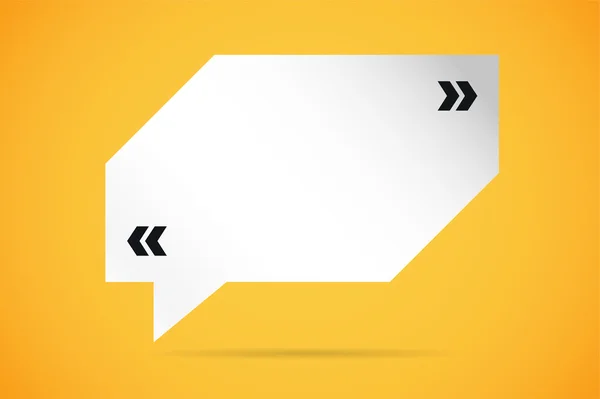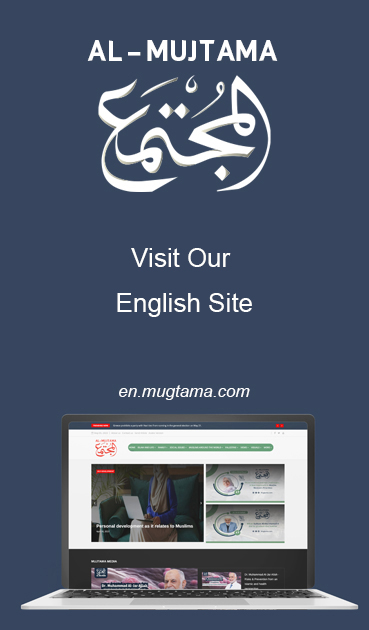العلمانية إلى تراجع

مستقبل العلمانية من القضايا التي تشغل الفضاء الفلسفي والفكري والثقافي منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وذلك عقب موجة الصعود الديني في العالم، وترافق هذا الصعود مع الأزمات الحادة في المجتمعات العلمانية، خاصة ما يتعلق بالتراجع الحاد في الضمير الديني والأخلاقي، والذي أوجد غيابه آثارا سلبية على تفكك الأسرة وزيادة الإدمان العنف، وظهور دعوات تبشر بإزالة العلمنة.
وتجلى حضور الدين في السياسة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي "ترامب" يناير 2025 في أكثر من مشهد سواء في قسم الرئيس، أو في حضور ثلاثة شخصيات تمثل الأديان الثلاثة المسيحية واليهودية والإسلام، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" عن حضور الشعائر الدينية في التجمعات الانتخابات الأمريكية في عدة تقارير، ذكر أحدها استدعاء المرشحين لمواقفهم وانتماءاتهم الدينية إلى حياتهم السياسية، بل إن بعضهم اعتبر نشاطه السياسي عملا دينيا مقدسا.
على مدى الثلاثين عاماً الماضية، أصبح علماء السياسة الأوروبيون مهتمين بشكل متزايد بالتشابك بين الدين والسياسة، ففي دراسة نشرت عام 2023 تحدثت عن تأثير اليمين والدين في سياسة الاتحاد الأوروبي والحضور الديني المسيحي في السياسة الأوروبية.
وهنا كان الحديث عن "ما بعد العلمانية" وهو دخول الدين إلى المجال العام سواء السياسي أو مؤسسة الحكم، وأن التشابك بين الدين والسياسة بات أحد العوامل القوية المؤثرة في تشكيل الهوية الأوروبية، فكانت الهوية هي المدخل الذي عاد الدين من خلالها إلى أروقة للتأثير فيها، فقدمت الأحزاب الدينية نفسها كمدافع عن الهوية المسيحية، وأنها لا ترى أوروبا إلا ذات هوية مسيحية.
العلمانية.. ماذا تريد؟
النجاح العلماني في التجربة الغربية من خلال إبعاد الدين عن مؤسسة الحكم كان عاملا مؤثرا في إنهاء الحروب الدينية في أوروبا، يعد أحد المبررات لاستمرار العلمانية في مواقع تأثيرها السياسي والاجتماعي حتى الآن.
فقد تم تبرير الاستمرار في العلمنة كنوع من الوقاية من شبح الحروب الدينية، تلك الحروب الأوروبية التي اشتعلت مع بدء حركة الإصلاح الديني البروتستانتي في العام 1517 وامتدت إلى بدايات القرن الثامن عشر الميلادي، ففي حرب الثلاثين عاما بين الكاثوليك والبروتستانت في الفترة من 1618م حتى 1648م راح ضحيتها ما يقرب من (12) مليون إنسان، حتى إن ألمانيا فقدت ثلث سكانها في تلك الحرب.
ومن هنا جاءت العلمانية لتحيد تلك الرؤى الدينية المتعصبة عن أروقة الحكم، لتعيد تشكيل الاجتماع السياسي على أسس غير دينية تفاديا لتلك الصراعات الدامية، واستطاعت العلمنة في تلك الفترة أن تحقق نجاحا، رغم أن العلمانية تحولت لوقود للصراع في الحربين العالميتين الأولى والثانية من خلال الدولة القومية والتعصب العرقي.
ومع الثمانينيات من القرن الماضي أخذت الشكوك تتصاعد في النجاح العلماني واستمراره في مواقع الحكم والتوجيه السياسي والاجتماعي، وطرحت القضية على مائدة النقاش، لكن لمأزق المجتمع الغربي الناجم عن تزايد معدلات الهجرة إلى أوروبا هو الذي خلق تحديا هوياتيا، فوجدت العلمانية أنها بحاجة إلى الدين لتحديد الهوية الأوروبية لمواجهة الهويات الوافدة، فكان لا مفر مع استدعاء المسيحية كأحد أهم مكونات الهوية الأوروبية.
العلمانية انتقلت من كونها حلا لأزمة أوروبية إبان حروبها الدينية، إلى اتخاذ موقف من الدين وإبعاده من المجال العام وعدم السماح بحضوره أو التعبير عنه إلا في داخل المجال الخاص الشخصي أو دور العبادة، وإذا كانت تجارب العلمانية سعت للتعامل مع الديني والسياسي كمجالين متوازيين أو عالمين مختلفين وتسامحت عن التعبير عن الدين في المجال العام، إلا أن هناك علمانية ذات وجه استبدادي إقصائي لا تكتفي بنزع الطابع السياسي عن الدين أو إبعاده عن أروقة الحكم، ولكن ترى ضرورة منع الدين من المجال العام، وهذا المنع لا يتم إلا بسلطة الدولة وقانونها.
والحقيقة أن العلمانية وضعت نفسها في مكان متعال تحكم من خلاله على كل الأفكار والقيم، جعلت نفسها معيارا للجميع، يذهب بعض المفكرين الغربيين أن الفلسفة الغربية منذ ادعت نهاية المتعالى، بإعلان "موت الإله" الذي تحدث عنه الفيلسوف الألماني "نيتشه" في كتابه "العلم المرح" عام 1882م، بحثت عن متعال آخر وعن مثاليات أخرى منزوع منها وجود الخالق سبحانه وتعالى، وسعت العلمانية لتصبح متعالية لتضفي على قوانينها قدسية وتنفذها بقوة الدولة.
أنتج ذلك التحول الخطير مشكلات عميقة في الفكر، لعل أهمها غياب المعنى، وغياب المرجعية الدينية للأخلاق، ومنح الإنسان نفسه القدرة على تحديد الخير والشر، ليس وفق معيارية متعالية خارج نطاقه، ولكن من معيارية وضعية مرتبطة بمنفعته ولذته ومصالحه.
ومن هنا أوجدت العلمانية إيمانا سهلا وهشا، وحولت الإيمان إلى نوع من الاختيار الشخصي بين خيارات متعددة منها الإلحاد، تحولت العلمانية إلى موقف أيديولوجي عقائدي متصلب، يحقق ذاته من خلال استبعاد الدين، أو من خلال السيطرة على الدين وتوظيفه، وهنا غاب مفهوم حيادية الدولة في التعامل مع الدين، وتحولت العلمانية إلى أداة لضبط الدين بالاستبعاد أو التنظيم أو التوظيف.
أثمر هذا التحول مشكلات عميقة في الأخلاق والبنى الاجتماعية، فظهر التحلل الأخلاقي وتآكل مفهوم الأسرة وحدثت زيادة في العنف والإدمان، يشير بعض المفكرين الغربيين أن العلمانية تتطور جنبا إلى جنب مع ضعف وانكسار الهوية الإنسانية وغياب المعنى للوجود الإنساني وافتقار الإنسان للغاية، وهي معان كان الدين بتقاليده العريقة يرسخها في المجتمع.
والحقيقة أن العلمانية يتم تعزيزها بدرجة أساسية من خلال سياسات الدولة، ومن هنا بدأ المأزق يتجسد في أن ذلك التعزيز من خلال سياسيات الدولة أدى إلى ما يمكن تسميته بــ"إزالة العلمنة" نفسها، لأن ذلك سمح من جديد بحضور الدين في المجال العام، وهو رصده عالم الاجتماع الأمريكي " بيتر إل. بيرجر" في كتابه "إزالة العلمانية من العالم " الذي حرره عام 1999م بمشاركة ستة من كبار الكتاب والمثقفين وأكد فيه على عودة الدين إلى السياسة العالمية، وتحدى هذا الكتاب المبكر:"الاعتقاد بأن العالم الحديث أصبح علمانياً على نحو متزايد، وأوضح أن التحديث يعمل في أغلب الأحيان على تعزيز الدين" وقدم رؤية لحيوية الدين في مواجهة الحداثة والعلمنة، ثم تتابعت الدراسات التي تجزم بعودة الدين للمجال العام في مقابل تراجع العلمانية.
ويمكن القول أن الأمراض التي أنتجتها الحداثة والعلمنة هي التي تمثل تحديا للدين وليس العلمانية نفسها، ويمكن رصد بعضا من تلك التحديات خاصة تلك التي تدفع الإنسان إلى الوصول لحالة من اللايقين خاصة فيما يتعلق بالمستقبل الذي كانت تبشر به، وعلى سبيل المثال ما حدث إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي تسببت في ركود اقتصادي طويل، وشككت في المستقبل، وأمام هذا اللايقين لم تستطع العلمانية أن تمنح الذين يعانون من الأزمة أي طمأنينة، وبات الكثير على حافة اليأس والانتحار، وهنا لعب الدين دورا مهما في رسم مسارات للخروج من هذا الإحباط.
تؤكد دراسة أن التدين يقف وراء انخفاض تعاطي المخدرات، فمثلا تشير إحصاءات أن حوالي 9% من الأمريكيين يعانون من اضطرابات إدمان الكحول وهذا الإدمان مسئول عن 12% من حالات الإعاقة في المجتمعات الصناعية الغربية، وأمام هذا الخطر تضطر الدولة لاستدعاء الدين ورعاية التدين وتوظيفه في مكافحة إدمان الكحول، وفي دراسة أخرى نشرت عام 2024 تحدثت عن التعافي المرتكز على الإيمان وأسباب اللجوء إلى الدين لمواجهة الإدمان وخلصت الدراسة أن "نظام المعتقدات "عامل وقائي ضد السلوك الإدماني".