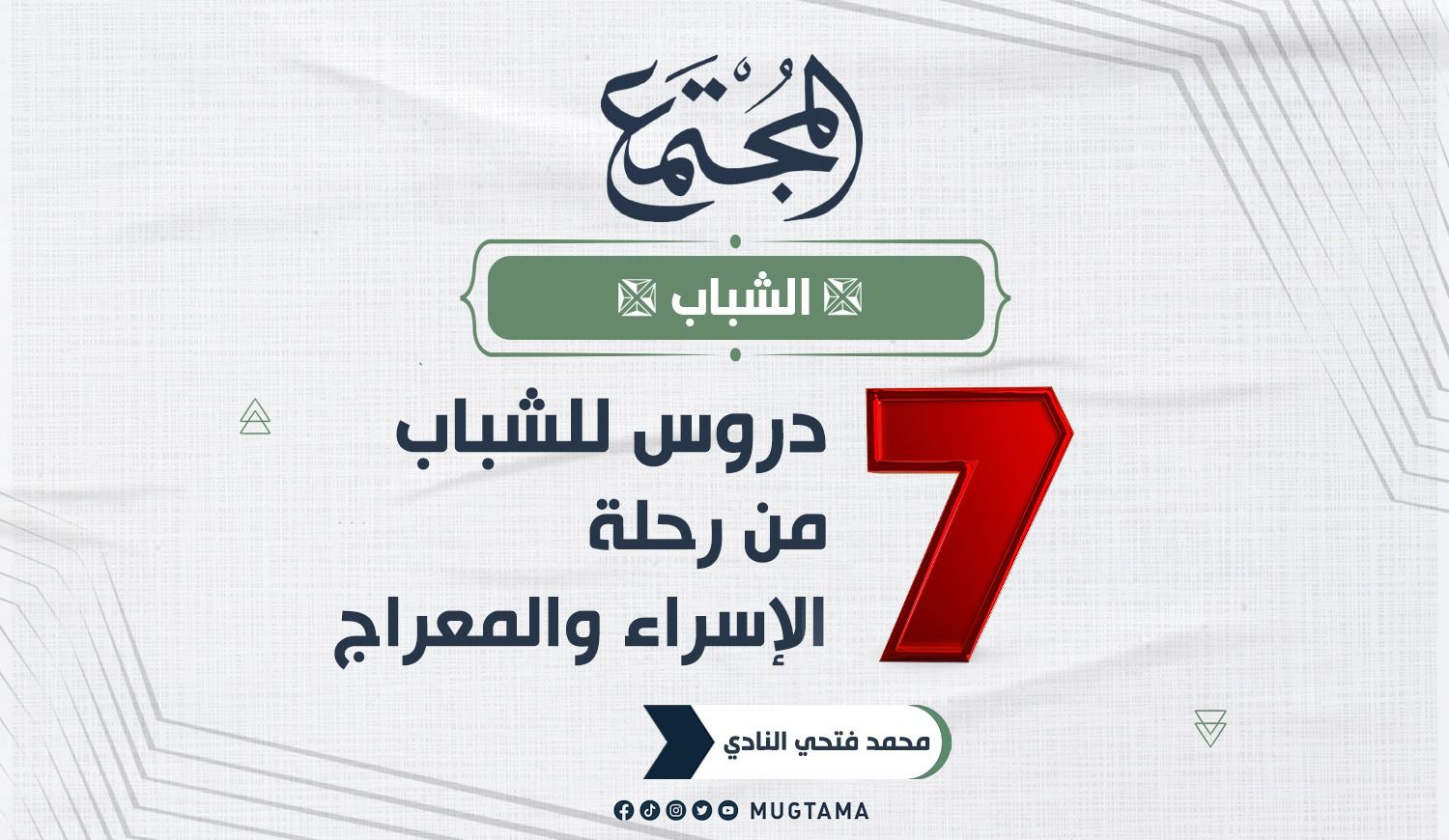«عام الحزن»، العام العاشر من البعثة، مُنِيَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وعمّه أبو طالب، وتزامن ذلك مع اشتداد أذى المشركين إجمالًا وحادثة الطائف وإيذاء بني ثقيف خصيصًا، جاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد ذلك العام، بتدبير السميع البصير سبحانه: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الإسراء: 1)، فكان من مقاصد تلك الرحلة أن يُرَى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يكون له فيها تسرية وتسلية، بشهود نفحات من الوعد الإلهي بالنصرة والتمكين، والتذكير برحمة الله وفضله، وغير ذلك من سبل التسرية.
ولأن الحزن والاغتمام شعور إنساني طبيعي يمر به كل شخص في حياته، اعتني شرع الإسلام العظيم بتقديم منهج متكامل للتعامل مع الأحزان على المستوى الشخصي والجماعي، يتضمن ضمن ما يتضمن التسرية والتعزية والتخفيف عن الحزين، بوصفها سبيلًا من سبل مداواة القلوب المكلومة وتخفيف المعاناة النفسية.
فما الإسراء؟ وما التسرية؟
اللفظتان من مادة «سَرَا»(1)، ولها عدة معان أوردها «لسان العرب»، منها ما يعنينا في هذا المقام:
– سرَّا ثَوْبَهُ عَنْهُ سَرْوًا وَسَرَّاهُ: نَزَعَهُ، التَّشْدِيدُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ.
– سَرَى مَتَاعَهُ يَسْرِي: أَلْقَاهُ عَنْ ظَهْرِ دَابَّتِهِ، وَسَرَّى عَنْهُ الثَّوْبَ سَرْيًا: كَشَفَهُ.
– السَّرِيُّ: النَّهْرُ، عَنْ ثَعْلَبٍ: وَقِيلَ: الْجَدْوَلُ، وَقِيلَ: النَّهْرُ الصَّغِيرُ كَالْجَدْوَلِ يَجْرِي إِلَى النَّخْلِ، ومنه وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
– سُرِّيَ عَنْهُ: تَجَلَّى هَمُّهُ، وَانْسَرَى عَنْهُ الْهَمُّ انْكَشَفَ، وَسُرِّيَ عَنْهُ مِثْلُهُ.
– سَرَيْتُ سُرًى وَمَسْرًى وَأَسْرَيْتُ بِمَعْنَى إِذَا سِرْتُ لَيْلً، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا)؛ مَعْنَاهُ سَيَّرَ عَبْدَهُ؛ وَفِيهِ أَيْضًا: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي) فَنَزَلَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ بِاللُّغَتَيْنِ; يُقَالُ: أَسْرَيْتُ وَسَرَيْتُ إِذَا سِرْتُ لَيْلًا
– وَالسَّارِيَةُ: السَّحَابَةُ الَّتِي بَيْنَ الْغَادِيَةِ وَالرَّائِحَةِ، أو الْمَطْرَةُ الَّتِي تَكُونُ بِاللَّيْلِ.
وإذن يتضح أن التسرية تعني كشف أو رفع شيء من الحزن عن الحزين؛ أي التخفيف والتهوين من وقع المصاب على نفسه، وإدخال السرور إلى قلب المهموم، بوسائل شتى منها ما هو ميسور لكل مسلم: الكلمة الطيبة، والدعاء، والتذكير بالله تعالى ونعمه وعلمه وإحاطته ووعده الإلهي لعباده في الدارين، والاعتبار بحكم الله وقدره.. إلخ.
وأما «التسلية» فمن مادة «سلو»، وتعني تخفيف الحزن أو وقع مصيبة، وقد تستخدم بمعنى الترفيه عن النفس عمومًا والتهوين عليها بعد مشقة أو حِمْل، وفي «لسان العرب» التسلية: ما يُلهي المصاب ويصرف قلبه عن شدة الحزن.
و«التعزية» مأخوذة من «عَزَى»، وتعني من بين ما تعني مواساة المُصاب، وحمله على الصبر، وذكره بما يُطمئن قلبه: عَزَّى فلانًا: صَبَّرَهُ، وواساه في مصيبته، وذكّره بالأجر والثواب انتهى من لسان العرب.
وقد حث الإسلام على سائر أشكال التسرية والتعزية وجعلها من القربات العظيمة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(2).
وتناول الإمام النووي في كتابه «الأذكار» موضوع التعزية وفضلها وآدابها، فقال: اعلم أن التعزية هي التصبير، وذكر ما يسلي صاحب الميت، ويخفف حزنه، ويهون مصيبته، وهي مستحبة؛ فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
من جهة أخرى، فالتسلية والتسرية والتعزية لا تكون من الواحد للغير فحسب، بل من المرء لنفسه كذلك، وهذا شكل من أشكال التسرية اللازمة والضرورية المغفول عنها!
فمن خير أبواب تعزية النفس التي شرعت لنا عبادة الاحتساب، والاحتساب يعني طلَب الثواب من الله تعالى، سواء فيما يعمله المسلم من مختلف الأعمال المفروضة والمسنونة، أو فيما يصيبه من مصائب، ففي الحديث: «إذا أصاب أحدَكم مصيبةٌ فليقُلْ: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندَك أَحتَسِبُ مُصيبَتي، فأَجِرْني فيها، وأَبدِلْني بها خيرًا منها»(3)، والمصيبة هي كل ما يصيب الإنسان مما فيه كراهة له وتأذٍّ منه ولا قُدرَةُ له على دَفْعِه.
وبالإضافة لما يرجوه المسلم من ثواب فيما يصيبه، فإنّ من نِعَم المِحَن التي يحتسبها كذلك تكفير الخطايا والسيئّات التي لا يخلو منها حَيّ بدرجاتها: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ (التعب) وَلا وَصَبٍ (الوجع الدائم أو المرض) وَلا هَمٍّ وَلاَ حَزَن وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ، حتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها إِلاَّ كَفَّر الله تعالى بهَا مِنْ خطَايَاه» (متّفق عليه)، ثمّ تكون رِفعَة وتطهيرًا: «فما يبرَحُ البلاءُ بالعبدِ حتَّى يمشيَ على الأرضِ وما عليه خطيئةٌ»(4).
ولذلك، كان دعاء عيادة المريض: لا بأس، طَهور إن شاء الله تعالى، أو كفّارة وطَهور؛ أي لا خوف عليك أو لا تجزع ممَّا تَجِدُه من وجع، بل يُكفِّر الله تعالى به ذُنوبك، ثمَّ يُفرِّج عنك، فيَجمَع لك الأجرَ والعافية، ففيه تَعزِيَة للمريض بتذكيره بالثواب الكامن في ثوب المرض، وتَذكيرُه بالكفَّارة لذُنوبِه وتطهيرِه من آثامِه إذا صبر واحتسب، لئلَّا يَسخط على أقدار الله تعالى أو يفوته اغتنام فرصة الأجر والتكفير(5).
إنه ليس في الدنيا جزاء أَوْفَى حقيقة، وإنما كلّ جزاء هو امتحان جديد، سواء كان نعمة أم ابتلاء، حتى تُوضَع الموازين القِسطُ ليوم القيامة فلا تُظلَم نفسٌ شيئًا ولو مثقال ذرَّة، فلْتَرْضَ النفس ولتطمئنّ الروح، ولتستأنس بقولة سيدنــا عُروة بن الزبير في ابتلائه، إذ ابتلي في يوم واحد بوفاة أحب أولاده له وقطع إحدى رجليه، فقال: اللَّهمّ لَكَ الْحَمْدُ، كَانُوا سَبْعَةً فَأَخَذْتَ وَاحِدًا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدًا وأبقيت ثلاثة، فَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلَقَدْ أَعْطَيْتَ، وَلَئِنْ كنت قد ابتليت فقد عافيت(6).
____________________
(1) يُظَن خطأ أن السرَّاء مشتقة من نفس المادة، والصواب أنها مادة سَرَر: وَالسُّرُّ وَالسَّرَّاءُ وَالسُّرُورُ وَالْمَسَرَّةُ، كُلُّهُ يعني الْفَرَحُ والنعمة.
(2) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً (1601).
(3) مسند أحمد، مسند النساء حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (26669).
(4) مسند أحمد، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (1607).
(5) هذه المعاني مستفادة من شرح فتح الباري على صحيح البخاري، والأذكار للنووي.
(6) ابن كثير: البداية والنهاية.