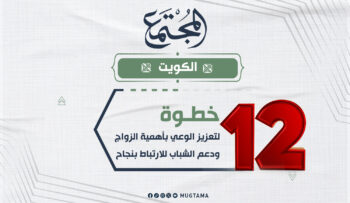{ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ “8” وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ “9”}(البلد) ، جلّ جلال الله.. فإن في هذه المعجزات الخلقية الثلاث ما يكفي للإيمان المطمئن بالله سبحانه وتعالى، وبكتابه العظيم.
{ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ “8” وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ “9”}(البلد) ،
جلّ جلال الله.. فإن في هذه المعجزات الخلقية الثلاث ما يكفي للإيمان المطمئن بالله سبحانه وتعالى، وبكتابه العظيم.
فأي نعمة كبرى في الرؤية.. وفي القدرة على الكلام الواضح المبين.. وفي تذّوق الطعام؟ وأي تركيب مدهش تنطوي عليه العينان بشبكتيهما وقرنيتهما وعدساتهما والملايين العشرة من الحجيرات الضوئية في تكوينهما.. وقدرتهما على قلب الصورة المعكوسة إلى وضعها الطبيعي في منظور الإنسان.. وعلى التحسّس العجيب للألوان، وعلى النفاذ إلى أكبر الأشياء وأصغرها والإحاطة بها علماً؟
ومَنْ غير الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العضو اللين الذي يمارس الكلام ويتذوق الطعام بمرونة مطلقة، دونما تعثّر أو ارتطام في صندوق الفم المليء بالأسنان الحادة والساحقة؟!
ومَنْ غير الله سبحانه وتعالى من يشق هاتين الشفتين بجمالهما وقدرتهما في الوقت نفسه على ممارسة اثنتين من أخطر وظائف الإنسان الفيزيولوجية: الكلام والطعام؟
إن «تشارلز دارون» الذي يقال: إنه كان زعيم، بل مؤسس، الإلحاد العلمي في العالم، يعترف في مذكراته الشخصية بمعجزة العين فيقول: «كلما فكرت في تركيب العين البشرية هزتني قشعريرة.. فمن قال: إني ملحد بالله؟!». وإذا كانت العينان تمارسان الشيء نفسه الذي تمارسه جل الحيوانات الأدنى منزلة من الإنسان.. فماذا يقال عن اللسان والشفتين اللتين منحتا الإنسان القدرة المتفوقة على الكلام الواضح المبين، الذي يتميز عن سائر الكائنات، والذي هو أحد تأسيسات الفعل الحضاري للبشرية كافة، والذي يقسم به الله سبحانه وتعالى: {فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. الذاريات: ٢٣ }.
حقاً، إن الإنسان كما يصفه الله تعالى «ظلوم كفار»، وهو يقف وجهاً لوجه أمام إبداعية الله في خلقه بهذا التناسب الجمالي والعملي المحكم، فيشيح عنه، ولا يكلّف نفسه عناء كلمة شكر يتوجه بها إلى الخالق العظيم الذي صنع هذا كله. إن هذا الذي يحدثنا عنه كتاب الله بخصوص العينين واللسان والشفتين، ما هو إلا غيض من فيض من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى على هذا الإنسان.. ويكفي أن نتذكر أنه من دون سائر الكائنات التي تحيا على هذه الأرض، قد حرّر جسده من الانحناء على الأرض والسير على أربع، بحيث يظل قائماً مستوياً ويداه متحررتان من شد الأرض.. يداه اللتان تمثلان الأساس في الفعل الحضاري.. ليس هذا فحسب، بل إنه حرّر الكفين وما تنطويان عليه من أصابع من شد الأظلاف والأخفاف، وجعلها تتحرك بحرية قبالة الإبهام القدير على الحركة في كل اتجاه.. وتلك هي معجزة أخرى؛{بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ “4”}
ذلك أن حركة الإبهام والأصابع التي تمسك بالقلم، والمعول، وتضغط على أزرار الحاسب الإلكتروني لهي كذلك من تأسيسات الفعل الحضاري للإنسان في هذا العالم.
ومع تحرير الجسد، والأيدي، والأصابع، فيما جعل عالم الحيوان لا يقدر على ممارسة الفعل الحضاري، أو بلوغ حافاته الدنيا، حتى لو عاش ملايين السنين.. هنالك عشرات ومئات المعجزات الخلقية في تكوين الإنسان الفيزيولوجي، ووظائف أعضائه المتقنة الصنع.. المرسومة بعناية.. والمتحركة في كل حلقاتها صوب غاياتها الأساسية في تمكين الإنسان من أن يكون كائناً متحضراً، قديراً على الأداء في اتجاهاته كافة.
فإذا أضفنا إلى هذا كلّه معجزة المعجزات المتمثلة بالقلب والدماغ، وما يؤديانه من وظائف مدهشة في حياة الإنسان.. وما ينطويان عليه من تركيب، وتقسيمات، وفاعليات، وغرف عمل وسيطرة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تجيء نتيجة الصدفة، أو ما يسمى بـ«النشوء والارتقاء»، وقوانين الصراع من أجل البقاء فيما لا يكاد يفسّر شيئاً على الإطلاق.
أدركنا كم أغدق علينا الله جلّ في علاه من نعم لا تعدّ ولا تُحصى، وكم كنا – نحن أبناء آدم – عاقّين لهذا الخلاّق المنعم، فلم نقدرها حق قدرها، فنذعن لكلمة الله، ونخرّ ساجدين لأفضاله علينا، وما أعظمها من أفضال.
حقاً إن الإنسان لظلوم كفَّار!