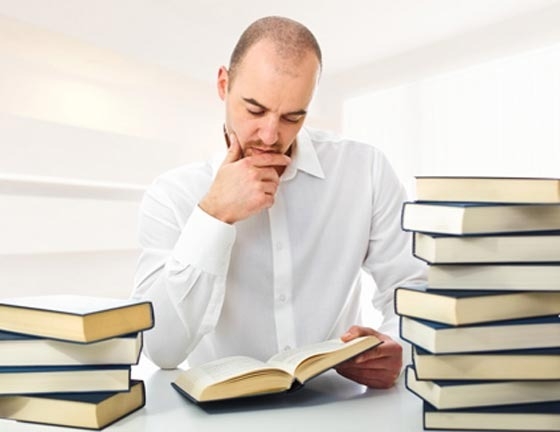تدق الساعة الخامسة عشية كل يوم فإذا الطريق العام الذي تطل عليه شرفة بيتي غير الطريق الذي كنت أعرف!
فبعد صياح السيارات الذي يصم الآذان، وعويل الدراجات البخارية الذي لا يهدأ في ليل أو نهار، فما إنْ تَحِنْ ساعة حظر التَّجْوال حتى تلتحف الطرقات بالسكون، وتخشع أرجاء المدينة، ويزحف الليل الساجي على الكون من حولنا، وأمسيت لا أسمع سوى أصوات الطيور وهي تأوي إلى أعشاشها بِطانًا رضيّة، وهي في عودتها تلك لا تستجيب إلا لداعي الفطرة وما جبلها الله عليه من نظامٍ، النهارُ فيه للمعاش والكدح والليل للسكينة والنوم!
وقد اعتدت كل عشية وقبل ساعة الحظر بدقائق أن أقف في شرفة بيتي أتملّى هذه الصورة، وأقف أمامها طويلًا لا ينقضي عجبي من غرابتها!
أقف أمامها كأنما أرى برزخًا بين مُختلفين لا يتشابهان أو يلتقيان؛ العمل والحركة والضجيج، ثم السكون والراحة والهدوء.
صورة تتمثّل لي فيها البشرية راكضة لاهثة، مندفعة مطأطئة لا تكاد ترفع رأسها لتبصر أي طريقٍ تسلك، وبينما هي تهرول مسرعة يباغتها من يأخذ بحُجْزَتِها، ويمسك بتلابيبها ويحملها على التوقُّف!
فتقف مكرهة غير مختارة، وتتَفرّس في نفسها، وتفرُك عينيها وهي ترى طريقها الممتد أمامها في الأفق، وتنظر حولها ذاهلةً تتبيّن العلامات والصُّوى (العلامات الدالة في الطريق) المنثورة على جَنَبَتَيْ الطريق!
وتَتَسمَّع صوتًا واهنًا من داخلها، تُصِيخ إليه فإذا هو صوت ضميرها الغافي، ونداء قلبها الذي أنهكه السعي الدائب والعمل الموصول!
صورة مفزعة لكنها مُعْجِبة، أتملّاها كأنها تنبض أمام عيني بالحياة، وأمام قلبي بالشعور والإحساس.
ولا أعرف إن كان هذا المشهد المُعْجِب المتجدد الذي يَلَذُّ لي عشية كل يوم ينُمُّ عن “أنانية” أُلامُ عليها إذ إنني رجل نَزَّاع إلى السكون، مَيّال الطبع إلى العزلة؟
أم أنه “روقان” لا يليق في وقت يشعر الناس فيه حولي بالأزمة، ويشيّعون فيه فرحتهم وآمالهم، ويغرقون في مخاوفهم وأحزانهم.
ولكن الذي أتيقنه من نفسي أنني كأي مسلم سليم العقيدة مستقيم الإيمان، يقابل ما لا طاقة له على تغييره من أقدار الله رَضِيَّ النفس مطمئن القلب.
فالشر المحْضُ لا وجود له في هذه الدنيا، والمنح والعطايا أَجِنَّة مستورة في أرحام المحن والبلايا، وإنّ مُغَالبة القدَر بالقدَر أرْوَحُ للقلب وأسلم عاقبةً، وأبعد عن موجبات الكآبة والعلل النفسية التي لا تقتات إلا على عافية البدن وهناءة القلب!
وإني لأكتب هذه الكلمات وأقرأ على صفحات الأصدقاء من عبارات التبرّم والضيق ما يدل على حيرة كاتبيها، ولكن ما هالني أن أولئك المتبرمين لا يبوحون بذلك أسفًا على ما بلَغَه حال الناس الذين أبدلتهم الأيام من أمنهم خوفًا، ومن طمأنينتهم فزعًا ووجلًا.
أو رثاءً لأولئك الضحايا الذين يسقطون هنا وهناك في جَنَبات الأرض بعدما انهارت منظومات الصحة، وعجزت آلاف المستشفيات أمام جموع المصابين بالوباء.
أو تألّمًا لحال أولئك الذين أصابتهم جائحة الاقتصاد فانقطعت مواردهم، وأغلقت متاجرهم وشركاتهم، فافتقروا بعد غني، وأعوزهم الدهر بعد كفاية.
أو حزنًا لتعطيل المدارس والمعاهد والجامعات وتضرّر مسيرة التعليم، والانقطاع الطويل الكفيل بالتأثير السلبي على ما تعلمه الطلاب في سنوات خلت.
إن كل هذا لم يخطر للقوم على بال، ولم يدفعهم لهذا الضيق المُعْلَن سوى أنهم يقضون في بيوتهم وقتًا أطول! ويرون في الحظر حبسًا وعزلة تحرمهم متعة الخروج حيث لقاء الأصدقاء وغِشْيان المقاهي والأندية، والتَّطْواف الذي يَذْرَعون به السكك والشوارع جيئةً وذهابًا في غير فائدة ترجى.
وقد تفكّرت في الأمر فإذا القوم لا يُعْزَلون في بيوتهم سوى ربعِ اليوم أو قريبٍ من ذلك، فإن كان وقت الحظر يبدأ من الخامسة مساءً، ورجل العصر في أيامنا لا يأوي إلى فراشه إلا بعد أن يمضي هزيع من الليل، أي في حدود الحادية عشرة، ينام بعدها ليستأنف يومه صباحًا وقد انتهت ساعات الحظر! فالأمر إذن لا يزيد على ست ساعات يقضيها المرء في بيته بين أهله وذويه، يداعب صبيته، ويضاحك إخوته ووالديه، أو ينكبُّ على هاتفه يقتل الوقت في الألعاب الإلكترونية وتتبُّع الأخبار، أو الثرثرة مع هذا وذاك.
ألا فليذكر هذا السَّئِم المَلُول نعمة الله عليه، ولطفه السابغ عليه في هذه الأيام.
وليذكر قومًا حبسهم المرض على أسرة المشافي ومعاهد الأورام وأجهزة الغسيل يتقلبون من الألم، وتمنعهم الأوجاع لذيذ الرقاد!
أو ليذكر أولئك الذين اعتقلهم الشلل في أجسامهم فلا يبرحون أماكنهم إلا بشق الأنفس ولا يقضون حاجة الإنسان إلا بمعين!
أو ليذكر -إن شاء- أولئك الذين يتكدسون في السجون لا تكاد يلَطِّف غُرفَهم عليل الهواء، أو يبلّل حلوقَهم بارد الماء، ولا يرون ضوء الشمس إلا من حينٍ إلى حين!
أو ليذكر أولئك الذين حملهم طلب الرزق على ترك أهليهم ومن يحبونهم، وشَطَّت غربتهم فلا يلتقون أهلهم سوى في كل عام مرة أو مرتين!
أو ليذكر أولئك الأطباء والممرضين الذين يتعرّضون للمرض وتتربّص بهم العدوى مع كل مريض يَفِد إليهم، وودّوا لو أنهم بين أهليهم في البيوت، غير أن نداء الواجب وهتاف الضمير وضرورة الوظيفة تحتّم عليهم الصمود والاستمرار وإن كان في ذلك حتفهم.
أو ليذكر أولئك العمال والموظفين والبسطاء الذين لا يملكون ما يعينهم على البقاء في بيوتهم يومًا أو بعض يوم، فلكل منهم صِبية من ورائه إن تركهم لطلب الرزق؛ فأصابته العدوى فمات ضاعوا، وإن لزم بيته اتقاء المرض جاعوا، فهو بين خطرين أهونهما الجوع!
ليذكر كل هؤلاء ويرتهن في بيته حامدًا شاكرًا، موصول الثناء على ربه أنْ لم يكلّفه ما لا يحتمل، ولم يضاعف عليه من البلاء ما لا طاقة له به.
ولكن ما بالنا في بلاد الشرق العربي نضيق بالفراغ، ويشُقُّ علينا قضاء شيء من الوحدة المؤقتة، ونرى فيهما عقوبة تستوجب الضجر والتسخط؟!