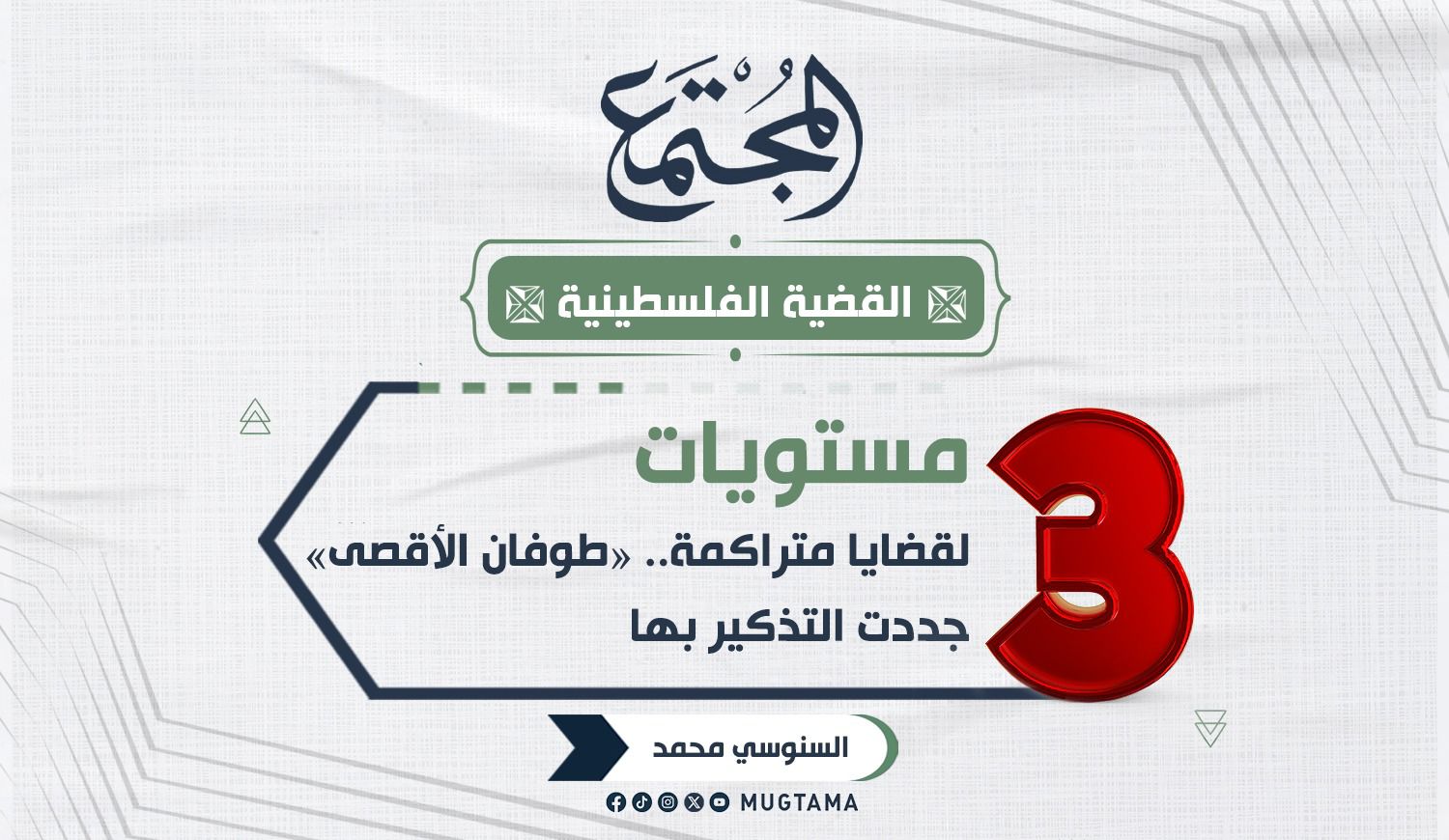من أهم ما أحدثته معركة «طوفان الأقصى» من أثر وتأثير أنها جددت التذكير بقضايا مهمة، متراكمة وعالقة، كان يُراد لها أن يطويها النسيان أو تُزيَّف حقيقتها! وذلك في ثلاثة مستويات شملت الوضع الفلسطيني، والمشهد العربي، والسياق الدولي.
أولاً: الوضع الفلسطيني.. الانقسام وفقدان البوصلة:
لقد مرت القضية الفلسطينية خلال عقود بتطورات كثيرة وتقلبات جوهرية، انتهت فيما يخص الوضع الفلسطيني إلى «اتفاقية أوسلو» عام 1993م، التي ترتب عليها وجود السلطة الفلسطينية، التي بدأت مع الاحتلال الغاشم مسارًا تفاوضيًّا ظنته يفضي إلى استعادة ولو الحد الأدنى من الحقوق.
لكن بعد 31 عامًا، انكشف الزيف الذي راهن على إمكانية تنازل الاحتلال عما اغتصبه قهرًا وعدوانًا، وتبخرت طموحات المسار التفاوضي جراء التعنت الصهيوني، مما ليس غريبًا على الاحتلال! واتضح أن الدول التي زعمت رعايتها للاتفاقيات والتفاوض لم تكن راعيًا أمينًا ولا طرفًا محايدًا؛ إذ لم تتزحزح قيد أنملة عن موقعها الأصلي الداعم والمساند والشريك للكيان الوظيفي، وإنْ أظهرت غير ذلك.
وقد صار هذا الوضع إلى جمود لا يقدر معه أصحابه على استعادة ماضٍ طالما تغنوا به في الكفاح والنضال، ولا يستطيعون -أو بالأدق ولا يرغبون- في التملص من مواقع يحصلون منها على نفوذ وسلطة موهومة!
وأمام تمسك قطاع كبيرٍ متنام من الشعب الفلسطيني بحقه في المقاومة والتحرير، وفي رفض كل القيود والإملاءات؛ كان لا بد أن يحصل انقسام في الصف الفلسطيني؛ لا سيما أن أصحاب الاتجاه المقاوم، وعلى رأسهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أثبتوا وبشكل متصاعد كفاءة واقتدارًا، وسجلوا صفحات فخار بالدم والنار؛ حتى أجبروا شارون على الفرار من غزة عام 2005م، بعد احتلال دام 38 عامًا، وأثخنوا في عدة حروب لاحقًا بالعدو الصهيوني الذي ظن في وقت ما أنّ باستطاعته احتواء الغضب الفلسطيني أو حشره في الزاوية.
فجاءت «طوفان الأقصى» لتجدِّد هذا الجدل المتصل بالوضع الفلسطيني الداخلي في الموقف من المقاومة ومن الاحتلال ولتذكِّر بحقيقة المشروع الوطني الفلسطيني المطلوب باتجاه التحرير، ولتطرح السؤال: هل البعض فعلاً قادر على مراجعة اختياراته ومعايرتها بالقدرة على تحرير المقدسات واستعادة الأرض، أم إن السقف انخفض والأمل تقلص، بل أصبحت «السلطة» عبئًا على القضية وعلى من يريد أن يدفع بها إلى المسار الصحيح؟
«طوفان الأقصى» كشفت الأوراق، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في خديعة الذات بالسير في مسارات عقيمة!
ثانياً: المشهد العربي.. العجز والانكشاف:
بعد أن انخرطت دول عربية فيما يسمى «اتفاقيات سلام» مع الكيان الصهيوني، وبعد أن نحج الكيان في أن يمد جسور الصداقة والشراكة مع دول أخرى، متجاوزًا ربط ذلك بالتقدم في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين؛ صار المشهد العربي على نحو من التفتت والتمزق والتيه بما مكّن لدولة الاحتلال، وجعلها تبدو في صورة من يحرص على السلام بالمنطقة، ويقدر على جلب الرخاء لها، بل يمكن أن يقودها لمواجهة إيران (الخطر المشترك).
هذه الصورة الزائفة كادت تنطلي على كثيرين، وأوشكت على أن تستكمل ملامحها النهائية؛ لولا أن جاءت «طوفان الأقصى»؛ فأعادت التذكير مجددًا بحقيقة هذا الكيان الغاصب؛ الذي لم ينفك عن تاريخه العريق في الإجرام والقتل بدم بارد، واحتقار العرب والمسلمين، والإبادة الممنهجة، فضلاً عن تزييف الصورة والكذب المفضوح والادعاء الباطل، واستعذاب الظهور بمظهر الضحية، وابتزاز العالم بما لم يكن العرب والمسلمون طرفًا فيه، وإنما كان مشكلة غربية حصرًا.
لقد باتت الدول العربية، التي طبعت مع الكيان والأخرى التي قطعت أشواطًا بالاتجاه، في وضع انكشاف غير مسبوق أمام شعوبها، وأمام ادعاءاتها بأنها ذهبت للتطبيع رغبة في مساعدة الفلسطينيين على استعادة حقوقهم، وذلك بفضل «طوفان الأقصى»، الذي طرح أيضًا التساؤلات مرة أخرى حول وضع النظام العربي وقدرته على الدفاع عن قضيته المركزية الأولى، وأصبحت المقارنة حاضرة بين موقف هذا النظام في عام 1948م، حين قرر التدخل عسكريًّا، وموقفه الأخير من المعركة الجارية؛ الذي لم تتردد أنظمة عربية في إدانته صراحة، ووقف بعضها منه موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها، ويجري في منطقة أخرى من العالم!
ثالثاً: السياق الدولي.. التبرير والتواطؤ:
لطالما حاولت دول غربية كثيرة أن تبدو في وضع حياد إزاء ما يسمى الصراع العربي «الإسرائيلي»، أو حتى الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، واستطاعت هذه الدول الغربية أن تحجب عن كثيرين حقيقة دورها في زرع الكيان الصهيوني بالقوة والتزييف في قلب العالم العربي والإسلامي؛ ليكون امتدادًا للاستعمار الغربي الذي كان يلملم نفوذه عن المنطقة العربية، وليكون أيضًا حاجزًا منيعًا ضد مشاريع الوحدة والتنمية، فهو في حقيقته كيان وظيفي مصطنع.
جاءت «طوفان الأقصى» التي هي عمل مشروع بامتياز، لأنها موجَّهة ضد احتلال غاشم؛ فرأينا الصورة التي أراد الغرب تثبيتها عن نفسه، تتهاوى وتتمزق إربًا، بعدما أخذت هذه الدول في التوافد على الكيان الصهيوني معلنة حقه في «الدفاع عن نفسه»، ونادى بعضها بضرورة تكوين حلف ضد ما أسمته «الإرهاب» (الموقف الفرنسي)، وبعضها الآخر وجد الفرصة لتجديد توبته من المحرقة (الموقف الألماني)، فضلاً عما اشتركت فيه الدول الغربية، وبنسب متفاوتة، من توفير جسر جوي وبحري لإمداد الكيان بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، على نحو غير مسبوق.
«طوفان الأقصى» لم تطرح فحسب التساؤل حول الموقف الغربي من الحق الفلسطيني، ومن الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني، وإنما طرحت أيضًا التساؤل حول جدية الغرب فيما يزعمه من قيم وحقوق إنسانية، ومن تمسك بالقانون الدولي وإنفاذ للقرارات الأممية(1).
إضافة لذلك، أصبح الإنسان الغربي، وبفعل المعركة، في موقف المتسائل عن دعم حكوماته غير المشروط لـ«إسرائيل»، وعن حقيقة ربط الانتقاد الموجه لـ«إسرائيل» بـ«معاداة السامية»، وهو تحول مهم أحدثته «طوفان الأقصى» في الساحة الغربية، سيتعاظم تأثيره مع أجيال الشباب.
لقد أظهرت «طوفان الأقصى» أن الوقت قد حان للتذكير بكل هذه القضايا المتراكمة، وعلى جميع المستويات؛ فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا، وأن الوقت لم يعد يتسع لمزيد من الخداع أو التسويف، كما بيَّنت الحرب أن إجابات تساؤلات هذه القضايا أصبحت أكثر وضوحًا من ذي قبل، لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد!
______________________
(1) الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض (الفيتو) 3 مرات لتعطيل قرارات بوقف إطلاق النار، منذ بدء معركة «طوفان الأقصى».