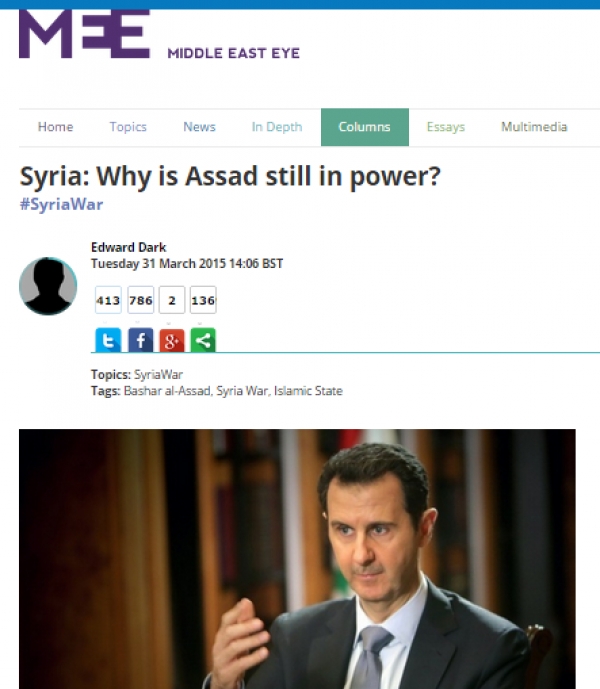ترجمة: جمال خطاب
دخل الصراع السوري عامه الخامس، وبشار الأسد لا يزال في السلطة متحدياً العالم أكثر من أي وقت مضى. والواقع، أنه يبدو أنه أكثر ثقة بعد أن مر بأسوأ ما في العاصفة. فآفاق إبعاده أو انهيار نظامه تبدو الآن بعيدة بشكل متزايد بعد تحول أولوية الولايات المتحدة لهزيمة الدولة الإسلامية، وتأخرت أولوية تغيير النظام في سوريا إلى المواقع الخلفية إلى أجل غير مسمى.
فلماذا نجا لفترة طويلة في مواجهة مثل هذه الاحتمالات التي كانت تبدو ساحقة؟ لماذا كان قادراً على الصمود في وجه القوى الكبرى العالمية، والدول المجاورة المعادية على كل الحدود وعشرات الآلاف من المقاتلين الثائرين المسلحين تسليحاً جيداً ضده؟ لقد لعب ارتفاع الدولة الإسلامية وشبكات الإرهاب بالتأكيد دوراً كبيراً من خلال تحويل التركيز العالمي بعيداً عن نظامه وكيفية مواجهة التهديدات الخطيرة للأمن العالمي الذي تمثله تلك الجماعة.
لقد كان الدعم السياسي والمالي والعسكري الذي لا يتزعزع من حلفاء الأسد المتحمسين: روسيا وإيران وحزب الله أيضاً عاملاً مهماً في استقرار تحكم نظامه وسيطرته على أراضيه. والواقع، أنه كان “للقوات على الأرض” وحزب الله مباشرة دور فعال في الصراع الدائر وفي تراجع مكاسب الثوار في عدة جبهات إستراتيجية، فضلاً عن تأمين المراكز السكانية الحضرية الكبرى، وهي كلها لا تزال كلياً أو جزئياً تحت سيطرة النظام. هذا باستثناء الرقة التي سقطت في قبضة الدولة الإسلامية بعد أن تم التقاطها من قبل الثوار في عام 2013م.
وبصرف النظر عن هذين العاملين المهمين، هناك عامل ثالث حاسم جداً يتم تجاهله أو الجهل به من قبل الدول المعادية للنظام السوري أو المؤسسات الإعلامية العالمية الكبيرة، رغم أنه المفتاح لفهم سر طول العمر الذي يتمتع به النظام وهو استمرار الدعم المقدم له من مساحات شاسعة من الشعب السوري، وإن كان العديد من السوريين يقوم بذلك خوفاً من البدائل.
ما ليس معروفاً على نطاق واسع هو أنه قبل انتفاضة عام 2011م، كان الأسد رئيساً شعبياً، يتمتع بدعم واسع بين كثير من شرائح المجتمع السوري. وكان حتى قادراً على قيادة سيارته الخاصة، والتمشي في الأسواق مع الحد الأدنى من الأمن المرئي. وهذا نوع من الدعاية التي كانت تمارس في سوريا، كما هو الحال في معظم الدكتاتوريات الأخرى.
ولكن المزاج الشعبي انقلب بحزم ضده هو ونظامه عندما أصبحت احتجاجات الربيع العربي مصدر إلهام ينتشر في سوريا وجوبهت احتجاجات الناس بعنف وإطلاق النار وقتل في الشوارع. وهذه هي أدنى نقطة في دعم النظام، حيث لم يبق له إلا الموالين المتشددين الوحيدين الذين لا يزالون يناصرونه. حينذاك قفز العديد من المسؤولين وضباط الجيش من السفينة تحسباً لغرقها الوشيك. على عكس ما كان يجري الترويج له آنذاك من قبل عواصم مختلفة في جميع أنحاء العالم، والسيل اللانهائي من وسائل الإعلام وتكهنات “الخبراء” بأنه ساقط هذا الشهر أو الذي يليه – ولكن السفينة لم تغرق.
الحديث عن وقوعه، كان مجرد طريقة أخرى تم بها خداع السوريين والرأي العام العالمي وتضليلهم، حتى ترسخ الصراع و”خطفت” حركة الاحتجاج الجماعية وتحولت الثورة لحرب أهلية فوضوية مدمرة. لم تكن هناك أي طريقة يمكن تصورها على الإطلاق تقول: إن الاحتجاجات وحدها، مهما كانت كبيرة، من شأنها أن تزيل مثل هذا النظام القوي، الماكر والوحشي دون تدخل عسكري خارجي. لم يستطع أي محلل ذي قيمة لشؤون الشرق الأوسط أن يقدم حلاً.
وبالفعل، تم سحق الاحتجاجات الجماهيرية بنجاح بحلول صيف عام 2011، ودخل الجيش السوري واستعاد سلطة الحكومة على جميع البلدات والمدن المضطربة بالقوة. وكانت الانتفاضة السورية سلمية إلى حد كبير على نحو فعال.
وبطبيعة الحال، فإن الدول التي استثمرت بكثافة في إزالة النظام كانت تعتقد خلاف ذلك، وبدأت المرحلة التالية؛ تمرد مسلح بتمويل ودعم من قبلهم. وفي الوقت نفسه، فإن الروايات الرسمية لوسائل الإعلام السائدة لم تتغير مع تصاعد العنف في سوريا وتصاعد الصراع المدني – المدعوم خارجياً إلى حد كبير. ومع ذلك، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التطرف والطائفية والجهادية مجموعات كانت في ازدياد واكتساب الهيمنة على الثورة.
كان هذا السيناريو تبييضاً مرة أخرى لصالح “النظام في مقابل شعبه”، ولذلك فإن العديد من هؤلاء الناس قد تحولوا الآن إلى النظام بأعداد كبيرة لأنهم نفروا من الحرب والعنف والدمار والتعصب وأمراء الحرب واستبعدوا من قبل العديد من الجماعات المتمردة.
مرة أخرى كان تحول التأييد الشعبي نحو الحكومة نتيجة حتمية لفشل التمرد الذي يعاني من مأزق بسبب الجماعات الأكثر تطرفا التي ولدت من رحم الصراع مثل داعش وفروع أخرى من تنظيم القاعدة. هذا لا يعني بالطبع أن النظام السوري لم يستخدم كافة السبل لضمان بقائه، والقتال في حروب المدن بعدد محدود من رجال السلطة يستخدم القوة الهائلة والعنف العشوائي مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين.
وقد تم توثيق جرائم الحرب هذه أيضاً. ولكن هناك فرقاً مهماً يجب النظر إليه هنا. النظام السوري يستهدف مناطق جغرافية تحت سيطرة المتمردين، وليس مجموعات معينة من الناس. ويتضح ذلك عندما يقوم سكان تلك المناطق بالفرار من القتال لمناطق أكثر أمناً، حيث يتعرضون للقليل جداً من حوادث الانتقام.
ومن أبرز الأمثلة على تحول الدعم ما قامت به الأقلية الإسماعيلية، الذين يتمركزون في معظمهم في بلدة السلمية في حماة. فقد كانت السلمية مرتعاً للاحتجاج السلمي المدني عند اندلاع الانتفاضة ولكن لم يعد هذا هو الحال الآن. والواقع، أن السلمية هي الآن معقل من معاقل النظام الرئيسية التي تحمي خطوط إمداداته إلى الشمال، وتتعرض لهجمات كثيفة ومتكررة من الثوار.
هذا التحول في المشاعر من قبل الطائفة الإسماعيلية من معارضين بشدة للنظام السوري إلي أنصار صامدين له، يعكس اتجاهات مماثلة بين الأقليات الدينية في سوريا وجزءاً كبيراً من الأغلبية السنية والذين يخشون من فقدان طريقتهم المحافظة المعتدلة لصالح المزيد من التطرف.
وبالعكس، فهذا يعني أن العكس هو الصحيح بالنسبة للتمرد والمعارضة الذين، على الرغم من ذلك، ما زالوا يحتفظون بدعم لا بأس به يتركز أساساً في المناطق التي جاء منها مقاتلوهم. ففي حالة الجماعات الجهادية مثل داعش والنصرة – التي لديها قوة كبيرة من المقاتلين غير السوريين وأيديولوجية فائقة التطرف – تم اكتساب التأييد الشعبي من خلال البراعة في ساحات المعارك، ومن خلال القدرة على توفير الخدمات الأساسية والمساعدات و الحد الأدنى من القانون والنظام. وهذه كلها من المفاخر التي فشلت المعارضة السورية الفضفاضة السائدة “المعتدلة” المدعومة من الغرب والتابعة له في إنجازه، ولهذا تحول التأييد الشعبي للجماعات الكفوءة الأكثر تطرفاً.
والنظام الذي لا يتوفر لديه الدعم من سكانه لا يمكنه البقاء على قيد الحياة أعواماً من الحرب الأهلية، بغض النظر عن مدى قوته أو مدى الدعم الذي يحصل عليه من الخارج، لأنه ضد كل منطق. ولذلك نقول: إن جزءاً كبيراً من الشعب السوري لا يزال داخل البلاد ولا يزال يدعم النظام، أكثرهم من الأقليات الدينية العديدة والمتنوعة في سوريا، ولكن عدداً لا بأس به أيضاً من داعمي النظام هم من السكان السنة في المدن الحضرية الكبيرة مثل دمشق وحلب.
والأسوأ من ذلك، أنك إذا كنت في منطقة الشرق الأوسط، سترى أنه قد تم تأطير الصراع السوري من قبل شبكات الأخبار المهيمنة المملوكة للخليج العربي التي تدعم الثورة بقوة باعتبارها تتصدى للشيعة من قبل السنية. وهذا يساعد على حشد الدعم – وحتى المجندين – لقضية المناهضة للنظام وتحافظ على الرأي العام العربي – ومعظمهم من المسلمين السنة – ضد النظام.
والحقيقة، مع ذلك، أكثر دقة بكثير، على الرغم من وجود بُعد طائفي للصراع السوري واستقطاب داخلي كبير على طول تلك الخطوط، يتكون الجيش السوري أساساً من المجندين السنة، في حين أن العديد من المتطوعين السنة على استعداد للانضواء تحت الجماعات شبه العسكرية التي تدعم القوات الحكومية النظامية والقتال إلى جانب الميليشيات الشيعية الأجنبية، مثل حزب الله، ضد عدد كبير من الجماعات الثائرة وكلها من السنة المسلمين حصراً وهي علي درجات تطرف متفاوتة – على الصعيدين المحلي والأجنبي. وهذا الانقسام السني في سوريا ربما يكون أهم عامل ولكنه يتم تجاهله في تشكيل الصراع.