حين يتجاوز الإنسان في فهم النص ومقصده، أو ينزله في غير محله، أو يستنطقه بغير مراده، فإنه يقع في الهوى والانحراف، وربما تطور أمره فصار صاحب الهوى في فهم الدليل يحكم على مجتمع بأكمله وفق آية محكمة أنزلها هو على هواه، أو انحرف في تفسيرها عما وضعت له، أو أخذها إلى محل غير محلها، فكان بفهمه الناقص أداةً تخرب المجتمع، يستبيح بفهمه هذا دماً معصوماً، أو مالاً مصونا.
لا يخفى على أي باحث في بطون كتب الشريعة هذا الكم من الخلاف الفقهي بين أئمة المذاهب، وهي ظاهرة تناولها الأصوليون في سياقات متعددة، ووضحوا بالأمثلة أسبابها؛ فـ«الخلاف إما في مسائل مستقلة، أو في فروع مبنية على أصول، والأول ينشأ من أحد أمور؛ الأول: كون اللفظ مشتركاً، أو الخلاف في عود الضمير، أو الغفلة عن أحد الدليلين المتقابلين -ولو بالعموم والخصوص- فينسحب على العموم من لم يبلغه دليل الخصوص»(1)، ومما يدل على ذلك أن العرب تقول: «رغبت عن الشيء إذا زهدت فيه، ورغبت في الشيء إذا حرصت عليه، فلما رُكب الكلام تركيباً سقط منه حرف الجر احتمل التأويلين المتضادين»(2).
فعدم الوعي بسياقات الكلام، والتعميم في غير موضع التعميم، والتخصيص كذلك، تطور إلى موقف وضع فيه من وقع في هذا -وهم الخوارج- واحداً من الخلفاء الراشدين في موقف الضلال والكفر! وتطلب الأمر أن يناقشهم ابن عباس قائلاً:
«أخبروني ماذا نقمتم على عليّ رضي الله عنه؟ قالوا: ثلاثاً:
أما إحداهن: فإنه حكَّم الرجال في أمر الله.
وأما الثانية: فإنه قاتل ولم يسبِ ولم يغنم.
والثالثة: أنه محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن فهو أمير الكافرين.
قال ابن عباس لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سُنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم. 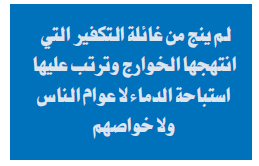
قال: أما قولكم حكَّم الرجال في أمر الله، فقد حكّم الله الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، فقال: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} (المائدة: 95)، فنشدتكم الله: أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل؟ أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال.. قالوا: نعم.
قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسبِ ولم يغنم؛ أتسْبُون(3) أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها، فلئن فعلتم لقد كفرتم! وهي أمكم، ولئن قلتم: ليست أمنا؛ لقد كفرتم، فإن الله يقول: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (الأحزاب: 6)، فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة، قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.
قال: أما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين، فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله»، فقال المشركون: لا والله؛ ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله»، فوالله لرسول الله خير من عليّ، وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه، فرجع من القوم بمحاجة ابن عباس ألفان وقتل سائرهم على ضلالة»(4).
وواضح من سياق القصة أن الخوارج احتجوا بأدلة منطقية في ظاهرها لا تحتمل النقض في حجيتها عندهم، لكن جلَّى لهم ابن عباس رضي الله عنهما الأمر، وبيَّن لهم خطأهم في تأسيس الدليل والبناء عليه.
فهذا التكييف الخاطئ للفعل، وتحميله ما لا يحتمله، وإلزامه ما لا يلزم، هو ما حدا بالخوارج أن تخطئ في الأحكام، وتستبيح بالخطأ الدماء والأعراض من المجتمع.
استباحة الدماء المعصومة
لم ينج من غائلة التكفير التي انتهجها الخوارج، التي ترتب عليها استباحة دماء الناس، لا عوام الناس ولا خواصهم، فقد أسر الخوارج الصحابي الجليل عبدالله بن خباب، وامرأته، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبدالله بن خباب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم قد روعتموني، فقالوا: لا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي»(5)، فاقتادوه بيده، فبينما هو يسير معهم، إذ لقي بعضهم خنزيراً لبعض أهل الذمة، فضربه بعضهم فشق جلده، فقال له آخر: لِمَ فعلت هذا وهو لذمي؟! فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه.
وبينا هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها واحد منهم وأكلها، فقال له آخر منكراً عليه: بغير إذن ولا ثمن؟ فألقاها من فمه، ثم قدّموا عبدالله بن خباب فذبحوه، وجاؤوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى، ألا تتقون الله! فذبحوها، وبقروا بطنها عن ولدها(6)! فجمعوا بين ورع كاذب؛ لا يستحلون تمرة؛ لكن لا يتورعون عن قتل صحابي جليل، وذبح زوجته الحامل.
هذا الفكر الذي نشأ نشأة مبكرة، لا تزال له في هذا العصر أصداء حاضرة، ولا يزال يتوارثه الخالف عن السالف، ولا يزال الشطط موجوداً بين طوائف من الشباب جرفته مثل هذه الأهواء المضلة، وهو ما يجعل تسليط الضوء على علاج هذه الآفة مطلوباً.
إن الشباب الذي وقع في أسر جماعات التطرف، ونال من المجتمع تارة بالتكفير، وتارة باستباحة دماء الآمنين وتحول إلى ظاهرة؛ يحتاج إلى دواء ناجع بعد أن استشرى ضرره؛ فالظاهرة في أساسها يلتصق أصحابها بالدين، ويتكئون على أحكامه ونصوصه! فلا بد في العلاج أن يُلقى في روع الشباب أن العلم الشرعي له موارد يجب ألا تُتخطى، وأن هناك فرقاً كبيراً بين تعلم العلم وحمله من موارده، ومجرد الثقافة الدينية التي يتلقاها المرء من خطب الجمعة والمقالات الدينية والقراءات العابرة في بطون الكتب وصفحات التواصل الاجتماعي، فإن من كان هذا زاده، فهذا قد ينفعه في تهذيب سلوكه وتمكين تدَيُّنه، لكنه يجني عليه ويضره أشد الضرر إذا استعمله في الفتوى وتأسيس الحكم.
وكم ضل أناس بتركهم أخذ العلم من موارده، بأن توجهوا للكتب، أو للدعاة حملة الثقافة العامة يحملون عنهم العلم، فضلّوا ضلالاً مبيناً؛ إذ ضلوا في 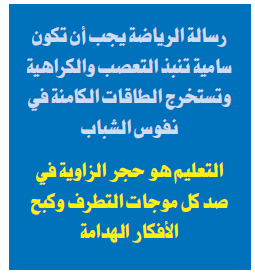 إطلاق الأحكام، بالغفلة عن معرفة موارد الأدلة، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، والفرق بين ظاهر النص ودلالته، قال الشافعي: «من تفقه من بطون الكتب ضيَّع الأحكام»، وكان بعضهم يقول: «من أعظم البلية تشيخ الصحيفة»(7)؛ أي: جعل الكتاب عمدة الباحث دون العلماء، وفي الحديث: «مَن قال في كتاب الله عزَّ وجلَّ برأيه فأصابَ؛ فقد أخطأ»(8).
إطلاق الأحكام، بالغفلة عن معرفة موارد الأدلة، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، والفرق بين ظاهر النص ودلالته، قال الشافعي: «من تفقه من بطون الكتب ضيَّع الأحكام»، وكان بعضهم يقول: «من أعظم البلية تشيخ الصحيفة»(7)؛ أي: جعل الكتاب عمدة الباحث دون العلماء، وفي الحديث: «مَن قال في كتاب الله عزَّ وجلَّ برأيه فأصابَ؛ فقد أخطأ»(8).
أدوار مطلوبة
والباحث عن العلاج لهذه الظاهرة أو الوقاية منها سيجد أن أمره يتوزع بين كل مكونات المجتمع ومؤسساته، فالأسرة لها دور مهم في تجنيب أبنائها غائلة الانحراف، والوقوع في شرك الجماعات الخارجة، وذلك بالاهتمام بالأبناء، والعناية بتعليمهم، وعدم إقحامهم في مشكلات الوالدين بأي سبب، والقرب منهم بصفة دائمة، وألا ينحصر دور الأسرة في توفير الأموال، وإعداد الأطعمة، ووسائل الرفاهية التي تمنحها، واعتبار هذا هو الرعاية والتربية.
أما المؤسسات على تنوعها -الإعلامية والدعوية والفنية والرياضية وغيرها- فيكمن دورها في ترسيخ الاعتدال بالتمكين لأصحاب الفكر المعتدل من مخاطبة الشباب؛ لشحذ طاقاتهم نحو تبني قضايا المجتمع، وأن تكون رسالة الرياضة رسالة سامية تنبذ التعصب والكراهية، وتستخرج الطاقات الكامنة في نفوس الشباب، وتتبنى المبدعين منهم، كما يجب أن يكون الفن حاملاً لهموم المجتمع، طارحاً علاجاً لقضاياه، فاعلاً في معالجة مشكلات الشباب، وأن يبتعد عن خدمة الغرائز، وإثارة الشهوات.
ويجب الانتباه إلى أن التعرض للثوابت الدينية، وإثارة الشكوك حول الغيبيات الثابتة على جهة القطع، يؤسس لموجات الإلحاد، ويسهم في نشأة التكفير، ويوجِد له مبرراً.
وأخيراً؛ فإن التعليم هو حجر الزاوية في صدّ كل موجات التطرف، وكبح الأفكار الهدامة، وهو قضية أمن المجتمع كله، فإن التطرف وما ينجم عنه يخرج في المجتمعات التي ترتفع فيها نسب الأمية، وتُؤخر التعليم عن اهتماماتها، وتجعل المتعلمين في ذيل المجتمع.
_________
الهوامش
(1) «الأشباه والنظائر» للسبكي: 2/ 259.
(2) الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين، ص 56.
(3) أي: أترضون أن تكون من سبايا الحرب كالأمة المسترقة.
(4) أخرجه عبدالرزاق، والنسائي، والطبراني.
(5) أخرجه الترمذي (2194).
(6) البداية والنهاية: 7/ 318.
(7) «تذكرة السامع والمتكلم»، ص 40.
(8) أخرجه أبو داود والترمذي، وهو ضعيف، ولكنه صحيح مقطوعاً.
(*) أستاذ العقيدة المشارك بجامعة المدينة العالمية






