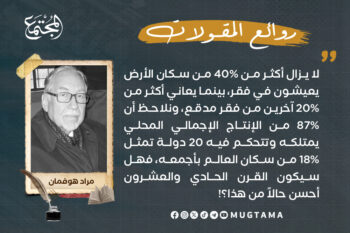بين الثامن عشر والحادي والعشرين من ديسمبر الماضي، عقد في العاصمة الماليزية مؤتمر دعا له ورعاه رئيس وزرائها مهاتير محمد، تحت شعار «دور التنمية في حماية السيادة الوطنية».
المؤتمر هو الخامس من نوعه، الذي ينظمه منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة بعد أربعة سبقته في عدة مدن، لكن هذه المرة نظم برعاية مباشرة من محمد الذي عاد للسلطة بعد فترة طويلة من ابتعاده عنها، محملاً بحمولة سياسية عالية.
أعطى مهاتير محمد للمنتدى الفكري بُعداً سياسياً مهماً من خلال دعوته لعدد من رؤساء الدول المسلمة للحضور، إضافة إلى مشاركة المئات من المفكرين والباحثين ورجال الفكر والرأي والدين من مختلف دول العالم الإسلامي كما في المؤتمرات السابقة، شارك منهم نحو 450 في منتدى هذا العام، وقد دعا رئيس الوزراء الماليزي لقمة خماسية تجمعه مع الرئيسين التركي والإندونيسي وأمير دولة قطر ورئيس وزراء الباكستان، بحيث تكون هذه القمة الخماسية نواة لعمل إسلامي يهتم بمشكلات المسلمين في العالم الإسلامي والغرب على حد سواء.
وقد لخص صاحب الضيافة مشكلات المسلمين في وصم دينهم بالإرهاب، وإبعادهم عن بلدانهم، ومشكلة التخلف القائمة في معظم بلدان العالم الإسلامي، ومن هنا، فيما يبدو، أتت فكرة شعار المؤتمر بخصوص «التنمية والسيادة الوطنية»، وقد دارت جلسات المؤتمر حول محاور سبعة، هي: السلام، والدفاع، والأمن، والعدالة والحرية، والثقافة والهوية، والنزاهة والحكم الرشيد، والتنمية والسيادة، والتكنولوجيا والحكومة الإلكترونية، والتجارة والاستثمار.
وجهتا نظر متقابلتان
منذ الإعلان عنها، قوبلت القمة بوجهتي نظر وتقييم متناقضتين، إحداهما رأتها بداية مرحلة جديدة في العالم الإسلامي ستحل كل مشكلاته، والأخرى رأتها سعياً لإنشاء كيان بديل عن «منظمة التعاون الإسلامي» التي تجمع كافة الدول المسلمة أو ذات الغالبية المسلمة، وتثبت مجريات القمة ثم مآلاتها أن كلتا النظرتين كانت قاصرة إلى حد بعيد ومبالغة في التقييم.
فالقمة لم تدَّعِ لنفسها القدرة على حل مشكلات العالم الإسلامي الكثيرة والعميقة والمعقدة، وإنما قالت: إنها تسعى لنقاش هذه المشكلات والبحث عن حلول لها، ومن جهة أخرى، لم تقل القمة أو منظموها: إنها كيان أو إطار بديل عن المؤسسات القائمة مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وإنما هي مبادرة تجمع عدداً من الدول التي تجد في نفسها الرغبة والقدرة على الاهتمام بما هو أبعد من أجنداتها المحلية، وبما يشمل مشكلات في عموم العالم الإسلامي ومناطق تواجد المسلمين.
ولعل هذا هو سبب اختيار الدول الخمس التي دعيت في البدايات (تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا إضافة لماليزيا)، التي يجمع بينها مؤخراً عدد من مسارات التنسيق، مثل مسار التعاون المتنامي بين تركيا وقطر، أو مبادرة رعاية كل من ماليزيا وتركيا وباكستان لفضائية تواجه حملات الكراهية و»الإسلاموفوبيا» ضد المسلمين في الغرب.
رغم ذلك، ورغم تأكيد الجانب الماليزي بأن القمة لا تستثني أحداً، وأنها وجهت الدعوات لعدد من الدول الأخرى للمشاركة، وأن أبوابها ستكون دائماً مفتوحة لمن رغب، فإن القمة ووجهت بحملة كبيرة صنفتها كمبادرة سياسية تستهدف ليس فقط منظمة التعاون الإسلامي، وإنما بعض الدول العربية والمسلمة الكبيرة كذلك، ولعل هذا ما قد يساهم في تفسير إحجام بعض الدول، مثل باكستان وإندونيسيا، عن المشاركة في القمة برأس هرم السلطة فيها، بغض النظر أكان ذلك برغبة ذاتية أم بضغوط خارجية.
في المحصلة، لم تختلف مجريات المؤتمر هذا العام عن المؤتمرات الأربعة السابقة، فقد تداولت جلساته وحواراته مشكلات العالم الإسلامي المشار لها وفق المحاور سالفة الذكر، في نقاش فكري أكاديمي معمّق للبحث عن حلول لتلك المشكلات تدور في معظمها حول فكرة التعاون بين الدول المسلمة وخصوصاً المؤثرة والفاعلة منها.
الشق السياسي
أما الشق السياسي في القمة -الذي تمثل أساساً بمهاتير محمد، ورجب طيب أردوغان، والشيخ تميم، وحسن روحاني، قادة كل من ماليزيا وتركيا وقطر وإيران على التوالي- فكان بمثابة رعاية سياسية للمؤتمر، وتبنٍّ رسمي لفكرة التعاون بين هذه البلدان وغيرها في محاولة تلمس حلول عملية للمشكلات الكثيرة التي يعاني منها المسلمون سواء في العالم الإسلامي الممتد أو في بلدان تواجدهم في الغرب.
نتج عن القمة إبرام عدد من اتفاقات التعاون بين مختلف البلدان، لا سيما بين تركيا وماليزيا، تتويجاً للمشاركة الرسمية، وتأكيداً لمسار التعاون المنشود، لكن من الصعب القول: إن القمة قد تخطت هذه الحدود إلى ما هو أكبر وأبعد منها؛ ذلك أن محدودية عدد الدول المشاركة في القمة، ومقاطعة بعض الدول العربية والمسلمة المؤثرة وضغطها عليها، والمواقف الدولية المتوقعة تحفظاً وريبة منها، وعدد الملفات الشائكة التي يفترض لها أن تتناولها؛ كلها عقبات وتحديات رئيسة وضعت أمام القمة الوليدة، فضلاً عن أن جزءاً لا يستهان به من دعاية القمة ومجرياتها ومخرجاتها كان مقصوداً منه الاستهلاك المحلي وبعض ديناميات السياسة الداخلية في ماليزيا.
ولعل الخطاب الهادئ والحكيم الذي صدر عن معظم المشاركين في القمة، والاتفاقات التي أبرمت بين عدد من الدول الأعضاء، فضلاً عن اجتماع المئات من النخب المسلمة من مختلف الدول في حوار معمّق مما يُرَدُّ به على من اعتبروها قمة فارغة أو فاشلة أو عاجزة عن الإنجاز.
بالنسبة لتركيا، مثلت القمة فرصة إضافية لها للتعبير عن مواقفها، ورفع مستوى التنسيق مع عدد من الدول التي تتفهم -بالحد الأدنى- سياستها الخارجية وغير الغاضبة من الأدوار التي تمارسها في المنطقة، بدليل تأييد باكستان الصريح لعملية «نبع السلام» الأخيرة في سورية، وتحفظ قطر على بيان الجامعة العربية الذي أدانها، وغيرها من الأمثلة.
ومن جهة أخرى، تمثل القمة إحياءً لفكرة تركية قديمة على عهد رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، وهي مبادرة «D8″ أو الدول (الإسلامية) النامية الثمانية على غرار “G8” المعروفة، فضلاً عن كونها تصب في سياق بحث أنقرة الدائم عن حلفاء وأصدقاء وشركاء في المنطقة والعالم الإسلامي، لا سيما في ظل حالة الاستقطاب السائدة فيهما والمرشحة للاستمرار سنوات عديدة قادمة على أقل تقدير.
في المحصلة، كانت القمة تعبيراً رمزياً عن اهتمام الدول المشاركة من حيث المبدأ بفكرة الحوار المشترك بخصوص مشكلات العالم الإسلامي، لا سيما في ظل جمود وضعف المؤسسة الأم؛ أي منظمة التعاون الإسلامي، لكنها لم تزعم ولم تسعَ لتكون بديلاً لها من جهة، ولا استطاعت بالتأكيد حل أي مشكلة من مشكلات العالم الإسلامي الكثيرة والمعقدة، فضلاً عن أن تساهم بحلها جميعاً كما حلم الكثيرون.
لكنها في نهاية المطاف شكلت مبادرة يمكن البناء عليها لزيادة مستوى الاهتمام والتفاعل والتنسيق والتعاون، بما يمكن أن ينقلها لمراحل متقدمة أكثر في المستقبل، إن كان بين الدول المشاركة الآن، أو بانضمام دول أخرى إضافية مستقبلاً، وبما يمكن أن يجعل تلك المبادرة ومن تضمها من الدول قادرة فعلاً على مواجهة المشكلات الكثيرة والشائكة التي تواجه المسلمين والعالم الإسلامي.