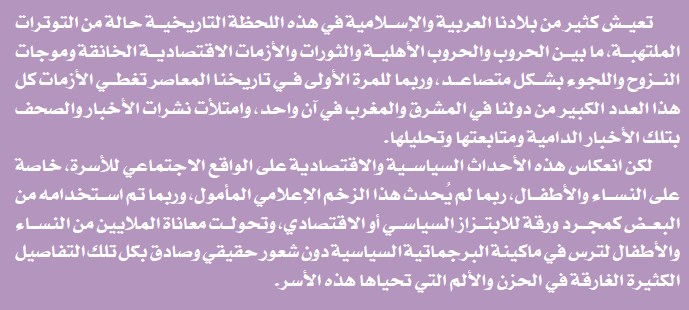
تراجع الزواج وارتفاع الطلاق:
هذه هي الملاحظة الأولى التي تسجلها الإحصاءات الرسمية في الداخل العربي وفي بلدان اللجوء؛ حتى تحدث بعضهم عن تخلخل الأسرة العربية، واستخدم آخرون مصطلح «تكسير الأسرة» بما يوحي به هذا المصطلح من آلام تطال كل أطراف العلاقة خاصة الحلقة الأضعف (أي الأطفال).
ربما يكون من الطبيعي تراجع معدلات الزواج في المناطق الملتهبة تحديداً، إلا أنها كذلك في بقية البلدان أيضاً، ربما بسبب المشكلات الاقتصادية والبطالة التي طالت الجميع، وانعكاس أجواء التوتر والترقب عليهم، وربما لأن هناك تغيرات نالت البنى العميقة لمجتمعاتنا؛ فقد تزامن اشتعال المعارك السياسية والعسكرية مع اشتعال المعارك الثقافية والفكرية المتعلقة بالأسرة تحديداً، وقادها التيار النسوي وأنصاره، ولاقت ترحيباً حاراً من المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في بلادنا.
على أن ارتفاع معدلات الطلاق ربما كان الأكثر مأساوية في المشهد؛ لتعلقه بطرف ثالث وهو الأولاد الذين يعاني كثير منهم صدمات نفسية متنوعة لم يتم الالتفات إليها بالقدر الكافي، ولعل ارتفاع معدلات الطلاق في بلاد اللجوء تحديداً تقف وراءه ما يمكن أن نطلق عليه «صراع الثقافات» لدى طالبي اللجوء؛ فالاندماج الذي يشبه الذوبان هو أحد شروط بلد اللجوء، وفي البلدان الأوروبية تحديداً فقدت الأسرة كثيراً من مبانيها ومعانيها؛ فهم لا يهتمون بمساعدة اللاجئين للحفاظ على مؤسسة الأسرة، بل العكس تماماً هو ما يحدث من خلال تقديم برامج لمساعدة النساء على التمكين بالمفهوم الغربي، في الوقت الذي لا تمتلك فيه اللاجئة الوعي الفكري والثقافي الكافي، ناهيك عن اضطراب ما بعد الصدمة الذي تعانيه في الوقت الذي يظل الرجل متمسكاً بالعادات والتقاليد الشرقية بغض النظر عن مدى ارتباطها بالدين، مع فقده قدرته على النفقة؛ لأنه لا يسمح للاجئ بالعمل، ويتم توزيع المساعدات عليهم بالتساوي؛ ومن ثم تؤدي كل هذه الملابسات الجديدة لهذا الارتفاع في معدلات الطلاق. 
الأم الوحيدة:
لا يمكن لأي كلمات أن تصف تلك المشاعر التي تعيشها تلك الأم الوحيدة؛ فبعد مقتل الزوج أو اختفائه القسري أو حتى بعد الطلاق تجد هذه المرأة نفسها فجأة في مواجهة مع كل صور التحديات الممكنة في الحياة، وقد أصبحت مسؤولة وحدها عن عائلة كاملة وأطفال صغار بحاجة للغذاء والتعليم والدواء، وبحاجة للإحساس بالأمان والحماية؛ حيث تجد نفسها مطالبة بهذه الرعاية وهي في أمسّ الحاجة لمن يرعاها هي شخصياً.
القصص التي تحكيها اللاجئات مروعة عن طريق الخروج ومحطات الرحلة المؤلمة حتى تجد نفسها وأطفالها أخيراً في مخيم اللجوء الذي قد يكون مكباً سابقاً للنفايات حيث كافة الجراثيم الفتاكة، وحيث تحشر هي وأطفالها في مكان ضيق ومزرٍ، ويفتقر لمقومات العيش الآدمي، حيث يعانون من البرد والأمطار التي قد تقتحم محل سكنهم، وحيث الطرق الموحلة بمياه الأمطار وكميات شحيحة من الغذاء، وأطفال جوعى حرموا من فرص التعليم أو ربما يحصلون على بعض التعليم غير الممنهج من متطوعين؛ فلا تدري هل كان يستحق هذا المخيم كل هذه الرحلة من الشقاء أم لا.
مخيم اللاجئين لا يعني فقط للأم الوحيدة الفقر والعوز والحرمان والجوع، بل قد يعني أيضاً التحرش الذي ربما يصل لحد الاغتصاب، حتى إن بعض اللاجئات في المخيمات أصبن بالتهاب في المثانة؛ لأنهن يمنعن أنفسهن من الذهاب للمراحيض ليلاً خشية هذه التحرشات، وبعض عمال الإغاثة متورطون في مثل هذه الممارسات الشائنة، للأسف! وفي البلاد التي لا تعيش فيها اللاجئة في المخيمات تعجز في كثير من الأحيان عن دفع إيجار سكن آدمي لائق، وقد تنام هي وأطفالها في الطرقات.
ولعل هذه المعيشة البائسة التي لا تتوافر فيها الحاجات الأساسية الأولية التي يغيب عنها الشعور بالأمن هي الدافع الأساسي لكثير من الأمهات للزواج من رجال في بلد اللجوء، أو تزويج بناتهن بهم مقابل المأوى والغذاء فقط، وعلى الرغم من أن هذا الزواج يحمل شكلاً أو صورة شرعية، وفيه مهر ولو بالغ البساطة، فإنه في جوهره يعاني من ثغرات جسيمة؛ فالمرأة التي تعاني من كل صور الاضطهاد والظلم والمعاناة كانت بحاجة للتعافي نفسياً أولاً من الصدمات التي تعرضت لها حتى تكون مؤهلة للزواج وقادرة على الاختيار الصحيح للزوج المناسب، وهذا ما لا يتوافر في زواج الضرورة، خاصة أن بعض الرجال في بلد اللجوء لا يمتلكون الوازع الديني الكافي لحماية هؤلاء الضعيفات وتعويضهن عن المعاناة اللاتي عشنها، وإنما يكون الدافع لهم مزيداً من الاستغلال لهذه الظروف في خوض تجربة مثيرة؛ حتى إن بعضهم يضمر نية الطلاق بعد حين وبعضهم يضمر نية الزواج المؤقت، وبعد الطلاق يكرر التجربة مع ضحية جديدة، خاصة أنه لا يكاد يدفع مهراً في كل هذه الزيجات.
لكن لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد في المقابل الكثير من الرجال من ذوي الخلق والدين الذين يقبلون على الزواج من اللاجئات بنية الزواج الشرعي المستقر، ولا يمنعون عنهن حقوقهن، وربما يكون بساطة المهر المطلوب حافزاً له على الزواج، ولكن نيته ليست استغلال اللاجئة، وربما يوجد من يتعمد الزواج بالأرملة ذات الأطفال من باب كفالة اليتيم، لكن تبقى مسألة أن هذه اللاجئة مضطرة للزواج بسرعة حتى تخرج من دائرة الانتهاكات البشعة التي تعيشها؛ فلا تستطيع التمييز في كثير من الأحيان بين الرجل الملتزم خُلقياً الذي يتحمل المسؤولية، والعابثين الذين يستغلون الظروف القاسية ونفسيتها المنهكة في خوض تجربة عبثية تحت مظلة الزواج، وقد تنتهي بمأساة جديدة للاجئة؛ فربما يتركها بعد أن تنجب طفلاً دون نفقة وهي لا تملك المال الذي يمكنها من ملاحقته قضائياً، حتى إن بعضهم لا يوثق الزواج أصلاً، ربما لأنها لا تملك أوراقاً ثبوتية ولا تملك المال اللازم لاستخراج مثل هذه الأوراق، وربما لأنه يتزوجها كزوجة ثانية في بلاد لا تسمح قوانينها بالزواج الثاني. 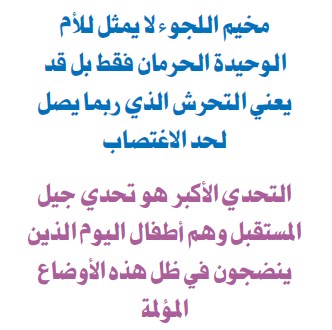
تحديات المستقبل:
لعل التحدي الأكبر الذي تواجهه الأسرة، ويواجهه المجتمع ككل، هو تحدي جيل المستقبل؛ أطفال اليوم الذين ينضجون في ظل هذه الأوضاع المؤلمة داخل بلادهم وفي بلاد اللجوء والشتات، هؤلاء الأطفال الذين قُتل ذووهم أمامهم، الذين فقدوا الآباء وعانوا قسوة الحياة مع الأمهات أو هربوا وحدهم من هول هذا الجحيم، الأطفال الذين أصيبوا ومنهم من لحقته عاهة دائمة، والأطفال الذين اعتقلوا وعذبوا، والأطفال الذين تم تجنيدهم وإلقاؤهم كوقود للحروب، الأطفال الذين تم التحرش بهم، والأطفال الذين اقتربوا من الموت جوعاً وبرداً، والأطفال الذين ماتوا في عرض البحر وهم يفرون هاربين، والأطفال الذين أوقفوا على الحدود وتم التعامل معهم بغلظة لا يعامَل بها المجرمون، والأطفال الذين تم التقاطهم ليعيشوا في مجتمعات أخرى وتم تذويبهم قسراً ومنعهم من لمّ الشمل مع ذويهم والعبث بمعتقداتهم، الأطفال الذين حرموا من التعليم، وهؤلاء الذين ماتوا بالأوبئة، والبنات الصغيرات اللاتي تم الاتجار بهن.
هؤلاء الأطفال تتجاوز مأساتهم حدود تلك اللحظة التاريخية المرهقة والمؤلمة؛ لأن نتائجها الحقيقية سوف تظهر في المستقبل، فالصدمة النفسية التي يتعرض لها هؤلاء الأبرياء تظل محفورة في عمق مشاعرهم، وتبقى الحاجة حقيقية وماسة للسعي لتحقيق الحد الأدنى من الحياة الآدمية الكريمة لهم، ورأب تلك الصدوع العميقة في نفوسهم بعيداً عن استغلال ما يعيشونه للمزايدات السياسية الرخيصة.
_______________________________________
(*) كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع.






