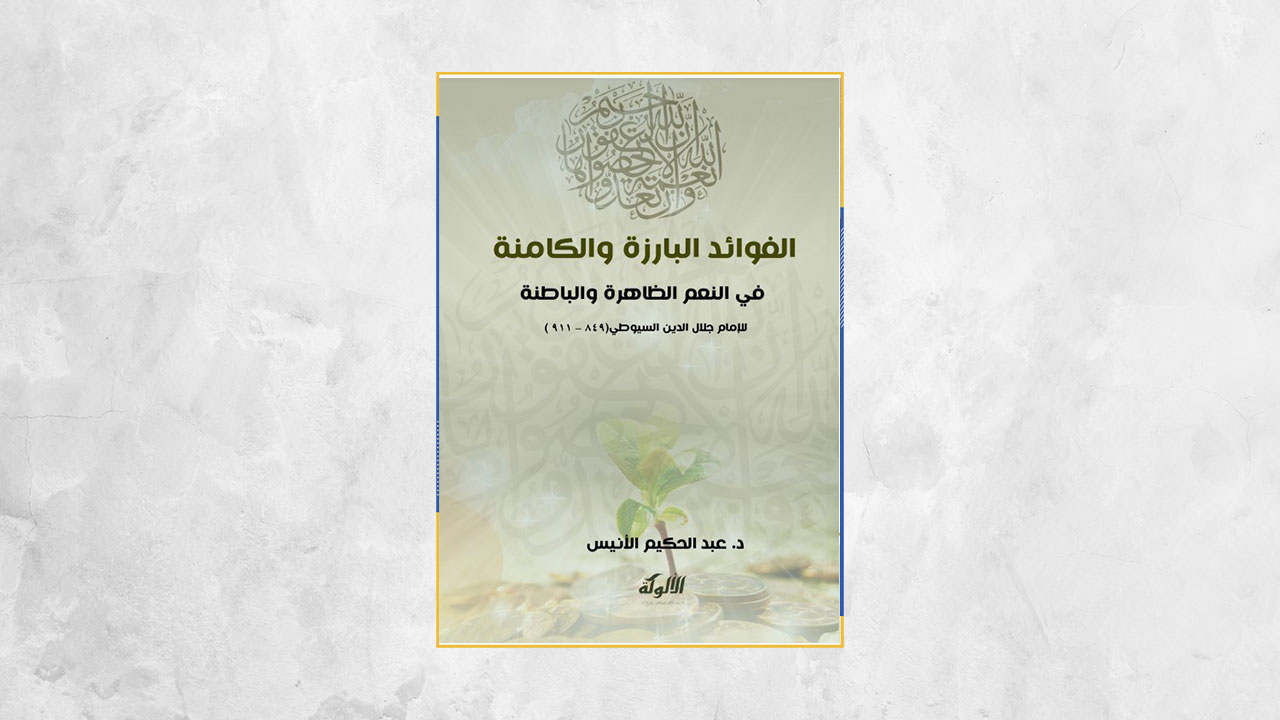وقعت يدي اليوم على شيء بعث ذكريات كنت قد أقبرتها تحت ركام من الأيام حتى نسيتها كأن لم تكن، وصدق شوقي بك حين قال: «اختلاف النهار والليل ينسي»، لعل جميعنا لديه شيء كوردة، رسالة، صورة.. إلخ، شيء يذكره بذكرى ما ويعيد عند لمسه تلك الذكرى بما حملته من مشاعر -سارة كانت أما محزنة- ذلك الشيء عندي هو قطعة من الملابس ارتديتها لأول مرة في أيام حسبتها ليالي سرمدية اجتمعت فيها ظلمات عدة، ولم ينجني من اليأس حينها إلا قوله تعالى: (لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (يوسف: 87)، ولأني لم أر في تلك الأيام سوى صعوبتها فقد أخفيت تلك الملابس مخافة أن تعيد تلك المشاعر المرهقة التي خابرتها، ولكنني اليوم أكتب عنها وقد رأيتها بمنظور جديد.
ربما تتساءل: ما الذي غيَّر منظوري للأمر؟!
إنها كلمة سمعتها من شيخ لي كان يشرح فيها كتاب الإمام جلال الدين السيوطي «الفوائد الكامنة والظاهرة في النعم الظاهرة والباطنة»، يقول فيها، رحمه الله: «الظاهرة: أنواع المسار، والباطنة: أنواع المضار، فإن لله في طي كل نقمة نعمة، وقد قال بعض السلف: كانوا يعدون البلاء نعمة وأنتم تعدونه مصيبة، وقال بعضهم: من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه»، فتساءلت كيف نعد البلاء نعمة؟ هل هذا خاص بالسلف لقوة إيمانهم؟! فوجدته يكمل فيقول: «وقد يقال الظاهرة: العطاء، والباطنة: المنع، وقد قال بعض الصوفية: إن في المنع عطاء، ولا يفهم العطاء في المنع إلا قليل» انتهى.
علقت في ذهني كلمة «قليل»، قلت لنفسي: لم لا أكون من هؤلاء القليل؟! وعزمت أن أطبق ما سمعت في أول فرصة، وحينما وقعت اليوم بين يدي قطعة الملابس تلك شعرت أنها الفرصة، فتفكرت في تلك الأيام وما حملته من نعم ظاهرة وباطنة، ربما أعمتني ثورة مشاعري واضطراب فكري عن رؤيتها، فخرجت بقولي محاكية السيوطي رحمه الله: «قد تكون الظاهرة: رحمة الله، والباطنة: التعلق بالله وهوان المصيبة»، ففي الابتلاء يدرك المرء أن كل شيء قد يزول عنه مال، بيت، صحة.. إلخ، فيشعر بضعفه وحاجته إلى ركن قوي يأوي إليه ويتعلق به، يشعر بهوان الدنيا وأنها قد تفارقه بخروج نفس لا يعود أبدًا، ويتمثل أمامه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «وأحبب من شئت فإنك مفارقه»، وقول ابن عمر رضي الله عنه: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»، فيهون في عينه الابتلاء ويصغر، ويرجو ما عند الله مما لا ينفد أبدًا.
– «وقد تكون الظاهرة: رفع الدرجات، والباطنة: رقة القلب»؛ فحينما يصيب الإنسان ابتلاء فإنه يرجو به رفع الدرجات أو مغفرة الذنوب تصديقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا يُصيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حَزَنٍ، وَلاَ أذَىً، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوكَةُ يُشَاكُهَا إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَاياهُا..»، ولكنه في الوقت نفسه لما ذاق حال المبتلى فقد يصيب قلبه رقة لحال من ابتلي مثله، ويدعو له ويهب لمساعدته متى استطاع ولو بكلمة.
– «وقد تكون الظاهرة: مساندة الأرحام، والباطنة: صلة الأرحام»؛ فلربما ينشغل الكثير منا عن تفقد حال أهله وجيرانه، ولكنه إذا نزل بأحدهم نازلة، تفقده وساعده، وقد تنكشف لك النفوس، فيقترب البعيد ويبتعد القريب، ويزداد المرء وداً وحباً لأهلك وأقاربك وتتصل الأرحام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى..».
– «وقد تكون الظاهرة: الشعور بقيمة الحياة التي اعتاد المرء عليها، والباطنة: انشغال القلب بالشكر»؛ فحينما يألف الإنسان النعم ينسى شكرها، فمن منا يحمد الله على نعمة البصر، على نعمة أن ينام ليلاً دون الحاجة إلى منومات، أن نذهب للتسوق فندفع ثمن ما نحتاج، يقول الله عز وجل: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (سبأ: 13)، ولكن حينما يفقد الإنسان منا نعمة لبعض الوقت حينها يتذكر شكر الله، فقد تجد من عانى من الأرق قليلاً حينما يستيقظ يقول: الحمد لله لقد استطعت أخيراً النوم، فقط لأنها فقدت منه قليلاً ثم عادت فشعر يقيمه ما اعتاد عليه في حياته، وانشغل قلبه بالشكر والحمد.
وإني أعلم يقيناً أني لو جلست لأبحث وأكتب عن نِعَم أخرى لتلك الأيام لما نفدت الأفكار، لأنه سبحانه وتعالى قال: (وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا) (إبراهيم: 34)، فاللهم لك الحمد والشكر على كل ما أنعمت، سواء ما أدركناه بكرمك ورحمتك أم لم ندركه بضعف بصيرتنا وغياب عقلنا.