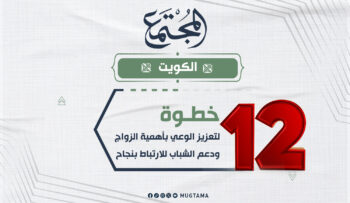لأن الإسلام «دين» و«دولة» و«حضارة»، فلقد فجر منذ ظهوره الإبداع الحضاري، مع هدايته القلوب إلى «الإيمان بالله».
لأن الإسلام «دين» و«دولة» و«حضارة»، فلقد فجر منذ ظهوره الإبداع الحضاري، مع هدايته القلوب إلى «الإيمان بالله».
فبينما اقترن انتشار النصرانية في أوروبا في القرن الرابع الميلادي ببدايات العصور الأوروبية الوسطى والمظلمة، التي بدأت في القرن الخامس الميلادي، وامتدت عشرة قرون.حتى إن أوروبا النصرانية، لم تعرف أول فلكي في تاريخها «كوبرنيكوس» (1473 – 1543م)، إلا في القرن السادس عشر، وكتابه الذي كتبه عن «دوران الأفلاك» عام 1530م، لم يطبع إلا بعد وفاته، وظل مصادراً من قبل الكنيسة حتى القرن الثامن عشر سنة 1758م! بينما حدث هذا لأوروبا المسيحية، فجّر الإسلام منذ ظهوره الإبداع الحضاري، في علوم التمدن المدني، مع علوم العقيدة والشريعة والتفسير والحديث.
إبداع حضاري
إن أوروبا المسيحية، قد تخلفت عن العلوم المدنية والطبيعية عشرة قرون، في ظل نصرانيتها، بينما فجر الدين الإسلامي الإبداع الحضاري في العلوم المدنية والطبيعية منذ القرن الهجري الأول، ولقد وقفت خلف هذا الامتياز والتميز الإسلامي أسباب عديدة، في مقدمتها:
– تميز النظرة الإسلامية لـ«الطبيعة» و«العالم» عن النظرة المسيحية لهذه «الطبيعة» وهذا «العالم».
فالطبيعة والعالم في النظرة الكنسية «مدنَّس»، في مقابل اللاهوت (المقدس)، ومملكته هذا اللاهوت الكنسي أشرف من أن تتحقق في هذا العالم «المدنَّس»! لذلك، كان الاشتغال بالعلوم الطبيعية والتجريبية عملاً شيطانياً، لأنه طلب للعلم خارج «المقدس» – الإنجيل واللاهوت – وكانت التجارب في ظل هذا اللاهوت الكنسي كالعمل اليدوي في ظل الفكر الإغريقي مما لا يليق بالأحرار والأشراف، وإنما هي من عمل العبيد الأرقاء.
اضطهاد الكنيسة
ومن هنا كان اضطهاد الكنيسة لكل الذين اشتغلوا بالعلم التجريبي، وكانت انتصارات هذه العلوم الطبيعية في النهضة الأوروبية على أنقاض سلطان الكنيسة وسلطات رجال الدين، وفي ظلال العلمانية، التي استبدلت «الدين الطبيعي» بـ«الدين الإلهي»، وجعلت العالم والطبيعة المصدر الوحيد للمعرفة، بل وألَّهت الطبيعة، وأحلتها محل الله.
مخلوق إلهي
أما الإسلام الذي اقترن فيه «الإيمان» بـ«العمل»، فإنه قد رأى ويرى في هذه «الطبيعة» خليقة مخلوقة لله، سبحانه وتعالى، مثلها في ذلك مثل الإنسان، وكل عوالم المخلوقات، فلها ككل المخلوقات شرف الخلق الإلهي، بل إن هذه الطبيعة في الرؤية الإسلامية حية مؤمنة بخالقها، وهي تسبحه كما نسبحه، حتى وإن لم نفقه نحن تسبيحها! إن لها شرف الخلق الإلهي حتى إن الإمام محمد عبده (1265 – 1323هـ/ 1849 – 1905م) كان يؤثر أن يسميها «الخليقة»، بدلاً من «الطبيعة»، ولها شرف الخطاب الإلهي لها، بل وعرض الأمانة عليها، ولها كذلك شرف العبادة والتسبيح لله!
ثم، إن هذه الطبيعة (الخليقة) قد سخرها الله، سبحانه وتعالى، بكل قواها وطاقاتها لخدمة الإنسان، فغدا عمرانها التحقيق للأمانة التي حملها الإنسان، كخليفة لله، سبحانه وتعالى: (اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ {32} وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ {33} وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ {34}) (إبراهيم).
فالبحث في هذه الطبيعة، التي خلقها الله وخاطبها وسخرها للإنسان والنظر في سننها، والاكتشاف لأسرارها، عبادة لله، وقيام بالفريضة الإلهية التي كانت أولى فرائض الإسلام، فريضة القراءة لآيات الله: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {5}) (العلق).
فالقراءة هنا قراءتان: قراءة لآيات الله الكونية والطبيعية المودعة في الطبيعة، وقراءة لآيات الله المنزلة؛ أي قراءة في كتاب الله المنظور، وقراءة في كتاب الله المسطور.
بل إن القرآن قد جعل البحث والتجريب والاكتشاف لأسرار الله في الطبيعة والكون، بواسطة العلوم الطبيعية والتجريبية، في مقدمة الأسباب الداعمة للإيمان الديني، والمفضية إلى أن يكون علماء هذه العلوم الطبيعية هم الأكثر خشية لله، سبحانه وتعالى: (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ {28}) (فاطر).
على حين كان المشتغلون بهذه العلوم الطبيعية والتجريبية – في نظر الكنيسة الأوروبية – هم المارقون والملاحدة، الذين تركوا البحث في «المقدس» (اللاهوت) واشتغلوا بالتجريب في «المدنَّس» (الطبيعة وعلومها)!
لهذه الحقائق، التي ميزت بين الإسلام وبين نصرانية الكنيسة الأوروبية، عاشت أوروبا المسيحية عشرة قرون مظلمة، بدأت بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476م، الذي تزامن مع انتشار المسيحية في أوروبا، وامتدت حتى اكتشاف «كريستوفر كولمبس» (1451 – 1506م) لأمريكا عام 1492م، وبدء الإصلاح الديني على يد «مارتن لوثر» (1483 – 1546م) في القرن السادس عشر الميلادي.
أما الإسلام، فإنه لتميزه ولتميز موقفه من الطبيعة، ولأنه دين ودولة وحضارة، قد سلك طريقاً آخر، اقترن فيه الإبداع في العلوم الطبيعية والتجريبية والمدنية بالإبداع في العلوم الشرعية، وكانت فيه الطبيعة وعلومها وآيات الإبداع فيها هي السبيل إلى معرفة الله وعظمته وقدرته، وهي السبيل إلى خشيته، بينما أدى الغلو العلماني، الذي جاء رد فعل للغلو الكنسي إزاء الطبيعة، إلى أن صاح الذين أحلوا العلم الطبيعي محل الله، صيحتهم المنكرة التي قالوا فيها: «لقد مات الله»!
شرعي ومدني
لقد برئ الإسلام من غلو احتقار الطبيعة، ومن غلو تأليه الطبيعة، حتى لقد رأينا الإبداع في العلوم الشرعية والإلهية يجاور ويزامل الإبداع في العلوم الطبيعية والتجريبية، ليس فقط في المجتمع الإسلامي، وإنما في عقل العالم المسلم، وفي المشروع الفكري لكثير من علماء الإسلام، فلم نعرف علماء للعلوم الشرعية، وآخرين للعلوم الطبيعية، وإنما وجدنا تجسد هذه النظرة الإسلامية الجامعة بين عالم الغيب وعالم الشهادة.
علوم طبيعية وشرعية
من العلماء الذين امتزجت في إبداعاتهم العلوم الإلهية بالعلوم الطبيعية: أبو الوليد ابن رشد (520 – 595هـ/ 1126 – 1198م) الذي كان الناس يفزعون إلى فتواه في «الفقه» كما يفزعون إلى فتواه في «الطب»، فهو الطبيب المجرب، والفقيه الأصولي المتكلم، والحكيم.. إنه صاحب «كتاب الكليات» في الطب، و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه، و«مناهج الأدلة في عقائد الملة»، و«فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» في علم الكلام والتوحيد.
وابن سينا، أبو علي الحسين بن عبدالله (370 – 428هـ/ 980 – 1037م) الذي كان الشيخ الرئيس في «الشرعي» و«المدني»، في «الإلهيات» و«الطيبات»، في «التصوف» و«النبات والحيوان» و«الهيئة»، فمن آثاره في الطب «القانون»، وفي الحكمة والإلهيات «الشفاء» و«المعاد» و«أسرار الحكمة المشرقية»، وفي التجريب والطبيعة «النبات والحيوان» و«الهيئة» و«أسباب الرعد والبرق».. إلخ.
والبغدادي، أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر (429هـ/ 1037م) الذي اشتهر بإبداعاته المتميزة في أصول الدين، والمبرزة في الحساب، وفي الهندسة، حتى لقد قالوا: إنه كان يُدرِّس في سبعة عشر فناً! ومن آثاره: «أصول الدين»، و«تفسير القرآن» و«معيار النظر»، و«التكملة في الحساب»، و«رسالة في الهندسة».. إلخ.
والخيام، أبو الفتح عمر بن إبراهيم (515هـ/ 1121م) اللغوي، والشاعر، والفيلسوف، والمؤرخ، والرياضي، والفقيه، والمهندس، والفلكي! ولقد بقيت لنا من آثاره: «مقالة في الجبر والمقابلة»، و«شرح ما يشكل من مصادرات إقليدس»، و«الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما»، و«الرباعيات» و«الخلق والتكليف».. وغيرها من الآثار الشاهدة على تنوعها وتكاملها على هذا المذهب الإسلامي، في تكامل مصادر المعرفة وتكامل أدواتها، وتكامل الإبداع فيها.
والفخر الرازي، أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر (544 – 606هـ-/ 1150 – 1210م) الذي كان الإمام في علوم الدين والدنيا جميعاً، حتى لقد قال مؤرخوه: «إنه كان أوحد زمانه في المعقول، والمنقول، وعلوم الأوائل»، ومن بين آثاره الكثيرة والجامعة لأقطار المعرفة وتخصصاتها، نجد: «مفاتيح الغيب» في تفسير القرآن، و«معالم أصول الدين»، و«لوامع البينات في شرح أسماء الله الحسنى والصفات»، و«الخلق والبعث» في التوحيد وأصول الدين، و«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» و«نهاية العقول» و«البيان والبرهان» في الفلسفة، و«المباحث المشرقية» في التصوف، و«السر المكتوم» في الفلك، و«النبوات» في النبوة والرسالة، و«النفس» في علم النفس، كما أبدع في الهندسة «كتاب الهندسة»، و«كتاب مصادرات إقليدس».. إلخ.