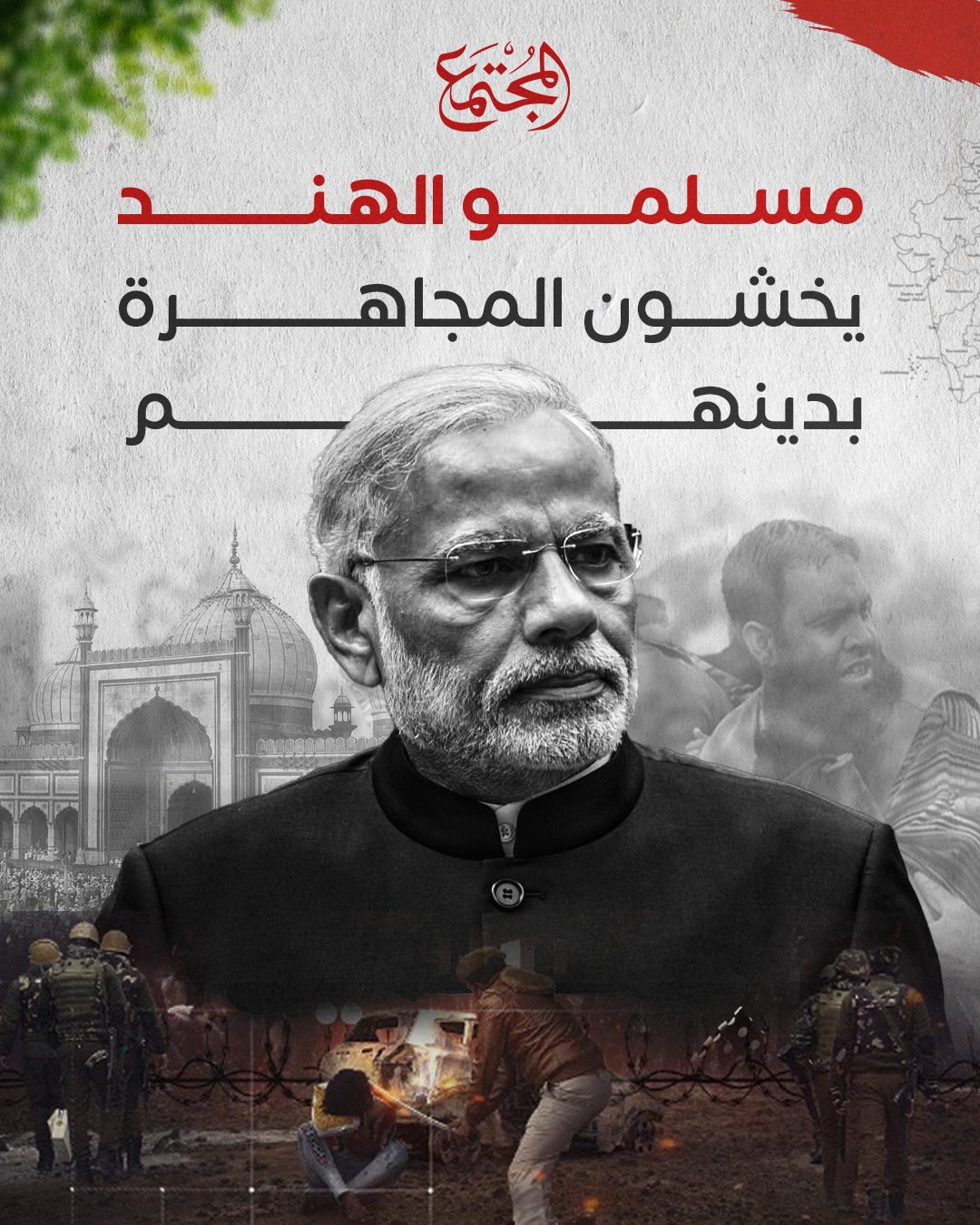خلق الله كل شيء بقدر، وأقدار الله فيها المؤلم (المكروه إلى النفس)؛ كالموت والسرقة والمرض والكوارث والحروب، وغير المؤلم (المحبوب إلى النفس)، كالرزق والذرية الصالحة وراحة البال وتحرير البلاد ودحر المحتل، ونحن مأمورون أن نؤمن بالقدر كله؛ خيره وشره، حلوه ومره.
ونحن نعتقد أنه ليس في أقدار الله تعالى ما هو على خلاف العدل؛ فإنه عزَّ وجلَّ لا يقدِّر شيئًا إلا وفيه خير للعباد، والإنسان وإن كان يتألَّم ببعض الأقدار المؤلمة (المكروهة إلى نفسه)، لكنها بعواقبها حسنة محمودة؛ ولهذا قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يناجي ربَّه: «والخيرُ كلُّه في يدَيْكَ والشَّرُّ ليس إليكَ» (رواه مسلم).
ثم إن من أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسُّنة اللطيف، من مثل قوله تعالى: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك: 14)، ولهذا الاسم معنيان عظيمان:
الأول: أن الله لطيف العلم، يعلم دقائق الأمور وخفاياها، وما في الضمائر والصدور.
الثاني: أن الله بَرٌّ بعباده، يحسِن إليهم فِي خَفَاء وَستر من حَيْثُ لَا يعلمُونَ، ويسبِّب لَهُم أَسبَاب معيشتهم من حَيْثُ لَا يحتسبون، كما قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً {2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) (الطلاق).
وإلى خلاصة هذين المعنيين أشار ابن القيم بقوله: «واسمه اللطيف يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة، وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية» (ابن القيم، شفاء العليل).
فمن لُطف الله بعبده مثلاً أن يسوقه إلى الخير، بحسب علمه بمصلحته لا بحسب مراده، بطرق خفية لا يشعر بها، فيوسف عليه السلام امتُحِنَ بالسجن، ثم خرج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرها، وكلاهما -رؤيا الملك، وانفراد يوسف بتأويلها- أمران خفيان، حصلا بعلم الله الدقيق بما فيه الخير ليوسف عليه السلام.
في ضوء ثنائية القدر واللطف الإلهيين يبرز سؤال مفاده: هل اللطف الإلهي يلازم القدر أو ينفكُّ عنه؛ بمعنى: هل يمكن أن يوجد القدر دون أن يتضمَّن لطفاً إلهياً؟
بداية، تشير قصص الابتلاءات التي تعرَّض لها صفوة الخلق من أنبياء الله ورسله إلى أن ألطاف الإله كانت ملازمة لأقداره المؤلمة، وليس أدل على هذا من قول يوسف عليه السلام بعد رحلة طويلة من الابتلاءات (مثل: فقد الأهل والوطن، وبيع إخوته له بثمن بخس، وفتنة النسوة، ومحنة السجن، إضافة لما حصل لأبيه من الابتلاء): (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (يوسف: 100)، حيث إنه اعتبر أن كل ما جرى له كان بلطف من الله.
قال لي بعض الناس: إن اللطف يلازم القدر المؤلم إذا كان ابتلاء أو اختباراً لمؤمن، وينفكُّ عنه إذا كان عقاباً لعاص أو كافر، وهذا برأيي غير صحيح؛ لجملة من الأسباب، منها:
إن الله وعد الناس ليَبْلُوَّنهم (بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ) (البقرة: 155)؛ أي: بشيء يسير منها؛ لأنه لو ابتلاهم مثلاً بالخوف كله أو بالجوع كله لهلكوا، والمحن للتمحيص لا للمحق والإهلاك.
ثم إن الله قدَّر ألَّا يَخْلُوَ عُسْرٌ مِنْ مُخَالَطَةِ يُسْرٍ (مرافق أو لاحق)، ولولا ذلك لهلك الناس، وهذا من لطف الله بعباده، قال تعالى: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ) (فاطر: 45).
ثم إن (اللَّه لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ) (الشورى: 19)، بعباده جميعاً، مؤمنهم وكافرهم، بَرِّهم وفاجرهم، فهو سبحانه خلقهم ويرزقهم، ويشفيهم ويعافيهم، ويدفع عنهم؛ لأنه سبحانه ربهم فهو لطيف بهم، وهذا لطف عام، وثمة لطف خاص بأهل الإيمان، يحيطهم الله به، ولا يُقدِّر لهم إلا ما هو خير لهم ولو كرهوه؛ لأنه أعلم بما يصلحهم.
والمقصود أن لطف الله عمَّ به الخلق أجمعين، وخصَّ به عباده المؤمنين، فما من مخلوق إلا وناله من لطف الله تعالى ما يصلحه وما تصلح به حياته، ولولا لطف اللطيف الخبير لامتلأت القلوب وحشة وخوفاً وقلقاً، ولما طابت بالحياة عيشاً.
خلاصة ما تقدَّم أن ثمة علاقة اقتران بين القدر واللطف الإلهيين، فأقدار الله تعالى لا تخلو من لطف علمه العبد أو لم يعلمه، سواء أكان القدر حلواً أم مرّاً، مؤلماً أم غير مؤلم، اختباراً أم عقاباً؛ لأجل هذا قال ابن عطاء السكندري: «مَنْ ظَنَّ انْفِكَاكَ لُطْفِهِ عَنْ قَدَرِهِ؛ فَذَلِكَ لِقُصُورِ نَظَرِه».
ومما تنبغي الإشارة إليه أن اللطف الإلهي موجود في أحوال المرء جميعِها؛ أحوال السَّعَة وأحوال الاضطرار، إلا أن أحوال السَّعَة وانتظام أمور العيش قد تكون حجاباً، يحول دون ملاحظة ألطاف الإله في أقداره؛ ولهذا كانت أحوال الاضطرار والالتجاء من أجلى مظاهر اللطف، وهو ما عبَّر عنه الطاهر ابن عاشور بقوله: «اللُّطْفُ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ» (ابن عاشور، التحرير والتنوير).
إنه برغم قسوة الأحداث التي تجري لنا في قطاع غزة منذ بدء معركة «طوفان الأقصى»، فإننا نعتقد أن لطف الله يُغَشِّينا، سواء في الأوضاع الإنسانية أو المفاوضات السياسية أو المعارك القتالية، ففي كلٍّ لطف الله حاضر؛ لَطَفَ الله بالمقاومة في السابع من أكتوبر، ولطف بها إذ حرَّر العدو بعض أسراه، ولطف سبحانه بالناجي الوحيد(1)، كما لطف بالشهيد، وصدق من قال: «لولا لطف الله بالشهيد لنجا من الموت».
في ضوء ذلك، إنه ليس على العبد إلا التقاط إشارات اللطف في القدر، لأسباب، منها: أن يكون من الصابرين على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فيُوفَّى أجره بغير حساب، ومنها: أن يكون من المعتبرين، فيصحِّح مساراته المستقبلية؛ ليمشي سويًّا على صراط مستقيم.
_____________________
(1) الناجي الوحيد: مصطلح يُطلَق على من استشهد جميع أفراد عائلته، وبقي وحيداً على قيد الحياة، وهم كثيرون في هذه الحرب، يسَّر الله من يرعى شؤونهم.