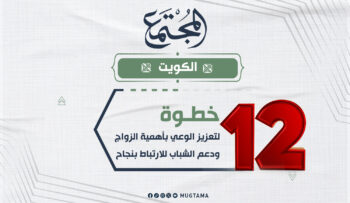هناك فرق كبير بين نمطين من مناهج الفكر، والتعاطي مع المسار الحركي.
هناك فرق كبير بين نمطين من مناهج الفكر، والتعاطي مع المسار الحركي.
الأول: النمط التقليدي الذي يشب على تصورات وقواعد وآفاق وخطط في العمل الإسلامي، ويشيب عليها، لا يقيل ولا يستقيل، دون النظر إلى تطورات الزمان والمكان والشخص، والتقدم في مجال العلوم والمعارف، والتجارب والخبرات، وما فيها من منافع وطيبات، ويظن أن الذي هو عليه هو الصواب الذي لا مرية فيه، ولا محيد عنه.
فلا يقبل بنظرية المراجعة، ولا يتقبل فكرة التطوير – رغم أننا نتحدث عن المتغيرات، بما لا يمس الثوابت – ويرفض المساس بكل معتاد عليه، ويندد بمن ينادي بمفاهيم التجديد، ويدعو إلى التحديث.
ويكون من نتائج هذا غياب المعاصرة، وسوء الرؤية في فقه الواقع، وضبابية الصورة في عالم التعاطي مع الأحداث، وجهل بفقه النواتج، وجمود في ترتيب الأولويات، ويجعل الحركة بعيدة عن الجماهير، وطبقات الشباب، مع استهلاك للوقت في الوسائل القديمات، وهذا لعمري من الملمات، ويمثل حالة تراجع لا تحمد عقباها، في الأمور كلها.
ترى أحدهم، وقد حمل رؤية ما، أو تشكل لديه موقف في العمل من المسألة الفلانية، أو غير ذلك من الصور، ثم تغيب عنه عقداً، أو عقدين، ثم تلقاه ثانية، فتجد أنه هو هو، لم يتغير، ولم يتبدل.
ربما اعتبر بعضهم هذا الأمر من الثبات ومن الصمود أمام التغيير، وهذا خلل كبير، بل مصيبة كبرى؛ لأن الخلط بين الثابت والمتحول، والنص والاجتهاد، والحكم المحكم، والاجتهاد الذي يأخذ طبيعة العرف، واعتبارها بميزان واحد، وبنفس المستوى من التعامل المنهجي، وهنا يكون الإشكال، وتسكب العبرات على واقعنا، عندما تبرز فيه مثل هذه النتوءات الخطيرة.
زرت مركزاً من مراكز العمل الإسلامي في بلد ما، ولقيت العاملين فيه، وتعرفت إلى مشاريعهم – جزاهم الله خيراً، وبارك فيهم – ومطابخ العمل فيها، فوجدت كل شيء، يحكي قصة قدم، قدم في المناهج، قدم في الوسائل، قدم في النظريات، قدم حتى في الترتيب الفني، فإذا الحكاية، حكاية مرور زمن، والأمر على ما هو عليه، دون تأثر أو تأثير!
هذا الأمر أحزنني، رغم حبي وثقتي بهؤلاء الأحبة الكرام، وقلت لبعضهم:
أرى كل شيء قديماً، لِمَ لا نطور كل شيء مما يقبل التطوير؟! لِمَ لا يكون التحسين في مساحاته الجائزة؟ لِمَ لا نخرج من مربعات كنا عليها، إلى دوائر المستقبل؟ بما حمل من خير “والحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها”.
فكان الجواب محزناً، وكنت أتمنى أن أسمع جواباً غير الذي سمعت، وما زلت آمل، أن تمضي القافلة في عالم المواكبة والمعاصرة، نحو مسارها الصحيح.
الثاني: نمط التطوير، مع المراجعة المستمرة، وتحديث قواعد العمل ووسائله، وملاحظة تغيير الواقع، فنغير معه من حال فاضل، إلى وضع أفضل، يكون ذلك، بين فترة وأخرى، مع العيش في عالمنا المعاصر، بكل حامل الكلمة من معان ودلالات، سياسة واقتصاداً واجتماعاً، ونتعاطى مع هذا الانفجار المعرفي، والاستحقاق العولمي، والتقارب في الزمان والمكان، حتى صار العالم كأنه قرية واحدة، هذا كله يملي علينا جملة من الإلزامات التي يجب أن نلتزمها، ونقوم على شؤونها بما يكافئها، من قضايا ومسائل وأمور.
ورحم الله العلماء، لما قعّدوا قاعدة “الفتوى تتغير زماناً ومكاناً وشخصاً وحالاً”، ولعل الإمام ابن القيم – رحمه الله – تكلم عن هذا باستفاضة، في كتابه القيم “إعلام الموقعين”، وفي جانب العرف نموذجاً على ما نذكر، ألف الإمام ابن عابدين رسالته الماتعة عن العرف وأثره في تغير الأحكام، والبناء عليه في تثبيتها.. “شذا العرف”.
وكل هذا بما لا يمس أصول المسائل، ولا يدخلنا في عالم التنازلات، كما يظن بعض الغيورين، بل ربما هذا الذي نشكو منه عندما يكون الأمر على هذه النتيجة.
هل من لازم عشق الماضي، بكل سلال مكوناته البشرية، ضرورة أن يكون صاحبه نابذاً لكل جديد؟! هذه حقاً مشكلة كبيرة، وهل كل تغيير وتحديث يصب في معاني التنازل والتهاون والمجاملة على حساب الحق، حتى لو كان في إطار من أطر المباح، أو صور من صور الشكل الجائز؟ هذا قلب للأمور، وتشويه للحقائق، وأمر لا يقره الشرع، وترفضه قواعد العقل.
ونحن اليوم أمام تحديات ضخام، وقضايا جسام، علينا أن نواجهها بفقه التمكين، الذي من ضرورياته، التفريق بين الثابت والمتحول، ونعمل على التطوير المستمر، في المجالات كافة، نعيش الحاضر، ونستشرف المستقبل، ونصنع الحياة، على قواعد الرشد، وميادين الجهاد بمفهومه الشامل.