مشكلة المرأة في أمريكا تتجاوز عدم المساواة في الأجور أو التحرش في أماكن العمل؛ فالفلسفة البرجماتية أفرزت بِنىً ثقافية ومجتمعية لا تدعم المرأة وتحرمها كثيراً من الحقوق الطبيعية، وما مشكلات الأم العازبة إلا نموذج لهذه الضغوط التي تعانيها المرأة هناك.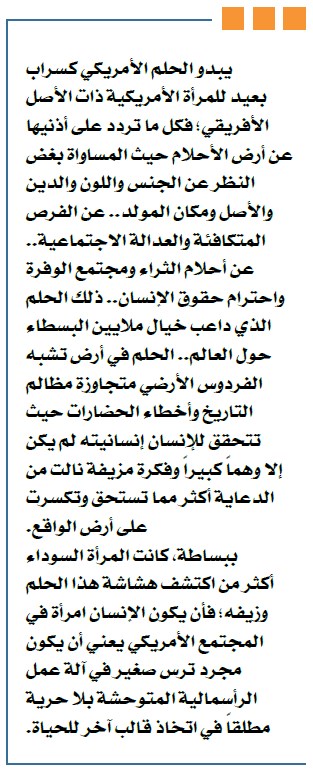
وعلى الرغم من كل القوانين والمواثيق التي تساوي بين المرأة والرجل، فإن الواقع يشهد بغير ذلك، يكفي في هذا الصدد أن نذكر ما قاله الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» عن النساء ذات مرة بأنهن حيوانات مقززة وخنازير وقاذورات، وتحدث أكثر من مرة عن علاقة المرأة بدورة المياه بألفاظ عامية سوقية، وأشار بسخرية إلى موضوع العادة الشهرية، وفي أحد تصريحاته يقول: «لا يهم ما يكتبونه، المهم أن لديهن وجهاً جميلاً و… أجمل»! ويقول أيضاً: «عليك أن تعامل المرأة بحقارة»!
«ترمب» لا يمثل استثناء في المجتمع الأمريكي؛ فكثير من الرجال الذين انتخبوه يشاركونه نفس الأفكار والقيم إن لم يكن نفس الألفاظ، وهذه هي القيمة الحقيقية للمرأة عندهم لا تلك التي يتم الترويج لها في الخارج.
على أن الأمر يتجاوز القيم والأفكار والكلام المسيء؛ حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أنه من بين كل خمس سيدات أمريكيات تتعرض أربع منهن للعنف المنزلي، وفي كل عام تتعرض ما يقرب من خمسة ملايين امرأة أمريكية للضرب والتعنيف من قبل شريك حياتها، وما لا يقل عن ثلاث سيدات يتم قتلهن على يد الزوج أو الشريك.
عنصرية تقاطعية
إذا كنتِ امرأة، وإذا كنتِ سوداء أيضاً، فهنا يتقاطع التمييز والعنصرية ضدكِ!
أما إذا كنت امرأة وكنت سوداء وكنت مسلمة؛ فهنا يجتمع عليك الاضطهاد بسبب الجنس والاضطهاد بسبب الأصول ولون البشرة، والاضطهاد بسبب الدين بحيث تبدو الفرصة شحيحة في النجاة من التعصب والعنصرية خاصة في بعض الولايات، حتى عندما تصل امرأة سوداء مسلمة إلى أن تكون عضواً في الكونجرس الأمريكي -أعلى جهة تشريعية في البلاد- فإنها لا تنجو من هذه العنصرية، هذا بالضبط ما حدث مع إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي المسلمة المهاجرة ذات الأصول الصومالية، حيث هددها أحدهم بقوله: «سأضع رصاصة في جمجمتها أو أنسفها بقنبلة.. إنها إرهابية»!
وقال عنها «ترمب»: «من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونجرس الديمقراطيات «التقدميات» اللائي جئن أصلاً من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة والأسوأ والأكثر فساداً وغير الكفؤة في أي مكان في العالم، وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة «أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض» بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا»!
بل ذهب أبعد من ذلك، حيث ألمح إلى طردها وعودتها من حيث أتت؛ «لماذا لا يعودن ويساعدن في إصلاح الأماكن المنهارة تماماً والمليئة بالجريمة التي أتين منها ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك؟»، وأخذ مؤيدوه يهتفون بصخب: «أعيدوها من حيث أتت»! 
الأسرة السوداء
على أن العنصرية التي تواجهها مثل إلهان عمر تبدو أبسط بكثير من تلك التي تعانيها المرأة السوداء العادية البسيطة هي وأسرتها، فإذا كان عدد السود 42 مليون نسمة؛ أي 13% من إجمالي عدد السكان، فإنهم يمثلون 40% من أعداد المسجونين، و26% من حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، و23% من الوفيات.
ويعاني 25% منهم من الحياة تحت خط الفقر، وفي ظلال جائحة «كورونا» تعقدت المشكلة الاقتصادية أكثر في الأسر السوداء؛ حيث فقدت 44% من الأسر وظيفة لأحد أفرادها، أو تم تخفيض راتبه، ولم يستطع 73% منهم الحصول على أي مساعدات مادية.
وكانت نتيجة هذا كله أن هناك 12 مليون طفل أمريكي أسود يعيش تحت خط الفقر يعاني من نقص الخدمات الأساسية في التعليم والصحة.
وهناك أسر تعيش حالة من التشرد، حيث يشكل السود النسبة الأكبر من المشردين الذين يتجاوز عددهم أكثر من نصف مليون شخص (عدد الشقق الشاغرة 5 أضعاف هذا العدد)، وهناك عدد كبير منهم من النساء والأطفال، وتشير بعض التقارير إلى أن نسبة النساء المشردات تمثل 40% من المشردين، واحتمال تعرضهن للمخاطر التي قد تصل للموت أو القتل مضاعفة، خاصة إذا أضفنا لذلك القسوة الرهيبة الممنهجة التي تتعامل بها الشرطة مع النساء السود، ولعل ما حدث مع مارلين بينوك المشردة المسنة السوداء التي انهال عليها أحد أفراد الشرطة بالضرب العنيف المبرح حتى أوقعها أرضاً، ثم جثا فوقها وأخذ يضرب رأسها بالأرض؛ نموذج بالغ الوضوح على الوحشية التي تنتهجها الشرطة حتى لو كانت الضحية سيدة تجاوزت الخمسين عاماً.
ومن المشكلات القاسية التي تواجهها الأسرة السوداء مشكلة الأطفال الذين يعيشون مع الأم الوحيدة التي لا تتمتع بالدعم الكافي، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية، فإذا كان 75% من جميع الأطفال البيض الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يعيشون مع الوالدين، فإن أقل من 40% من الأطفال السود من يتمتع بأسرة طبيعية مع والديه، بينما يعيش أكثر من ثلث الأطفال السود في الولايات المتحدة تحت سن 18 عاماً مع أمهات غير متزوجات، مقارنة بـ6.5% من الأطفال البيض، والواقع يشهد أنه لا تُقدَّم لهؤلاء الأمهات صور الدعم التي تلقاها النساء البيض سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية أو الثقافية، بل هناك اتجاه متزايد لسحب الإعانات؛ في حالة من تكريس العنصرية في ظل توجه عام معاد لها حتى إنه كثيراً ما توصم الأم السوداء الوحيدة بالشيطنة.
حضور الماضي
على أنه لا يمكن أن نفهم كل صور العنصرية والاضطهاد التي تلقاها النساء السود في اللحظة الراهنة دون النظر إلى ماض ليس ببعيد، ولكنه حاضر وبشدة، بل لعله لا يزال ساخناً طازجاً في الوعي الجمعي الغربي؛ فالمجتمع الأبيض ما زال منبهراً بـ «سكارلت» (بطلة رواية «ذهب مع الريح» للمؤلفة الأمريكية الشهيرة مرجريت ميتشل التي تحولت لفيلم من أهم وأشهر الأفلام الأمريكية وأعلاها إيراداً وأكثرها تأثيراً)؛ حيث تقول عن رائحة العبيد: «ولم تكد القطعة المقضومة تبلغ معدتها الفارغة المهتاجة حتى استلقت سكارلت على التراب تتقيأ بعناء، وزادت الرائحة الخفيفة المنبعثة من غرف الزنوج في اشمئزاز نفسها فاستمرت تتقيأ في صورة مزرية».
وكانت شخصية «مامي» -في الرواية نفسها- تلك السيدة السوداء السمينة التي لم نعرف اسمها أبداً هي النموذج المثالي للنساء السود -في البنية العقلية للبيض العنصريين- فهي تابعة مخلصة لسيدتها حتى بعد أن تحررت ترفض أن تتركها، وحتى عندما كرمت الممثلة السوداء التي أدت دور «مامي» بعد حصولها على جائزة «أوسكار» لأفضل ممثلة مساعدة رفضوا أن تجلس معهم في القاعة نفسها، ووضعوا لها طاولة بعيدة عن السادة البيض.. هذا الفيلم مجرد نموذج للذاكرة الجمعية الغربية التي تأصلت فيها العنصرية.
أما الذاكرة الجمعية للنساء السوداوات فهي مليئة بالجراح النازفة، وهل يمكن أن ينسين ما قام به طبيب النساء الشهير جيمس ماريون سيمز -الذي يطلق عليه «أبو علم طب النساء الحديث»- الذي قام بعمل تجارب لعمليات جراحية نسائية جديدة على نساء مستعبدات من ذوات البشرة السوداء دون أن يكلف نفسه عناء التخدير؛ لأنه كان يزعم أن النساء السود لا يشعرن بالألم وكأنهن لا ينتمين للجنس البشري! وقد صورت إحدى اللوحات الفنية الطبيب وهو يقف قبالة المرأة السوداء الجاثية باستسلام وإذعان وهو يرمقها بنظرة بالغة البرود، وقد أمسك بإحدى يديه إحدى أدوات الجراحة، بينما تراقب نساء سوداوات أخريات من خلف الستار ما يحدث وما سيتعرضن له لاحقاً.
يمكننا إذن القول: إن المرأة السوداء في أمريكا لن تنقذها حزمة القوانين والمواثيق ما دامت العقلية العنصرية التي يزكيها اليمين المتطرف هي المهيمنة على المشهد، وظلت الثقافة التي لا تحترم قيمتها الإنسانية هي المسيطرة على الشارع.






