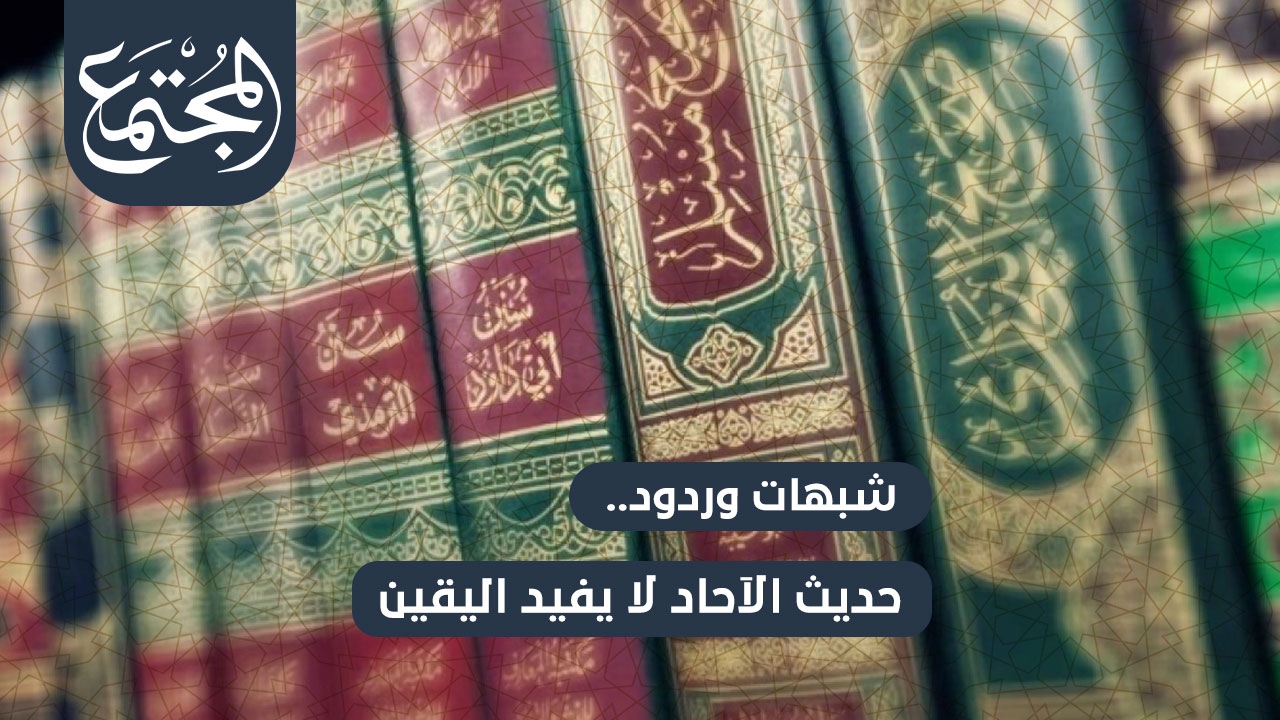يقول منكرو السُّنَّة: لو سلمنا أن السُّنَّة صحيحة وبريئة، من كل المآخذ، فإنها تعتمد في عمومها على أحاديث الآحاد، وهذه الأحاديث ليس لها دور في التشريع؛ لأنها لا تفيد اليقين، أما غير الآحاد من الأحاديث فهو نادر الوجود في السُّنَّة فماذا بقي لنا بعد ذلك من الأحاديث النبوية لنتخذه مصدراً تشريعياً ثانياً بعد القرآن(1)؟
نقض هذه الشبهة وبيان بطلانها
أولاً: يجب أن نؤكد أن حديث الآحاد أوقع خلافاً قديماً بين العلماء، هل يُعْمَلُ به أو لا يُعْمَلُ به؟ وإذا كان يُعْمَلُ به فما هو مجال العمل به؟ هل هو عام يشمل العقائد والحدود، أو خاص في غير العقائد والحدود؟ وهذا خلاف مشهور عند طلاب العلم، وقد أولاه علماء الحديث وعلماء أصول الفقه والفقه عناية فائقة ووصل إلينا هذا الأمر محسوماً بأدلته، وواقعيته في حياة المسلمين، بما لا يدع مجالاً للقيل والقال، ولكن منكري السُّنَّة كعادتهم يتصيدون أي خلاف بين العلماء ليثيروا من خلاله شبهاتهم الواهية.
ثانياً: نؤكد كذلك أن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد تقسيم مستحدث ولم يكن موجوداً في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالأفضلية، ومعلوم أن الحديث النبوي ينقسم إلى قسمين باعتبار كثرة رواة الحديث وقِلتِهم، فما كان عدد رواته قليلاً، واحداً فما فوقه، سمي الحديث “حديث آحاد” وما كان رواته كثرة مستفيضة سمي “الحديث متواتر” وهذان اصطلاحان فنيان لعلماء الحديث، أرادوا بهما ضبط بعض المسائل المتعلقة بالحديث النبوي.
ثالثاً: ينبغي أن نقرر أن العلماء حينما قسَّموا الحديث هذا التقسيم لم يحددوا بالضبط نهاية العدد الذي يعتبر به الحديث آحادياً، ولا بداية العدد الذي يعتبر به الحديث متواتراً، فبقي قدر مشترك بعد الحديثين الآحاد والمتواتر، إلا أن منكري السُّنَّة يؤكدون أن حديث الآحاد هو ما رواه واحد عن واحد من بداية السند إلى نهايته، وهذا غير صحيح، فأكثر أحاديث الآحاد جاءت من طرق وروايات وأسانيد كثيرة، مما يؤكد مضمون الحديث وصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أحاديث الآحاد أجمعت عليها الأمة، وتلقاها العلماء بالقبول، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وعملوا بها جميعاً، وهذا أيضا يؤكد ويقوي هذه الأحاديث، مثال ذلك الأحاديث الواردة في الصحيحين: البخاري ومسلم، فما زال العلماء يقبلونها ويعملون بما فيها، ومعلوم أن اتفاق العلماء على مر العصور على قبول حديث معين علامة من علامات تأكيده وقوته، وكثير من هذه الأحاديث تشهد لها آيات من القرآن الكريم، وتشهد لها أقوال الصحابة الكرام، فكل هذه مؤكدات ترفع مستوى التصديق بحديث الآحاد، وهذه المؤكدات يسميها العلماء “القرائن”، أي المؤكدات التي تثبت الأحاديث وتؤكدها، وقد رجَّح المحققون من العلماء أن حديث الآحاد إذا اقترنت به بعض هذه المؤكدات فإنه يفيد العلم الذي يفيده الحديث المتواتر.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المُخبِرين كان الخبر متواتراً، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبِرين به، فرب عدد قليل أفاد خبرُهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم؛ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم؛ وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلَمُ علماء الحديث علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول، وخبر الواحد المتلقَّى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك؛ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن؛ لكن لمَّا اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق، كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يُجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث، لا يُجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار، توجب لهم العلم، ومَن عَلِمَ ما عَلِمُوه حَصَلَ له مِن العلم ما حصل لهم” انتهى(2).
رابعاً: إن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا يعملون بالحديث النبوي الصحيح، دون التفرقة بين ما كثر سامعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قل سامعوه، وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث والعمل به هو “الصحة” وما كانوا رضي الله عنهم يطلبون أمراً زائداً على الصحة ولا يقدح في ذلك أنهم كانوا –أحياناً– يطلبون مع راوي الحديث راوياً آخر قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعه الراوي الأول، وليس هذا قادحاً في قبول الصحابة الحديث مطلقاً دون النظر في كثرة الرواة وقلتهم، لأمرين:
الأول: أن طلب الراوي الثاني لم يكن غالباً، بل ورد في بعض الحالات النادرة، ولم يحدث من أبي بكر رضي الله عنه إلا مرة واحدة، ومن عمر رضي الله عنه مرات قليلة، وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهما.
الثاني: أن طلب الخلفاء راوياً ثانياً يعاضد سماع الراوي الأول، لا يخرج الحديث من “الآحاد” إلى “التواتر” وهذا لا نزاع فيه.
ونستنتج من هذا أن الخلفاء الراشدين، والصحابة، جميعاً كانوا يعملون بالسُّنَّة الصحيحة، ولا يتجاوزون شرط الصحة من الحديث إلى أمر آخر زائد عن الصحة، فشرط العمل بالحديث هو رواية “الثقة” عن مثله، ومتى استوفى الحديث شرط الصحة وجب قبوله والعمل به، وعلى هذا جرى العمل عند رجال القرون الثلاثة الأولى.
خامساً: قد يرد حديث الآحاد ولا يعمل به، لكن لا لأنه حديث آحاد، ولكن لأمر آخر يتعلق بسنده أو متنه مثل أن يكون له معارض أقوى منه، أو تكون في الحديث علة قادحة من علل المتن أو السند أو يكون مخالفاً لعمل أهل المدينة عند الإمام مالك رضي الله عنه، أو دل دليل على نسخه، أو تخصيصه بواقعة معينة، فإذا لم يكن في المسألة إلا حديث واحد مما أطلق عليه علماء الحديث أنه “حديث آحاد” وجب العمل به في المسألة المعروضة للفتوى أو الحكم، إذا كان رواية ثقة عن مثله، ولا يجوز رده، وهكذا كان يفعل الخلفاء الراشدون فإذا رددناه فلا يخلو الحال من أحد أمرين:
الأول: أن نعمل بالرأي وهذا لا يجوز، لأن الرأي مقطوع بأنه ليس حكماً لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحديث الآحاد الذي يرويه الثقة فهو فتوى أو حكم منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك أن يكون مفيداً للعلم، أو الظن القوي، فيكون العدول إلى الرأي مع وجود النص الشرعي حكماً بغير ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ألا نقضي في المسألة المعروضة، للفتوى أو الحكم بشيء، وحينئذ يكون فيما انتهينا إليه تعطيل لشرع الله عز وجل وتعريض مشاكل الناس للاستفحال، وبعض الفقهاء يقدمون الحديث الضعيف على العمل بالرأي، وهذه حيطة محمودة، فما بالك بالحديث الصحيح، الذي رواه العدل الضابط عن مثله؟!
سادساً: إن أكثر الأحكام الفقهية قائمة على الظن القوي وما في ذلك من حرج وحديث الآحاد الذي رواه الثقة يفيد الظن القوي إن لم يفد العلم، فيجب العمل به، وقد ذكر الإمام الرازي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بحديث رسول الله آحاد أو غير آحاد ولأهل العلم المحققين أدلة من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تؤكد وجوب العمل بأحاديث الآحاد، منها:
– رسله وكتبه التي كان يبعث بها إلى رؤساء الشعوب والعشائر يدعوهم فيها إلى الإسلام، كالفرس والروم وأهل مصر وعشائر شبه الجزيرة العربية، مع جلال المهمة التي كانوا يضطلعون بها وهي أصل الدعوة إلى الإسلام.
– وكتبه وعماله إلى البلاد التي دخل أهلها الإسلام ولم يكونوا آلات صماء كما يقول بعض الناس، بل كانوا ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتوى والقضاء والفصل في الخصومات.
هذا هو موقف الأمة من صدر الإسلام إلى يوم الناس هذا، يعملون بالحديث النبوي (الصحيح) ولم يفرقوا بين حديث رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة وحديث رواه أربعون، فما أبعد منكري السُّنَّة عن الحق في كل شبهاتهم التي يثيرونها لإبطال سُّنَّة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم (قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ)(3).
_______________________________
(1) الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السُّنة، د. عبدالعظيم المطعني (1/ 182).
(2) “مجموع الفتاوى” (18/40-41).
(3) أصل هذه الشبهات من كتاب: “هذا بيان للناس.. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية”، د. عبدالعظيم المطعني، مكتبة وهبة، طبعة 1420هـ/ 1999م.