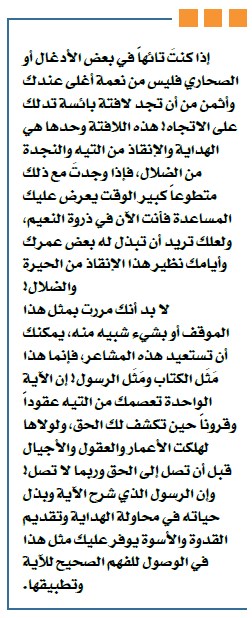 لقد ظلت أوروبا حتى وقت قريب تنظر للأعراق الأخرى نظرة دونية، ويتجادل علماؤها وفلاسفتها فيما إن كان بعض الناس بشراً أم أنهم ليسوا كذلك، وإذا وقع الاتفاق على أنهم بشر فهل هم في نفس المرتبة مع الأوروبيين، أم أنهم في مرتبة أدنى ويحتاجون بالضرورة إلى الأوروبي ليقوم بمهمة تحضيرهم واستعمالهم! وهذا نقاش قديم اشترك فيه طابور طويل من الفلاسفة والقساوسة والمنظرين والسياسيين منذ أفلاطون، وأرسطو، مروراً بجون لوك، وجوبينو، ولا يزال يتجدد في أيامنا هذه مع صعود اليمين ونظريات العرق الأبيض.
لقد ظلت أوروبا حتى وقت قريب تنظر للأعراق الأخرى نظرة دونية، ويتجادل علماؤها وفلاسفتها فيما إن كان بعض الناس بشراً أم أنهم ليسوا كذلك، وإذا وقع الاتفاق على أنهم بشر فهل هم في نفس المرتبة مع الأوروبيين، أم أنهم في مرتبة أدنى ويحتاجون بالضرورة إلى الأوروبي ليقوم بمهمة تحضيرهم واستعمالهم! وهذا نقاش قديم اشترك فيه طابور طويل من الفلاسفة والقساوسة والمنظرين والسياسيين منذ أفلاطون، وأرسطو، مروراً بجون لوك، وجوبينو، ولا يزال يتجدد في أيامنا هذه مع صعود اليمين ونظريات العرق الأبيض.
وفي عصر الاحتلال الأوروبي للعالم، الذي هو عصر النزعة العلمية (العلموية)، قدمت هذه العلوم خدماتها للساسة في تبرير وشرعنة احتلال الشعوب، بإنتاجها نظريات التفوق الطبيعي للأوروبي الأبيض ونظريات التدني والانحطاط الأصيل لبقية الشعوب، وهذا مجال واسع اشترك فيه طابور طويل من علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع والمستشرقين، مثل صمويل مورتون، وكارل فون ليناس.
ولا يمكن الحديث هنا عن نظريات علمية مجردة، أو آراء موضوعية ناتجة عن مجرد التأمل والتفكير والبحث، بل إن الغرائز والشهوات والأطماع والمصالح السياسية والاقتصادية تضغط على الإنسان وتشكل أفكاره وتؤثر في نظرياته، إن الأمر يؤول في النهاية إلى «اتباع الهوى» وأخلاق الشح والأثرة والظلم والاستبداد، ولكن هذه الدوافع تتزين بالنظريات العلمية والآراء الفلسفية.
هنا تبدو القيمة العليا والنعمة العظمى بوجود نص إلهي مقدس يقول: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: 13)، وبوجود رسول يقول: «لا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح»، ثم إن هذا الرسول قضى حياته لترسيخ هذه المعاني حتى صار القرشي عمر بن الخطاب يقول عن الأسود الحبشي بلال: «سيدنا»!
ولهذا فلم تتطور نظريات وبحوث المسلمين –من مؤرخين وأدباء ورحالة- نحو العنصرية التي تحطّ من إنسانية الأقوام الآخرين، غاية ما هنالك أن يوجد من حاول تفسير بعض الظواهر الاجتماعية أو التاريخية أو النفسية من خلال اللون والبيئة والمناخ والحجم، بينما لم يكن ثمة من نزع عنهم الإنسانية أو رآهم في مرتبة أقل من البشر أو في مرحلة مما قبل التاريخ، بل شهد التاريخ الإسلامي صعوداً قوياً لطبقات العبيد الذين أُسِروا إلى مراتب السياسة والجيش، منذ العصر الثاني للدولة العباسية مروراً بالمماليك والانكشارية، فضلاً عن صعودهم بما حققوه في العلم والعبادة، حتى انتشر ذكرهم حتى في كتب الزهد والرقائق.
لولا وجود هداية النص وهداية القدوة لما وصلنا إلى ترسخ معنى المساواة بين الناس، إذ مهما اجتهد بعض الفلاسفة والمنظرين والمفكرين في إثبات أن البشر جميعاً متساوون في الإنسانية، فإن هذا لن يعدو أن يكون قولاً ضمن أقوال، ورأياً ضمن آراء، حتى لو سُجِّل في حقبة ما ضمن وثائق عالمية لا تساوي –عملياً- ثمن الحبر الذي كتبت به! بغير وجود النص المقدس والعقيدة الدينية التي تأمر بالمساواة وتحرص عليها لن يكون ثمة عاصم من انزلاق الفكر إلى الآراء والنظريات البغيضة التي تجيز استعباد الإنسان والحط منه!
وفي هذا المعنى يقول الرئيس المجاهد علي عزت بيجوفيتش، رحمه الله: «إن المساواة والإخاء بين الناس ممكن فقط إذا كان الإنسان مخلوقاً لله، فالمساواة الإنسانية خصوصية أخلاقية وليست حقيقة (مادية)، إن وجودها قائم باعتبارها صفة أخلاقية للإنسان، كسمو إنساني أو كقيمة مساوية للشخصية الإنسانية، وفي مقابل ذلك إذا نظرنا إلى الناس من الناحية المادية فالناس غير متساوين.. فطالما حذفنا المدخل الديني من حسابنا سرعان ما يمتلئ المكان بأشكال من اللامساواة؛ عرقياً وقومياً واجتماعياً وسياسياً، إن السمو الإنساني لم يكن من المستطاع اكتشافه بواسطة علم الأحياء أو علم النفس أو بأي علم آخر»(1)؛ ولهذا فقد لاحظ المستشرق الفرنسي الشهير جوستاف لوبون «أن العرب يتصفون بروح المساواة المطلقة وفقاً لنظمهم السياسية، وأن مبدأ المساواة الذي أعلن في أوروبا قولاً لا فعلاً راسخ في طبائع الشرع (الإسلامي) رسوخاً تاماً، وأنه لا عهد للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماعية التي أدى وجودها إلى أعنف الثورات في الغرب ولا يزال يؤدي»(2).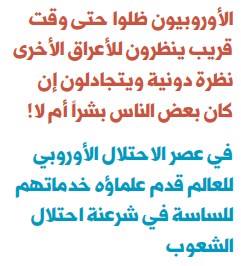
يفتح موضوع العنصرية نقاشات طويلة، فللكاتب أن يفرد حديثه عن عظمة الإسلام في التعامل مع الأقوام المفتوحة، أو عن عظمة الفقه الإسلامي في التعامل مع حقوق العبيد والأرقاء، أو عن تاريخ العبودية وجرائم الاحتلال الغربي في أفريقيا لأربعة قرون على الأقل، أو حتى عن أوضاع السود والملونين في أمريكا حتى الآن، إلا أن ثمة باباً في هذا الموضوع لا يزال لم يُفتح بعد، وذلك هو ما تواتر وتكاثر في روايات غير المسلمين –من المستشرقين والمؤرخين والرحالة الأجانب- عن تعامل المسلمين مع عبيدهم وأرقائهم، فقد أنتج هؤلاء في القرون الثلاثة الماضية كثيراً من المؤلفات والتقارير التي مهدت لمرحلة الاحتلال ورافقتها ولا تزال مستمرة حتى الآن، وقد سجَّل كثيرٌ من هذه المؤلفات أحوال البلاد العربية والإسلامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمنها ما كان تشويهياً، ومنها ما كان منصفاً، ومنها ما كان واقعياً، ومنها ما زادت فيه جرعة الخيال، إلا أنها في كل الأحوال مصادر تاريخية لا غنى عنها، ثم إنها تتميز في موضوعنا هذا بكونها شهادة «شاهد من أهلها»، فهي بيان وحجة على لسان أعدائنا لتاريخنا العظيم الذي هو شعبة من تفسير قول الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء: 107)، وقول الله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110).
سنحاول في هذه السطور القادمة التقاط شذرات بسيطة من مناطق متفرقة، على سبيل فتح الباب أو حتى فتح الشهية، لعل باحثاً يتفرغ له فيخرج منه بسفر عظيم.
تركيا:
أفرد المستشرق البريطاني الشهير توماس أرنولد فصلاً عن تحول العبيد المسيحيين إلى الإسلام في العهد العثماني، وذلك في دراسته الشهيرة الضافية «الدعوة إلى الإسلام»، وكانت مادة هذا الفصل خليطاً من الأقوال والتحليلات التي تحاول تفسير لماذا اندفع العبيد النصارى إلى اعتناق الإسلام، فالأمر المؤكد أن الذين اعتنقوا الإسلام حتى وهم في العبودية كانوا أكثر بكثير جداً ممن بقوا على المسيحية.
وقد ذهب المؤرخون النصارى مذاهب كثيرة في تفسير هذا التحول، وفي التحسر عليه كذلك، والتقط بعضهم أن السر في ذلك هو ما للعبيد من حقوق مرعية، يقول: «كان للرقيق كما كان لسائر المواطنين حقوقهم، بل قيل: إنه كان للعبد أن يقاضي سيده إذا أساء معاملته، وأنه إذا تحقق القاضي من اختلاف طباعهما اختلافاً بيّناً إلى حد تعذر الاتفاق بينهما فله أن يرغم السيد على بيعه»، وقد نقل أرنولد بعض أقوال الغربيين المتحسرين على إسلام العبيد النصارى لما يرونه من حسن معاملة المسلمين، فمن ذلك: «في الوقت الذي لم يقض على أجسامهم بما أظهره لهم من رعاية وتقوى، صمم بدهائه الشيطاني على أن يقتل أرواحهم بتجريدهم من إيمانهم، ويمكن أن يشهد على هذه الحقيقة تلك الجموع من المؤمنين الذين لا يدخلون تحت حصر؛ ذلك أنه على الرغم من أن كثيرين منهم كانوا على غاية الاستعداد بأن يموتوا في سبيل العقيدة المسيحية.. قد نفث فيهم، بإنقاذهم من الموت الجسدي، وحملهم إلى الأسر، فأفسدهم بمرور الزمن، ودفعهم بخسة إلى أن يُنكروا إيمانهم بالمسيح»، وسجل رحالة إنجليزي في القرن السابع عشر أنه «كان قليل منهم يعود إلى وطنه؛ وأقل منهم من كان له من الشجاعة والثبات ما يمكنه من الاحتفاظ بدينه المسيحي»(3).
الكويت:
أقام ضابط الأمن السياسي البريطاني ه.ر.ب. ديكسون حوالي ربع قرن في منطقة شمال الجزيرة العربية وشرقها، وكان له دور سياسي مهم في خضم النفوذ البريطاني المهيمن على المنطقة، وجاء كتابه «عرب الصحراء» بمثابة تقرير شامل عن حياة سكان هذه الأنحاء، ويقع هذا الكتاب –كما يرى كثيرون- ضمن الكتب التشويهية في كثير من الأمور؛ مما اضطر دار النشر إلى حذف بعض الفصول والفقرات التي اشتدت فيها جنايته على الشخصيات والموضوعات، ومع ذلك، فنراه يقول في شأن تعامل العرب مع عبيدهم: «الغالبية من الناس يعاملون عبيدهم من العاملين في خدمتهم بالأعمال المنزلية معاملة حسنة، ولا أبالغ إذا قلت: إن بعضهم يعاملهم كأطفالهم تماماً، فلهم حرية التزاوج بالطريقة المناسبة وبمساعدة أسيادهم، ولهم الحق بالتناسل بمقدار ما يشاؤون، ويعامل أطفالهم كما يعامل أطفال أسيادهم، يلعبون معاً ويعيشون معاً، ولا أبالغ إذا قلتُ: إن سيدات البيت يعاملن هؤلاء معاملة أفضل، وحتى في بعض الأحيان لا تختلف عن معاملة أخت لأختها»(4).
الحجاز:
من أشهر الرحلات الاستشراقية وأشملها رحلة تشارلز داوتي إلى الجزيرة العربية، فإنها حافلة بالتفاصيل، وقد ترجمت في أربعة مجلدات إلى اللغة العربية، قضى فيها صاحبها عامين في أنحاء الجزيرة العربية (1876 – 1878م)، ومن أعجب ما ورد فيها مما يخص حديثنا هنا أن داوتي رأى عبيداً أفارقة في الجزيرة يحمدون الله على فضله أنهم صاروا عبيداً، وذلك أن هذه العبودية كانت طريقهم لاعتناق الإسلام وسكنى أرض الحرمين.
يقول داوتي: «ظروف العبيد هي دوماً أمور مقبولة في الجزيرة العربية، وغالباً ما تكون ظروفاً سعيدة؛ والعبيد هنا ينشؤون باعتبارهم إخواناً مساكين وفقراء لأبناء الأسرة، وهو نوعٌ من مكافأة الرب لرب الأسرة المسلم المتدين، وهو العم لهؤلاء العبيد أثناء عبوديتهم، وهو أيضاً الأب بالنسبة لهم.. ورب البيت هنا إذا كان من النوع الذي يخشى الله ويخافه يعتق عبيده خلال بضع سنوات قلائل؛ وهو لا يعتقهم ويرسلهم لحال سبيلهم خاويّ الوفاض؛ ولكن في الجزء المرتفع من الجزيرة العربية (حيث لا يمتلك العبيد فيه سوى الأغنياء)، يقوم ذلك الرجل الطيب بتزويج العبد المعتوق سواء أكان ذكراً أم أنثى ويعطيه شيئاً من ثروته ومقتنياته.
هؤلاء الأفارقة لا يحسون بأي قلق أو ضيق لأنهم كانوا عبيداً في يوم من الأيام -إنهم في أغلب الأحيان يكونون أسرى من الحروب- بالرغم من أن تجار العبيد كانوا يختطفونهم من والديهم، كان الرعاة الذين يتبنون أولئك العبيد ويشترونهم يضمونهم إلى عائلاتهم، ويقومون بتختين الذكور منهم –وكان ذلك يُقَوِّي من روح هؤلاء العبيد المعنوية، حتى فيما يتعلق بعاطفة الحنين إلى الوطن القوية- لقد نظر الله إليهم في محنتهم، وبوسعهم أن يقولوا: هذا فضل الله، لأنهم استطاعوا عن طريق ذلك الذي حدث لهم أن يدخلوا في الدين المنقذ، ومن هنا فهم يعتقدون أن هذا البلد، الجزيرة العربية، هو الأفضل حيث أعتقوا فيه، وأن الحياة المدنية في هذا البلد أفضل من بلدهم، وأن هذه هي بلاد الحرمين الشريفين، أرض محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك شكر هؤلاء العبيد الله على بيع أجسادهم في أسواق العبودية»(5).
ليبيا:
توقف المؤرخ الإيطالي إتّوري روسّي متعجباً، وهو يرصد وضع تجارة الرقيق في طرابلس الغرب (ليبيا) في منتصف القرن التاسع عشر، ومجهود أوروبا وبالذات الإنجليز في محاربة هذه التجارة و»إنقاذ» العبيد، وخلص بعد الاستعراض إلى القول: «الغريب أن عملية الإنقاذ هذه قد تعرضت لصعوبات جمة، من قبل هؤلاء العبيد أنفسهم، الذين عاد عدد كبير منهم إلى أسياده، بعد تحريرهم وإعتاقهم، كما تعود البهائم المعتادة على النير وحمل الأثقال، عاجزين عن أن يشقوا لأنفسهم طريقاً خاصاً مستقلاً، وقد تخلوا في غير أسف عن تلك الحرية التي لم يرغبوا فيها، رغم ما كان يُوَفَّر لهم من حماية ومساعدة.
ومن الحق أن يقال: إن وضع هؤلاء العبيد، لم يكن سيئاً قاسياً، وأن أصحابهم كانوا يعاملونهم معاملة إنسانية في العادة، كما أن أوضاع العبيد في البيئة الإسلامية لم تكن مهينة، كما يمكن أن تبدو على ضوء الأفكار الحديثة، في المساواة بين البشر»(6).
مصر:
كان جوزيف بتس بحاراً إنجليزياً لكنه وقع في أسر الجزائريين عند السواحل الإسبانية في حروب القرن السابع عشر، فبقي أسيراً وزار مع سيده مكة، وكتب رحلته إلى الحج، وفي أثنائها مر بمصر، فوصف فيها حال العبيد والجواري على هذا النحو: «في الجزائر أعترف أن إجبار الرقيق على التحول للإسلام ليس أمراً شائعاً، رغم أنني –علم الله- قد عانيت بما فيه الكفاية منهم، لكن في مصر وتركيا –دعني أؤكد- أن الأمر يختلف؛ فالجواري والعبيد الذين هم في مرحلة الشباب يلحقون مباشرة بالمدارس لتعلم القراءة والكتابة، فهم مخلوقات جاهلة بائسة، وحقيقة فإنهم بعد تحولهم للإسلام تسير أمورهم في هذه الأنحاء على نحو أفضل، وقد يتفوقون كأبناء سادتهم إن كانوا أذكياء، ويقال: إن هؤلاء المتحولين للإسلام يلقون حظوة أكثر من الأتراك الأصلاء.. ويفخر العبيد والجواري الذين بيعوا هنا أن يوسف عليه السلام قد تم بيعه في مصر»(7).
وبعد قرنين من رحلة بتس؛ أي في منتصف القرن التاسع عشر، وصل إلى القاهرة أشهر رحالة إنجليزي في عصره وهو ريتشارد بيرتون الذي ملأت رحلاته ثلاثة وأربعين مجلداً، وكان يجيد خمساً وعشرين لغة، وكانت رحلته للحج في ثلاثة مجلدات، الأول منها هو ما كان في وصف الأحوال في مصر، وجاء فيه: «لقد عرف الإنجليز لتوِّهم أن العبيد ليسوا بالضرورة أكثر الناس بؤساً وأحطهم مرتبة، فهناك من لديه الشجاعة الكافية ليخبر الشعب الإنجليزي أن الرقيق في بلاد الشرق عامة يأكل أفضل بكثير من الخدم أو حتى أفراد الطبقات الدنيا ممن ليسوا عبيداً، وهذا أمر حقيقي.
فالشريعة الإسلامية تلزم المسلمين بمعاملة رقيقهم برقة بالغة، والمسلمون –بشكل عام- حريصون على الأخذ بتعاليم نبيهم، فالرقيق يعد فرداً من أفراد الأسرة.. وعندما لا يكون العبد راضياً بمعيشته ففي وسعه أن يجبر سيده على بيعه بالطرق المشروعة، والعبد في بلاد الشرق لا ينعى همَّ الطعام أو السكن أو اللباس أو الاستحمام، كما أنه مُعفى من دفع الضرائب، ومُعفى من الخدمة العسكرية ومن دفع أي مبالغ لسيده»(8).
إن المتأمل في الأحوال العامة للعبيد في عموم تاريخنا الإسلامي سيجد أنهم كانوا في حال أفضل من حال السجين في السجون المعاصرة، بما في ذلك السجون الغربية، وكلما أطلنا التفتيش في تاريخنا وتراثنا –بشرط أن نتخلص من ضغط الثقافة الغالبة- ازدننا إيماناً أن نبينا إنما هو «رحمة للعالمين»، وأن البشرية تنتظر صحوة هذه الأمة لتزيل ما رسخ في أقطار هذه الأرض من الجرائم والمظالم.
___________________________________________________________
(1) علي عزت بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة: د. محمد يوسف عدس، ط1 (القاهرة: دار الجامعات، 1997م)، ص100.
(2) جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، 2000 م)، ص391.
(3) توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن وآخران، (القاهرة: مكتبة النهضة العربية، 1971م)، ص200 وما بعدها.
(4) ديكسون، عرب الصحراء، ط2 (دمشق – بيروت: دار الفكر – دار الفكر المعاصر، 1998م)، ص456، 457.
(5) تشارلز داوتي، ترحال في صحراء الجزيرة العربية، ترجمة: صبري محمد حسن، ط2 (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2009)، الجزء الأول، المجلد الثاني، ص384، 385.
(6) إتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى 1911، ترجمة: خليفة التليسي، ط2 (طرابلس: الدار العربية للكتاب، ص1991م)، ص452.
(7) جوزيف بتس (الحاج يوسف)، رحلة جوزيف بتس إلى مصر ومكة والمدينة المنورة، ترجمة ودراسة: د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ، (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1995 م)، ص37، 38.
(8) ريتشارد ف. بيرتون، رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز، ترجمة وتعليق: د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ، (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1994 م)، ص63.






