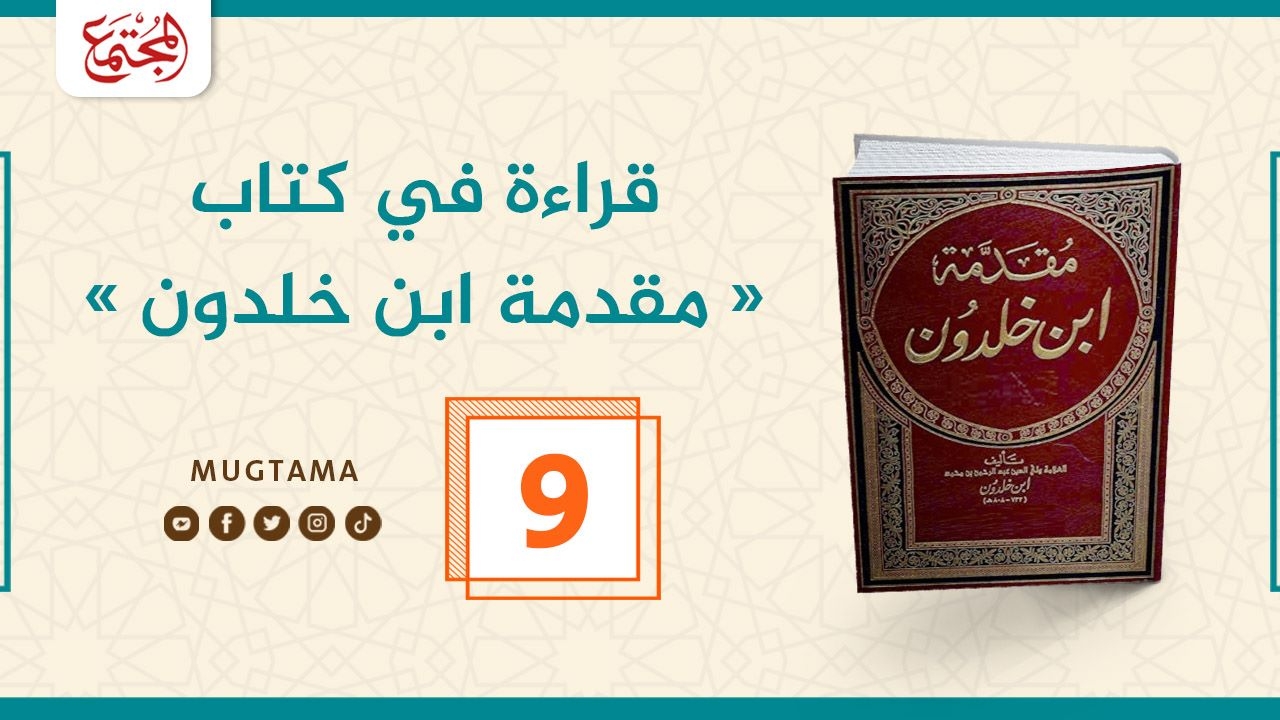وقفنا في الحلقة السابقة عند اتجاه العلاَّمة الراحل ابن خلدون إلى المشرق، بعد استئذان السلطان في أداء فريضة الحج.
قال ابن خلدون: «ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء أنواره وقضاء الفرض والسُّنة في مطافه ومزاره، والوقوف على آثاره في دواوينه وأسفاره، فأفدت ما نقصني من أخبار ملوك العجم بتلك الديار، ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار، وأتبعت بها ما كتبته في تلك الأسطار وأدرجتها في ذكر المعاصرين لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك الأمصار منهم والضواحي».
ويقصد بالمطاف بيت الله الحرام، ومزاره المسجد النبوي، وهنا هو ينتقل بكتابه من البعد المغربي إلى التاريخ العام حيث كتب عن البربر ثم العجم والقبط والترك والعرب، ثم أضاف إليهم من عاصرهم من ملوك البلدان فأصبح التاريخ ليس مغربياً فقط، كما كان ينوي، وكما كتبه في أوله، وإنما أمسى تاريخاً عاماً، بعد أن اطلع على ما كان من أمر ملوك المشرق ودولهم.
قال: «وأدرجتها في ذكر المعاصرين لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك الأمصار منهم والضواحي، سالكاً سبيل الاختصار والتلخيص، مفتدياً بالمرام السهل من العويص»، فهو استبدل السهل بالصعب، لأنه يريد أن يصل إلى الناس، ولا يضعهم في مشكلات فهم، رغبة في زيادة الوعي.
استشراف للمستقبل
قال: «داخلاً من باب الأسباب على العموم إلى الإخبار على الخصوص»، وهنا هو يُذكّر بأُسس مدرسته، حيث يبحث عن العلل والأسباب مع الأصول والجذور والأحداث وشؤون الدول وقيامها وأصلها وفصلها.
قال: «فاستوعب أخبار الخليقة استيعاباً، وذلل من الحِكَمِ النافرة صعاباً، وأعطى لحوادث الدول عللاً وأسباباً، وأصبح للحكمة يعني الفلسفة صواناً وللتاريخ جراباً»، وكأن كتابه هو دولاب الحكمة، فمن أراد فلسفة فليفتح كتاب ابن خلدون ليجد الفلسفة: فلسفة الدول، فلسفة الهزيمة، فلسفة التطور.. إلخ، ومن أراد أن يعرف ما حدث فعليه كذلك بكتابه حيث الأحداث على حقيقتها، لأن كتابه مرويٌ بالأسانيد وليس مروياً عبر التلاقي من أفواه الرجال.
قال: «ولما كان مشتملاً على أخبار العرب والبربر من أهل المدر والوبر والإلمام بمن عاصرهم من الدول الكبر، وأفصح بالذكرى والعبر في مبتدأ الأحوال وما بعدها من الخبر، سميته كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»، المدر هو الطين ويُكنِّي به العربُ عن العمران المبني بالطين، والوبر هو البيت المعمول من صوف الأغنام أو الإبل؛ وهي الخيام التي يتخذها أهل البادية، وفي الحديث الصحيح: «ليبلغن هذا الدين ما طلعت عليه الشمس، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل».
قال: «ولم أترك شيئاً في أولية الأجيال والدول، وتعاصر الأمم الأول، وأسباب التصرف والحِوَل، في القرون الخالية والملل، وما يعرض في العمران، من دولة ومِلة، ومدينة وحِلَّة، وعزة وذلة، وكثرة وقلة، وعلم وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة، وبدو وحضر، وواقع ومنتظر».
والحِوَل هو التحول عن الأشياء والكائنات والأماكن وما إليها، يقول رب العالمين: (لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً) (الكهف: 108)، فكتابه لم يترك فيه شيئاً من أسباب التحول التي أصابت الدول والقبائل، أما «الحِلَّة» فهي القرية الصغيرة، فهو جمع أخبار المدن الكبيرة وجمع أخبار القرى الصغيرة التي لها أهمية وقيمة كي يعرف الإنسان ما جرى.
وهنا ذكر ابن خلدون استشرافه للمستقبل، واستقراءه للأحداث، فلديه قوانين واضحة، للصعود أو السقوط في حياة الأمم، وليس هذا من قبيل ضرب الودع، ولكنه معرفة من خلال دراسة الواقع لاستشراف ما سيحدث في مقبل الأيام.
قال: «لم أترك شيئاً من هذا إلا واستوعبت جمله، وأوضحت براهينه وعلله، فجاء هذا الكتاب فذاً بما ضمنته من العلوم الغريبة، والحكم المحجوبة القريبة»، ورغم أن العرب يقولون: «شدة القرب حجاب»، فطول العشرة مع الالتصاق لا يرينا المزايا أو العيوب، ولكن ابن خلدون يريد أن يقول: إن هناك حِكَماً قريبة يراها الناس كل يوم ولا يشعرون بها؛ ولذلك هي قريبة محجوبة، ومحجوبة بالقرب، بينما هي قريبة جداً إلى الناس لو فكروا وتأملوا.
قال: «وأنا من بعدها موقن بالقصور بين أهل العصور، معترف بالعجز عن المضاء في مثل هذا الفضاء، راغب من أهل اليد البيضاء والمعارف المتسعة الفضاء في النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء والتغمد لما يعثرون عليه بالإصلاح والإغضاء»، وهنا يذكرنا ابن خلدون بمعنى عظيم، لأنه رحم الله امرءاً أهدى إليَّ عيوبي، وصديقك من صَدَقَكَ لا من صَدَّقَكَ، فهو يرجو من أهل العلم الذين تتسع معارفهم أن ينظروا في كلامه بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء، وأن يتغمدوا أخطاءه بالإصلاح وما إلى ذلك، والتغمد معناه الستر، والإغضاء يعني التسامح وعدم التوقف عند الخطأ.
قال ابن خلدون: «فالبضاعة بين أهل العلم مزجاة، والاعتراف من اللوم منجاة، والحسنى من الإخوان مرتجاه، والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وهو حسبي ونعم الوكيل»، والمزجاة يعني الرديئة، والإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» قال عن نفسه: «وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجاة»؛ ولذلك امتلأ كتابه بالأحاديث الضعيفة، وإن كان مات وهو يقرأ في صحيحي مسلم، والبخاري، وكان يدعو الله في خاتم حياته: «اللهم إيماناً كإيمان عجائز نيسابور».
وبعد هذه المقدمة، هناك صفحتان قال فيهما ابن خلدون: إنه سيهدي هذا الكتاب إلى الملك العظيم الهمام كذا كذا كذا»، وهذه أوصاف الله أعلم بها لم نعش عهده حتى نقر بصدقها، ولا مبرر لقراءتها والوقوف عندها، فإن كل الذين أهدوا الكتب للملوك والحكام أشادوا بهم إشادة لا تبلغ الأوهام وبعض هؤلاء أحقر من الأصنام؛ (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ) (الأنبياء: 98).