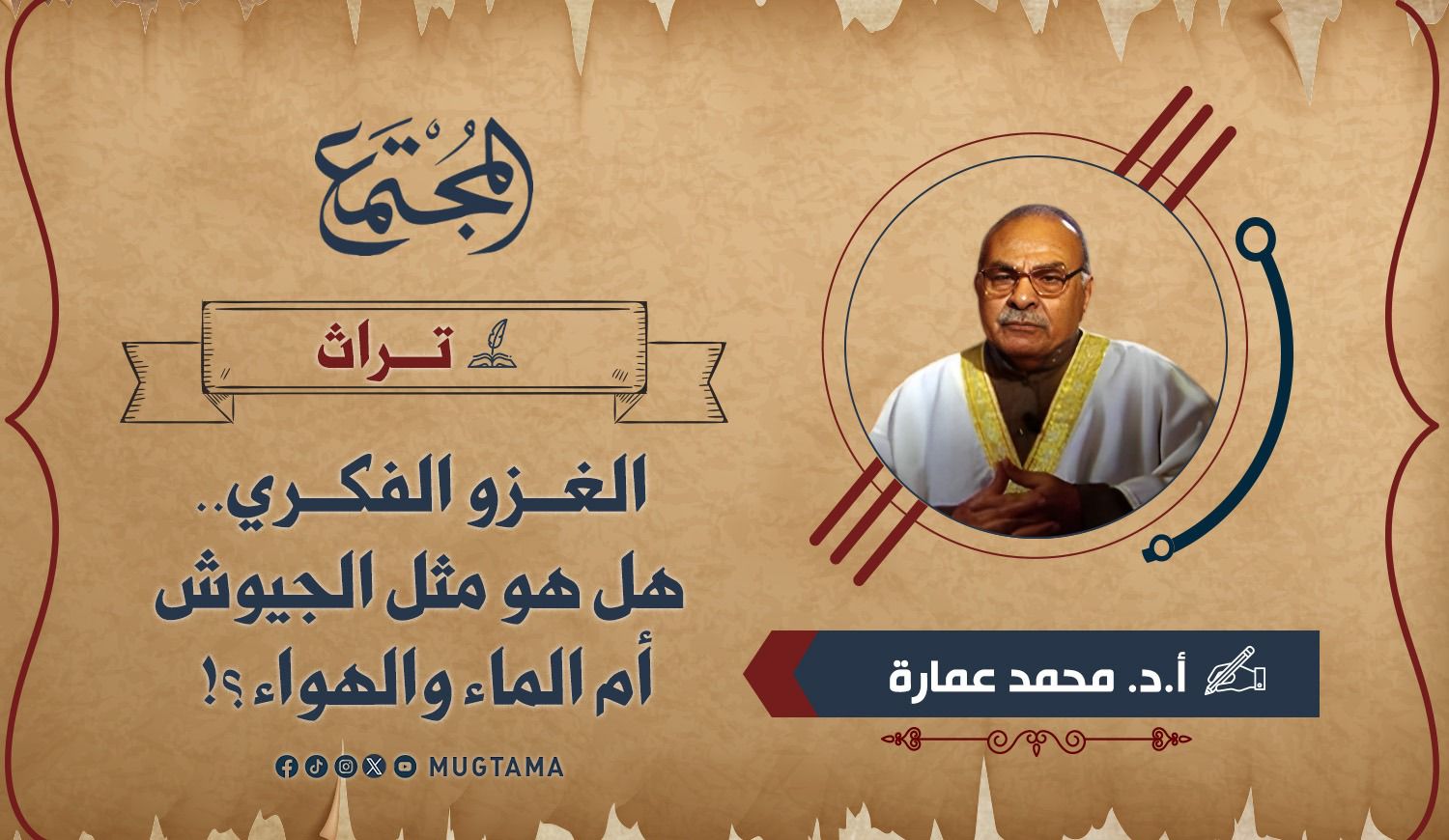من سنن الله تعالى في الخلق أن يكون أسوأ ما يتعرض له الناس شيئاً من صنع أيديهم ونزعات قلوبهم، ولذا فإن علينا دائماً ألاّ نسلّط الوعي على الحجارة التي تُوضع في طريقنا، وإنما على الحفر التي نحدثها بمعاولنا.
ومن الملاحظ في هذا السياق أن كثيراً من المثقفين يملكون البراعة والعدة البيانية الكافية التي تمكّنهم من الظهور بمظهر الضحية، وتمكّنهم من التنصل من المسؤوليات الملقاة عليهم، لكن ما لدى المسلم من حبّ للحقّ، وما لديه من إخلاص وصدق وحرص على بلوغ الأحسن، يدفعه دفعاً نحو وضع شؤونه الخاصة تحت المجهر، ومحاولة رؤيتها بقدر جيّد من الموضوعيّة.
والحقيقة أن المشكلات التي يتعرّض لها المثقف المسلم وصانع الخطاب الدعوي مشكلات كثيرة جداً، ومن الصعب الإلمام بها، ولو على نحو سريع، فلنعرض إذاً إلى بعض ما نراه مهماً منها:
1- ثمة داء واسع الانتشار يتعرض له كل من يهتم بالشأن الثقافي ومن كل الاتجاهات والتيارات، وذلك الداء يتمثل في الرغبة الجامحة في الطفوّ على السطح، وتعجّل الظهور أمام الناس بغضّ النظر عن مدى امتلاكه للأدوات المعرفيّة وبلورته للمنهج الفكري والعلمي الذي سيسير عليه في صياغة خطابه. هذا التعجّل يتم في أحيان كثيرة بسبب ضعف شعور المثقف بمسؤولية التصدي لمهام التثقيف والقيادة الفكرية للناس. ومن وجه آخر فإن هذا التعجّل يتمّ بسبب الإغراءات الكثيرة التي يقدّمها الإعلام، ويقدّمها المجتمع أيضاً لكل من يُظن أنه أضحى (شخصية عامة)، أو نجماً تلفازياً.
المشكلة أن صانع الخطاب اليوم إذا كان ناجحاً فإنه قد يؤثر في الملايين من الناس. وهو عبر رسائله المستمرة يشكّل لديهم اتجاهاً ثقافياً، له محكّاته وملامحه ومطالبه.. ثم إذا به يكتشف أن مذهبه الفكري والإصلاحي الذي نشره على أوسع نطاق، يحتاج إلى تعديل وتهذيب، وربما إلى تغيير جذري، وفي هذه الحالة فإن كثيرين منا يخشَوْن أن يُدخلوا -من خلال التعديل- الاضطراب على تلك الأعداد الهائلة التي شكّلوا وعيها. وأحياناً لا يكون هذا هو الهاجس، وإنما النقص في الشجاعة الأدبية المطلوبة للنقد الذاتي، والتبرّؤ من رؤية أو مذهب أو اتجاه.. ومن ثم فإن الذي يتم هو كتم الأفكار الجديدة في الصدور، أو إشاعتها في وسط ضيق عن طريق الأحاديث الشخصية والخاصة. وهذا على المستوى الأخلاقي شيء خطير للغاية، هناك مثقفون كثيرون لا ينظرون إلى شيء من هذا وذاك، ومن ثم فإنهم ينتقلون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولكل يمينه ويساره مما يجعل قرّاءهم وطلابهم عاجزين عن فهم المنهج الذي يسيرون عليه؛ فتكثر الأقاويل والتفسيرات، ويشيع الغمز واللّمز.
ويحدث ما هو أخطر من هذا، وهو ضعف الثقة بالقيادة الثقافية والفكرية، والزهد في أي خطاب توجيهي، وكلنا يذكر ما جرى من التحوّل المفاجئ لأعداد كبيرة من المثقفين على امتداد العالم من النقيض إلى النقيض، وذلك حين انهار (الاتحاد السوفيتي)؛ إذ رأينا الكثيرين ممن كان يُنَظّر لتحكم الدولة، والاقتصاد الاشتراكي، وحقوق العمال، وقد صاروا بين عشية وضحاها من دعاة الليبراليّة والتعدديّة وحقوق الإنسان واقتصاد السوق، وبعضهم فعل ذلك بفجاجة وغلظة غير مدرك خطورة ما أقدم عليه!
وفي الساحة الإسلامية رأينا كثيرين من الكتاب والمفكرين اشتغلوا ردحاً من الزمن بالحديث عن انهيار البلد وتفاقم الأوضاع وضرورة الإسراع في الإصلاح قبل فوات الأوان… وبعد مدة إذا بهم يعرضون عن كل ذلك، ويشرعون في الحديث عن التربية وتعليم الناس أمور دينهم وأهمية النهوض بالفرد.. وصار إلى جانب ذلك لا يألو جهداً في إيجاد المسوّغات للأوضاع السائدة!
وكم من مثقف كان الحديث عن الشعر والأدب والنقد شغله الشاغل، فإذا به يتحول عن ذلك إلى التحدث في الشؤون السياسية والقضايا الإستراتيجية والتنموية.. لا شك في مشروعيّة الترحال والتحوّل الثقافي؛ إذ إنه يعبر عن استمرار النمو والنضج لكن بشرط ألاّ يتم ذلك بدوافع مصلحية وانتهازية. ومع هذا فإنه يجب أن يتم بوضوح تام، ويجب أن يشرح المثقف لأولئك الذين كوّن وعيهم، وأثّرت فيهم ملامح رؤيته الجديدة، وأسباب انتقاله وتقويمه للمرحلة السابقة.
وهذا في الحقيقة لا يحدث إلا قليلاً؛ إذ إننا تعودنا دائماً الحديث عن إنجازاتنا وفتوحاتنا الفكرية والثقافية، ونجد في الوقت نفسه صعوبة بالغة في الحديث عن الأشياء التي لم نفهمها والأخطاء الثقافية التي وقعنا فيها. وهذا يعود إلى البيئة الاجتماعية التي لا تفتأ تلحّ على الظهور بمظهر الكمال في كل الظروف والأحوال!
لا يخفى أن كثرة اختلاط المثقف بالناس وانفتاحه عليهم على نحو مسرف، يحرمه من العثور على الوقت المطلوب للتأمل في تحوّلاته الفكريّة، ولتجديد ثقافته والتواصل مع المنتجات الفكرية الجديدة، مما يجعل ما لديه من أفكار ومقولات معرّضاً للتقادم والتآكل، والذي ينتج عنه التكرار المملّ.
الخلاصة أن علينا التريّث في الظهور والاستعداد له على نحو مناسب، وإذا وجدنا أنفسنا مغمورين بالأضواء، فلنتعلم كيف نخطو خطوة إلى الوراء حتى نظل على تواصل مع مصادر التثقف، وعلينا إلى جانب هذا أن نحدس بالتطورات الثقافية القادمة من أجل المزيد من الوعي بالموقف الفكري الذي يجب أن نتخذه منها، وذلك بقصد تجسيد العلاقة بين الحاضر والمستقبل وإضفاء المنطقية على حركة الفكر خلالهما.
2- المثقف المسلم مهدد دائماً بأن تتحول مهمته التبليغيّة والإرشادية من رسالة تملأ العقل والروح، وتشغل البال إلى حرفة أو وظيفة أو التزام أمام فلان وعلان. إن الذي يصنع خطابه وهو موقن بشرف المهمة التي يتصدى لها، وبأهميتها في إصلاح الناس، يتكلم ويكتب ويحاور، وهو مشتعل حماساً وحيوية وأملاً ببلوغ مراضي الله تعالى، ونيل توفيقه. إنه يجعل من طاقته ووقته وقوداً حياً لتحريك المجتمع في الاتجاه الصحيح.
وإن من شأن هذه الحالة أن تولّد الإبداع والفاعلية والاستمرار في العمل، إنه بسبب إخلاصه وصدقه وحماسته يظهر قدراً كبيراً من الفرادة والتميّز، ويعبّر عن تجربة فذة وغنية، وسيكون الأمر مختلفاً جداً حين يتكلم الإنسان لأنه خطيب جمعة. وحين يعظ لأنه عُيّن على وظيفة واعظ وإلا لما وعظ. وحين يكتب يومياً لأن هناك عموداً يجب أن يقرأه الناس يومياً وقد طرّز اسمه.. إن العمل حينئذ سيكون رتيباً وكئيباً، ويكون عند الحد الذي يسمح باستمراره ليس أكثر. وهذه المشكلة واسعة الانتشار إلى درجة أنها تصلح مفسراً –مع تفسيرات أخرى- لحالة عدم الفاعلية التي نراها لدى كثير من الكتاب والدعاة. قد نكون في هذه المرحلة بحاجة إلى عدد كبير من الأبطال الذين يرفعون الرايات، ويقدمون النماذج الرفيعة في الحرص على التأبّي على التحوّل من موقع الرائد إلى موقع الموظف أو المنتفع. وما أشدّ الفرق بين النائحة والثكلى!
3- التحزب أو الانحياز الفكري خطر آخر يهدد المثقف المسلم وغير المسلم. إن عظمة الأفكار تكمن في قدرتها على الرفرفة، وفي طلاقتها وقدرتها على التعبير عن الكرامة الشخصية والتعبير عن حرية الإدراك والقرار.
وهذه السمات تشكل الأساس الذي نمنح بناء عليه المصداقية للمجتهد والمفكر والداعية. إن المفكر الحر لا يستند في حريته الفكرية إلى التأبي على المساومة والتوظيف من قبل أصحاب المال والنفوذ فحسب، وإنما يملك إلى جانب ذلك المنهج الذي يمكنه من مقاومة (التأطير) الذي يهدد كل صانعي الخطاب. هناك فرق كبير بين مفكر اتخذ من مبادئه وعقيدته وخلاصة تجربته خلفية فكرية وثقافية توجهه، وإطاراً يتفاعل معه، ويتحرك في داخله، وبين مفكر انتسب إلى حزب أو جماعة أو مؤسسة، أو صار موظفاً لدى دولة، فأصبح ولاؤه الجديد عبارة عن إطار داخل الإطار الإسلامي، وأحياناً يتحول إطاره من إطار صغير إلى إطار كبير يتداخل مع الإطار الإسلامي، وهذا يعني أن ذلك المثقف أو المفكر صار منحازاً إلى رؤية جزئية أو اجتهاد فئوي، أو صار معبراً عن مصالح ضيقة لا تتطابق مع مصالح الأمة.
ليس هناك خطورة كبيرة في الأصل في أن يجد المرء نفسه ميالاً إلى اجتهاد دعوي أو إصلاحي دون غيره، لكن من المهم أن يكون على وعي بأنه مهدد بالتقزم الفكري والانحسار في الفهم للخريطة الفكرية والثقافية التي يجب أن يدركها، ويستحضرها عند تحليله وتقويمه للأشياء. وحين يتوفر هذا الوعي فإن المثقف المسلم سيعمل دائماً على محاولة التحرر من قيود ثقافته وانتماءاته وذلك من خلال رؤية الأشياء من زوايا متعددة، ومن خلال الحرص على تفهم طروحات الآخرين والحرص على إنصافهم.
4- كثيراً ما يشعر المثقف أنه يرى ما لا يراه غيره ممن يحيطون به، وهذا كثيراً ما يولّد لديه مشاعر نرجسيّة صفويّة، كما يولّد لديه الاعتقاد بإمكانية فهم الواقع ومعرفة هموم الناس من غير مخالطتهم، وقد لاحظنا أن تشكيل ثقافة النخب قد تحول إلى ما يشبه الصناعة المغلقة؛ فصور الواقع يرسمها المثقفون، ويقومون بتحليلها، ويتداولونها بينهم، وهم وحدهم الذين يبتكرون الحلول للمشكلات ويشخّصون الخارج من الأزمات، وكثير منهم تكيّفوا مع أفكارهم، ويتوحّدون مع ذواتهم لاعتقادهم أنهم يعيشون في مجتمعات جاهلة وفاسدة، وهذا ما يجعلهم يشعرون بالغربة والعزلة الهامشية. وقد انعكس ذلك على طروحاتهم التغييرية، فهي ما بين سوداء ورماديّة!
إن الشعور بالتفوق شيء يصعب الاحتراز منه، وكون المثقف يرى ما لا يراه غيره صحيح نسبياً، لكن لا ينبغي لهذا وذاك أن يحرمنا من التغذية الراجعة وقراءة ردود أفعال الناس على ما نخاطبهم به، كما لا يصح أن يحجبنا عن سبر الواقع عن طريق الإحصاء والمعايشة الفعلية وعن طريق الحوار مع الناس العاديين المستهدفين بالرسالة التثقيفيّة.
5- إذا عدنا إلى الوراء مئة سنة من الآن، فسنجد أن المثقف النخبوي كان هو الأكثر أهمية على الساحة، ونخص بالذكر طلاب العلم الشرعي وحاملي الثقافة الشرعية. إنهم يشكلون المرجعية للناس، ويؤثرون فيه ويعيشون معهم ألوان معاناتهم اليومية. أما اليوم فقد اختلف كل هذا على نحو جذري، وهذا الاختلاف يعود إلى وجود خطابات عديدة تنافس الخطاب الإسلامي، وتشوّش عليه، كما أن وظيفة الثقافة العليا إسلامية وغير إسلامية، في صياغة الثقافة الشعبيّة وتوجيهها قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها. وما نسمع عنه اليوم من متابعة وتصويت لبعض البرامج المخجلة والتافهة، يوضح لنا أن تنظير المثقفين ومعالجاتهم باتت في واد، وبات معظم الناس في واد آخر.
إن الخطاب الثقافي النخبوي وكذلك الخطاب السياسي يفقد زخمه وتأثيره وجاذبيته على سبيل التدرّج بسبب التغيّرات العالمية، ولا سيما ما حدث على صعيد الثورة التقنية في مجال البث والاتصال. والحقيقة أن التغيرات التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة؛ وذلك بسبب بروز مؤثرين جدد في الحياة الاجتماعية من خارج الدوائر التقليديّة لصناعة الفكر والمعرفة.
وقد صار لرجال الأعمال والإعلام ومهندسي الحاسبات ومصممي الأزياء ونجوم الطرب والكرة- حضور قوي ومتابعة شعبية كثيفة، تفوق متابعة رافعي مشاعل المعرفة وموقدي مصابيح الفكر. ومن المؤسف أنك حين تلتقي بكثير من صانعي الخطاب الإسلامي تجد أن طروحاتهم ورؤاهم وآمالهم في الإصلاح والتجديد والنهضة بعيدة كل البعد عن اعتبار المعطيات الجديدة، وذلك لأنهم يكفرون بالطريقة نفسها التي فكر بها أسلافهم قبل ثلاثة قرون.
وقد صار لمن كانوا يُسمّون بالعامة والغوغاء وضعيّة عامة تؤثر فيها الأفلام والمطاعم الأمريكيّة، والأذواق والأزياء الأوروبيّة على نحو طاغٍ ونافذ، ولم يشعر كثيرون منا بهذا، ولا حاولوا التكيف معه على نحو إيجابي.
إن على المثقفين أن يدركوا حدودهم الجديدة، وأن يعيدوا النظر في المفاهيم والمقولات التي كانوا يدركون من خلالها الواقع العام للأمة. كما أن عليهم أن يدركوا على نحو دقيق ما تبقّى لهم من دوائر التأثير، ويحاولوا الاستثمار فيها بشكل مكثف، بالإضافة إلى إدراك المسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيّرات الإيجابيّة والسلبيّة الحديثة.
إن التأمل هو التفكير ، وليس هناك شيء أولى بتسليط نور الوعي عليه من الوضعيّة التي صار إليها أولئك الذين عليهم أن يشخّصوا أدواء الأمة، ويصفوا لها العلاج.