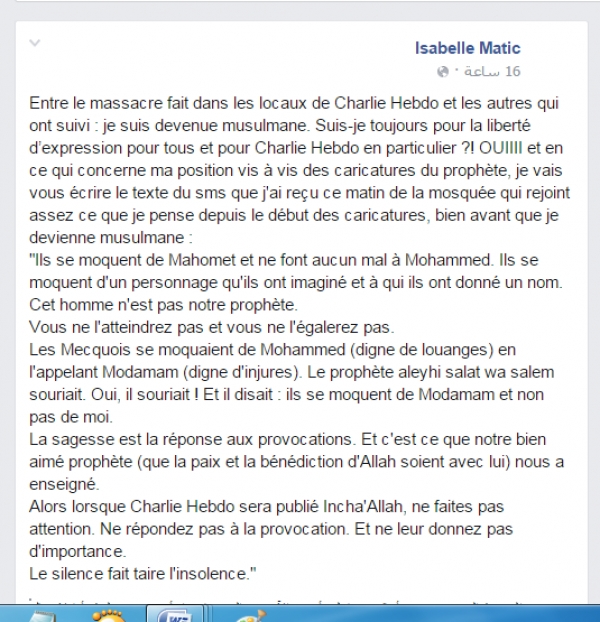هذه دراسة سريعة لكتاب “أبي أمي.. نحن متهمون”، للدكتور علي شريعتي، الصادر عن مركز الدراسات التاريخية والاجتماعية في لندن عام 2014م.
هذه دراسة سريعة لكتاب “أبي أمي.. نحن متهمون”، للدكتور علي شريعتي، الصادر عن مركز الدراسات التاريخية والاجتماعية في لندن عام 2014م.
ومجمل الكتاب أن شاباً يبدأ بطرح الأسئلة التي تراوده حول المظاهر السلبية الملازمة للتشيع وحسب تصوراته للإسلام عموماً كاتهامه الإسلام بدين “لا”، وما جدوى قراءة القرآن؟ وأن الصلاة ليست سوى رياضة تكرارية، وأن الصوم عبارة عن تغيير مواعيد العشاء والغداء، وعن معنى الحج خصوصاً وأن الشيعة يصلون في المناطق المحيطة أكثر من صلاتهم في الحرم نفسه، وعن معنى تضحية الحسين (رضي الله عنه) بنفسه من أجل الأمة على نهج المسيح والحلاج كما يتصور، وهي أمور ليس لها أساس في العقيدة الإسلامية أصلاً!
وكثير من الأسئلة يطرحها بخلفية علمانية ووجودية؛ نظراً لتأثره بـ”جان بول سارتر”، و”ألبيركامي وأرنست رينان”، كما تدل عليه سياقات الكتاب، وهو يضع الأسئلة ثم يجيب عنها، فكانت معظم الأجوبة أسوأ من الأسئلة.
وعندما يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة؛ فإنه ينطلق من خلفية شيعية تؤمن بالشيوعية باسم محاربة الفقر، وعقلية وجودية خاصة لتبرير وحدة الوجود، وهما السمتان الأبرز اللتان لازمتا الحركات الشيعية، وما نتج عنهما من إفرازات القرامطة الإسماعيليين، وحركات الحشاشين، وحركات التصوف الباطني كالحلاجية والبكداشية التي عملت على نسف فكرة الخالق وحولتها إلى فكرة وحدة الوجود، وما صاحبها من أفكار الاتحاد والحلول التي نشرتها الباطنية تحت غطاء التشيع لآل البيت؛ وبالتالي استسهال الالتزام بالفرائص ثم التخلي عنها.
والحقيقة أن علي شريعتي وأمثاله هم في صراع فكري داخلي لتبرير التشيع على الضوء اليساري والعدمي، وكلما أوغلوا في تبريراتهم ازدادوا بُعداً عن المفهوم الشامل للإسلام، وهي واحدة من سمات الفكر الشيعي المضطرب طوال التاريخ.
علماً أنه يقول: إن التشيع هو أكثر التفسيرات تقدمية في مدرسة الإسلام الفكرية، ولا يقول لنا: أي تشيع يتبع؟ هل الاثنا عشري الذي ينتظر المهدي الذي اختفى عام 260هـ، أم هو الإسماعيلي الشيعي الذي ظهر مهديه عام 297هـ وأسس الدولة الفاطمية، أم الزيدي الذي يجيز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، ناهيك عن تشيع الفرق الغالية مثل النصيرية فالقائمة تطول؟
إن هذا اللا توازن الفكري والتعصب المذهبي الباطني يدفعه للقول: “إن التشيع هو الإسلام ولا شيء غيره”، ويقول: “فهو فهم تقدمي مضاد للأرستقراطية والعرقية والطبقية وحاكمية البشر”، ثم يتهم الإسلام اللا شيعي بأنه فتح الاستقرار للنظام الطبقي والنظام الحاكم في الإسلام، وهو في هذا السياق يضع نفسه في سياق ساذج لا معنى له؛ أي نظام الإسلام عموماً هو نظام اجتماعي غير متوازن، فليس النظام أو الدين هو الذي يخلق التفاوت بين الناس، بل إن جهد الإنسان وعمله قد يخلق هذا التفاوت، بالإضافة لعوامل كثيرة لا مجال لذكرها يدركها أي إنسان واقعي، يقول الله تعالى: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً) (الزخرف:32)، وقوله تعالى: (فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ {71}) (النحل).
وهذه اللجاجة تدفعه للتطاول على الله؛ فيعطي الشروط للإيمان بالله فيقول: “إن ذلك الإله الذي أؤمن به، وذلك الدين الذي أؤمن به؛ ليس دين تبرير الفقر”، ويقول: “إن المذهب الذي ينمو فيه الفقر والشقاء ليس مذهبنا”، وفي كل هذه الطروحات فهو يهاجم الإسلام بصورة غير مباشرة؛ ليقدم لنا ديناً جديداً باسم الإسلام على الطريقة الباطنية.
ولا يوجد دين أو مذهب يرسخ الفقر، ولم يحارب دين الفقر كما حاربه الإسلام بجعل الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام حيث وردت 30 مرة في القرآن ومقترنة بالصلاة 28 مرة، وأن أبا بكر رضي الله عنه قد قال: “والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه”.
ويزداد إيغالاً في ترسيخ فكرة خيالية على أن علي (رضي الله عنه) هو مؤسس النظام الاشتراكي في الإسلام، وهو تهافت لا معنى له على الإطلاق، ويصوره على أنه صاحب نظام إلغاء الطبقات بقوله: ويصوره على أنه صاحب نظام إلغاء الطبقات بقوله: “فعلي الذي صار له نظام اقتصادي خاص به، واشتراكية تقود إليه”، وهي كلها ادعاءات باطلة وأكاذيب، فالمدة القصيرة التي تولى فيها علي رضي الله عنه كانت فترة مليئة بالحروب والمنازعات، ولم تشهد أي نوع من أنواع النظام الاقتصادي الخاص، ولم يشذ عن القرآن والسُّنة قيد أنملة.
والحقيقة أن هذه الادعاءات ما هي إلا تنفيس خفي عن عقدة “الرهاب الأموي” الذي تعاني منه النفسية الشيعية، وخاصة الفارسية داخل اللاوعي الشيعي، فيقول عن إسلامه هذا: “هو إسلام أبي ذر، وتشيع أبي ذر والذي كان يرفع شعاراته لا ضد نظام الكفر بل ضد نظام عثمان وجامع القرآن وناشره، إنه يثور ضده ويقاتله! هذا هو التشيع”.
نعم، هذا هو التشيع، فهو التطاول على الذي تستحيي منه الملائكة ذي النورين عثمان رضي الله عنه والذي أنفق جل ثروته في سبيل الدعوة للإسلام، ولعل أغرب تقلباته تكمن بتخليه عن تشيعه؛ فيدعي الإسلام عندما يهاجم الخلافة خارج التشيع فيقول: “إنني كمسلم أعترض طوال تاريخ الإسلام على خلافة الجور التي تدعي اتباع سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون هناك قيادة على أساس مبدئية الإنسان المعصوم؛ أي طاهر النفس ليس خائناً دنساً تكون له قيادة البشرية”.
إن الانتماء والتاريخ الأموي الذي لا يفتأ الفرس بتجريحه والنيل منهما أمران مقصودان بالكامل، فالحضارة الأموية في الأندلس مازالت شاهدة على أعظم حضارة قامت في تاريخ الإسلام، ولم ينتشر الإسلام وتترسخ أقدامه كما انتشر أيام الدولة الأموية!
وفي محاولة باطنية للنيل من القرآن، فهو يصف مسألة رفع المصاحف في موقعة “صفين” بطريقة وقحة؛ فيصفه بـ”القرآن كراية على رؤوس الجريمة”، وهو “القرآن ككتاب يصنع من قبل قبائل بدائية مبعثرة في صحراء وفيما لا يزيد عن ربع قرن محددي مصير العالم وقامعي القوى العالمية”، وبهذا فهو يشطب على مسألة قبول الإمام علي رضي الله عنه المعصوم بنظره لمسألة التحكيم التي أعقبت رفع المصاحف بدون الخوض في التفاصيل!
هكذا يكون الحاكم عنده طاهر النفس، ليس خائناً ودنساً حتى يكون مؤهلاً لقيادة البشرية، ولا ندري كيف نوفر للسيد شريعتي وأمثاله هذا النوع من “السوبر مان” الذي يحكم ولا يخطئ، إنها أحلام شيعية مريضة.
أما المجتمع الذي نزل فيه القرآن فيصفه كالتالي:
“في مجتمع بدائي قبلي لا الكتاب ولا القلم ولا التعليم ولا التربية من الأمور المطروحة فيه”.
وهذه من التعميمات السخيفة، فالعرب زمن الدعوة لم يكونوا كلهم بدواً رُحَّلاً، فمجتمع المدينة كان مجتمعاً تجارياً، ومجتمع المدينة زراعياً، والشعر منتشر، واللغة العربية الفصيحة راسخة الأقدام، وكل ما ينقص العرب عدم وجود كيان سياسي بأقدام راسخة، بهذا التهافت يربط السيد شريعتي أحلام التشيع بالشيوعية تحت ستار محاربة الفقر والتعلق بأهداب الرجل المعصوم الذي يحكم ولا يخطئ في محاولات دفينة لتجريح التاريخ الإسلامي.
هذه التلاطمات اللا متجانسة تبرز عند السيد شريعتي أفكاراً وجودية كانت الهدف الأعلى لكل الحركات الباطنية والشعوبية في التاريخ؛ أي فكرة “وحدة الوجود”، والتخلي عن فكرة الخالق والمخلوق والتي هي عماد الدين الإسلامي، وضمن هذه الخلطة العجيبة بين مفاهيم الإسلام والتشيع والاشتراكية العجيبة نراه يحشر هذه الأفكار حشراً في السياق؛ لأنها أصلاً إحدى المقومات الدخيلة على الإسلام والتي أتت بها الحركات الباطنية، فاستخدام كلمة الإله أكثر من استخدام كلمة الله في سياق الكتاب؛ فيقول: “فليس للتوحيد نظرة ميتافيزيقية مثالية فحسب.. إن الله في الوجود واحد ليس أكثر.. إن التوحيد بيننا رؤية كونية.. رؤية تاريخية اجتماعية وبشرية.. وهو البنية التحتية لوحدة الوجود والوحدة العرقية والطبقية”.
إن فكرة وحدة الوجود تخالف كل الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، وهي نسف لفكرة الخالق المطلقة، وهي من الأفكار الدخيلة التي صنعها الحلاج ومن سار على نهجه في محاولاته لنشر الفكر الإسماعيلي – القرمطي تحت غطاء التصوف الباطني، وهي مسألة لها جذور عميقة في محاولات تخريب الفكر الإسلامي، فهل كان السيد شريعتي إسماعيلياً قرمطياً، أم اثني عشرياً بثوب جديد؟ هذا ما لا تجيبنا عنه الأدبيات الشيعية المعاصرة حتى الآن.