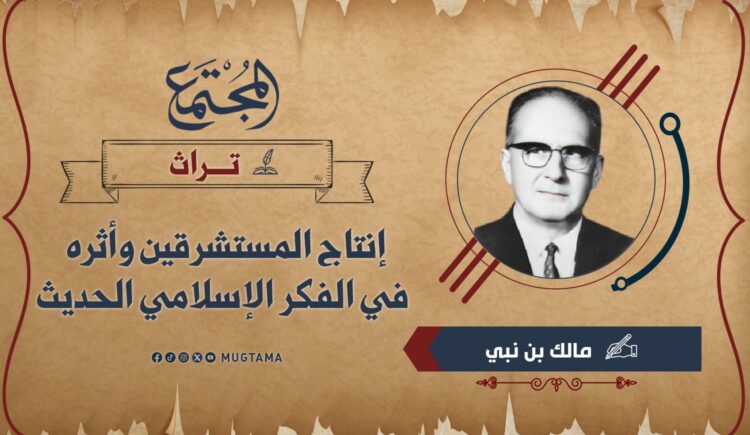يجب أولاً أن يحدد المصطلح: إننا نعني بالمستشرقين الكُتَّاب الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية.
ثم علينا أن نصنف أسماءهم في شبه ما يسمى «طبقات» على صنفين:
أ- من حيث الزمن، طبقة القدماء، مثل جرير دوريياك Gerbert d, Aurillac والقديس طوماس الأوكويني وطبقة المحدثين مثل كاره دوفر Carrade Vaux، وجلد زهر Goldizer.
ب- من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين لكتابتهم، فهناك طبقة المادحين للحضارة الإسلامية وطبقة المنتقدين عليها المشوهين لسمعتها.
هكذا وعلى هذا الترتيب يجب أن تقوم كل دراسة شاملة لموضوع الاستشراق، إلا أننا من الوجهة الاجتماعية الخاصة التي تهمنا في هذا البحث وفي النطاق الضيق المحدد لهذه السطور، نختار عن قصد فصلاً خاصًا، اختيارًا تبرره مبررات إلغائنا للفصول الأخرى. إنه لمن الواضح أن المستشرقين القدماء أثروا وربما لا يزالون يؤثرون على مجرى الأفكار في العالم الغربي، دون أيما تأثير على أفكارنا، نحن معشر المسلمين، إن ما كتبوا كان قطعًا المحور الذي تحركت حوله الأفكار التي نشأت عنها حركة النهضة في أوروبا، بينما لا نرى لهم أي أثر فيما نسميه النهضة الإسلامية اليوم.
فلنترك إذن قضيتهم جانبًا لمن تهمه دراسة التاريخ العام، كما نترك أيضًا قضية المنتقدين على الحضارة الإسلامية المحدثين حتى ولو كان لهم بعض الأثر في تحريك أقلامنا أو كان لهم بعض الصيت في زمنهم وفي بلادهم مثل الأب لامانس، إنهم لا يدخلون في موضوع بحثنا لأن إنتاجهم، على فرض أنه مس ثقافتنا إلى حد ما، إلا أنه لم يحرك ولم يوجه بصورة شاملة مجموعة أفكارنا، لما كان في نفوسنا من استعداد لمواجهة أثره تلقائيًا، مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع الفطرية عن الكيان الثقافي، كما وقع ذلك في العهد الذي نشر فيه كتاب “في الشعر الجاهلي” على غرار ما تقتضيه مسلمة قدمها المستشرق مرجليوت قبل سنة، فأثار كتاب طه حسين تلك الزوبعة من السخط التي تخللتها الصواعق الانتقامية المنطلقة من قلم مصطفى صادق الرافعي رحمه الله وأكرم مثواه.
ولكننا على عكس ذلك نجد للمستشرقين المادحين الأثر الملموس الذي يمكننا تصوره بقدر ما ندرك أنه لم يجد في نفوسنا أي استعداد لرد الفعل، حيث لم يكن هناك، في بادئ الأمر، مبرر للدفاع الذي فقد جدواه وكأنما أصبح جهازه معطلاً لهذا السبب.
وموضوعنا هنا هو أن نبين ما كان لهذه الثغرة في جهازنا للدفاع عن الكيان الثقافي من أثر في تطور أفكار المجتمع الإسلامي منذ قرن، وأثناء هذا القرن العشرين على وجه الخصوص.
لا شك أن المستشرقين المادحين مثل رينو Renaud الذي ترجم جغرافية أبي الفداء في أواسط القرن الماضي، ومثل دوزي DOZY الذي بعث قلمه قرون الأنوار العربية في أسبانيا ومثل سيدييو Sedillo الذي جاهد جهاد الأبطال طول حياته من أجل أن يحقق للفلكي والمهندس العربي أبي الوفاء لقب المكتشف لما يسمى في علم الهيئة “القاعدة الثانية لحركة القمر” ومثل آسين بلاثيوس الذي كشف عن المصادر العربية للكوميدية الإلهية، لا شك أن هؤلاء العلماء كتبوا لنصرة الحقيقة العلمية، وللتاريخ وكل ذلك من أجل مجتمعهم الغربي.
ولكننا نجد أن أفكارهم كان لها واقع أكبر في المجتمع الإسلامي، في طبقاته المثقفة.
إن الجيل المسلم الذي أنتسب أنا إليه يدين إلى هؤلاء المستشرقين الغربيين بالوسيلة التي كانت بين يديه لمواجهة مركب النقص الذي اعترى الضمير الإسلامي أمام ظاهرة الحضارة الغربية.
ولكننا إذا تصفحنا هذه القضية في ضوء خبرتنا الحديثة وفي ضوء تجاربنا القريبة لم يكن لهذه الوسيلة إلا الأثر المحمود في تطور أفكارنا وثقافتنا، بل كان لها أثر مرض هو الذي تريد طرحه كموضوع للبحث في هذه السطور.
فلكي نتصور هذا الأثر على صورته الحقيقية في مجتمعنا الإسلامي، يجب أن تعيد هذا النوع من الاستشراق إلى مصادره التاريخية.
إن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين من تاريخها، فكانت في مرحلة القرون الوسطى قبل وبعد طوماس الإكويني، تريد اكتشاف هذا الفكر وترجمته من أجل إثراء ثقافتها بالطريقة التي أتاحت لها فعلاً تلك الخطوات الموفقة التي هدتها إلى حركة النهضة منذ أواخر القرن الخامس عشر.
وفي المرحلة العصرية والاستعمارية فإنها تكتشف الفكر الإسلامي مرة أخرى لا من أجل تعديل ثقافي بل من أجل تعديل سياسي، لوضع خططها الاستعمارية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية من ناحية، ولتسيير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه هذه السياسات في البلاد الإسلامية لتسيطر على الشعوب الخاضعة فيها لسلطانها، وربما انطبقت هذه المجهودات العلمية، في نفس أصحابها على مجرد الاعتراف بفضل تلك الشعوب وبمساهمتها في تكوين الرصيد الحضاري الإنساني، ولا شك أن المستشرق سيدييو والعلامة جوستاف لوبون يتسمان في إنتاجهما بميزة العلم الخالص والاجتهاد المخلص للحقيقة العلمية.
ولكن تجب هنا الملاحظة بأن هذا اللقاء الجديد وقع في ملابسات تاريخية لم يكن فيها العلم الإسلامي علمًا حيًا ينقل من أفواه الأساتذة مباشرة ومن كتبهم المعاصرة، بل أصبح أشبه شيء بعلم الآثار يكتشفه الباحثون الأوروبيون بحكم الصدفة ويصدقون أو لا يصدقون في نقله، ثم ينسبونه لأصحابه من العلماء المسلمين، أو ينسبونه لأنفسهم أو لأحد الأوروبيين، فهكذا كانت اكتشافات كبرى تنسب لغير أصحابها، مثل دورة الدم الصغرى للإنجليزي فليام هرفي، بينما كان صاحبها الطبيب المسلم ابن النفيس الذي عاش قبله بأربعة قرون.
كما تجب الملاحظة أيضًا أن العالم الإسلامي أصبح في هذه الملابسات يعاني الصدمة التي أصابته بها الثقافة الغربية، ويعاني بسببها على وجه الخصوص أثرين: مواجهة مركب نقص محسوس من ناحية، ومحاولة التغلب عليه من ناحية أخرى حتى بالوسائل التافهة.
لقد أحدثت هذه الصدمة، عند قبيل من المثقفين المسلمين شبه شلل في جهاز حصانتهم الثقافية، حتى أدى بهم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين أمام الزحف الثقافي الغربي، وألقوا أسلحتهم في الميدان، وكأنهم فلول جيش منهزم في اللحظة التي بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين المجتمع الإسلامي والغرب، فأصبح هذا القبيل من المثقفين يبحث عن نجاته في التزيي بالزي الغربي، وينتحل في أذواقه وسلوكه كل ما يتسم بالطابع الغربي حتى ولو كان هذا الطابع مظهرًا لا شيء وراءه من القيم الحضارية الغربية الحقيقية.
وبدأت تظهر في الأفق الثقافي الإسلامي الفكرة الجديدة التي حركت بعد ثورة سنة ١٨٥٨م بالهند، تأسيس جامعة عليكرة وحركت من جانب آخر ضد هذا المشروع، باعث النهضة الإسلامية السيد جمال الدين الأفغاني.
وهكذا أصبح الفكر الإسلامي، على أثر الصدمة الثقافية التي اجتاحته وما تسبب عنها من مركب نقص، ينحاز إلى معسكرين، أحدهما يدعو لتقبل الفنون والعلوم والأشياء الغربية – حتى اللباس – والآخر يحاول التغلب على مركب النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلل بها النفس.
فالتيار الأول كان من الناحية العقلية والسياسية والاجتماعية له أثره في لونين، اللون الذي يتمثل في تأسيس جامعة عليكرة، واللون الذي يتمثل في دعوة جمال الدين الأفغاني مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل التي كانت تفرض على العالم الإسلامي في كلتا الحالتين تطورًا يؤدي به إلى الشيئية والتكديس.
وأما التيار الثاني وهو موضوع حديثنا لاتصاله بإنتاج المستشرقين فإنه وجد مخدره الطبيعي في أدب الفخر والتمجيد الذي أنشأه علماء مستشرقون أمثال دوزي عن الحضارة الإسلامية.
ولا يمكننا، على أية حال أن نجعل بين التيارين فاصلاً قاطعًا، لأن الثاني منهما لا يكون بصورة منهجية مدرسة مستقلة عن الأول، بل نجده يخامر الفكر الإسلامي على العموم ويتخلل اتجاهه العام كفكر يبحث عن حقنة اعتزاز للتغلب على المهانة التي أصابته من الثقافة الغربية المنتصرة، كما يبحث المدمن عن حقنة المخدر التي يستطيع بها مؤقتًا إشباع حاجته المرضية.
وهذا لا يجعلنا ننفي لهذا التيار ولنوع الأدب الذي نتج عنه كل أثر حسن في مصير المجتمع الإسلامي، لأنه كان له نصيب لا يزهد فيه في الحفاظ على شخصيته، والجيل الذي أنا منه يدين له بذلك النصيب على الأقل في المحافظة على شخصيته الإسلامية.
إنني على سبيل المثال قد اكتشفت وأنا بين الخامسة عشرة والعشرين من العمر أمجاد الحضارة الإسلامية في ترجمة دوسلان لمقدمة ابن خلدون وفيما كتب دوزي وأحمد رضا بعد الحرب العالمية الأولى.
وإني لعلى إدراك تام لما أدين به لهذه المطالعات، وقد ذكرت ذلك في الجزء الأول. من “مذكرات شاهد القرن” والآن وقد تجاوزت الستين من العمر أستطيع أكثر من ذي قبل تقدير هذا العلاج للفكر وللضمير، لا في النطاق الشخصي، بل في النطاق الشامل للمجتمع الإسلامي طيلة أربعين سنة بعد تجربتي، فأرى أن أقرر هنا مع الاختصار اللازم في هذا العرض أن مساوئ طريقة هذا العلاج تظهر لي بالتالي أكثر من حسناته وذلك لأسباب متعددة.
فالسبب الأول لأنه بديهي، ولأن ملاحظة الآثار النفسية لأسلوب التكوين، أي البيداغوجية، تبرز تلقائيًا بالنحو الذي نشير إليه بمثل بسيط.
إننا عندما نتحدث إلى فقير، لا يجد ما يسد به الرمق اليوم، عن الثروة الطائلة التي كانت لآبائه وأجداده، إنما تأتيه بنصيب من التسلية عن متاعبه بوسيلة مخدر يعزل إلى حين فكره مؤقتًا وضميره عن الشعور بها، إننا نسكن الآلام، لا نشفيها.
فكذا لا نشفي أمراض مجتمع بذكر أمجاد ماضيه، ولا شك أن أولئك الماهرين في فن القصص قد قصوا للأجيال المسلمة في عهد ما بعد الموحدين قصة ألف ليلة وليلة، وتركوا بذلك (إثر كل سمر) نشوة تخامر مستمعيهم حتى يناموا على صورة ساحرة لماض مترف.
ولكن سوف تستيقظ هذه الجماهير في الغد، فتنفتح أبصارها من جديد على مشهد الواقع القاسي الذي يحيط بها في وضعها الذي لا تغبط عليه اليوم.
فالأدب الذي ينشد عصور الأنوار للحضارة الإسلامية يؤدي أولاً هذين الدورين، إنه أتاح في مرحلة معينة الجواب اللائق للتحدي الثقافي الغربي الذي حفظ مع عوامل أخرى الشخصية الإسلامية، ولكنه من ناحية أخرى، نراه قد صب في هذه الشخصية الإعجاب بالشيء الغريب ولم يطبعها بما يطابق عصر الفعالية.
ربما تبدو هذه الملاحظة عارضة في هذا العرض، إلا أنها في نظرنا جديرة، على بساطتها، بكل الاهتمام، وذلك ليس لأنها تهمنا من جهة نظر الاجتماع فحسب، بل لأنها تهمنا أكثر إذا اعتبرنا مدلولها بالنسبة إلى مجال الصراع الفكري الذي تورط فيه العالم الإسلامي اليوم، في مرحلته الراهنة.
وإذا أردنا، بما يمكن من الإيجاز، التعريف بما نسميه “الصراع الفكري” في العالم الإسلامي فإنه يجب على الأقل أن نضع نصب أعيننا هذه القاعدة العامة: فكلما طرح المسلم أو المسلمون مشكلة ما تتصل بمصير هذا المجتمع، يجب علينا القطع بأن الاستعمار قد طرحها أو سيطرحها على الفور، وأنها لا تخفى على المختصين بالدراسات الإسلامية، فهم تناولوها قطعًا بالبحث أو سيتناولونها، وأنهم سيبذلون كل جهدهم، إذا ما وفق المسلمون إلى حل من الحلول لهذه المشكلة، في تزييف هذا الحل إن كان صحيحًا، أو في توسيع الرتق فيه إن كان مخطئًا.. هذا أبسط تعريف للصراع الفكري.
وعليه، فإذا بدرت في العالم الإسلامي بادرة، حتى ولو كانت خافية على أبصارنا نحن، فسرعان ما تلتقطها مراصد أولئك الأخصائيين، فيضعونها تحت مجاهر التحليل، خصوصًا إذا كانت تلك البادرة ذات صلة قريبة أو بعيدة بحركة الأفكار في العالم الإسلامي، وبنهضته، أفنجري عملية الفحص والتحليل إلى أقصى حدها، وتمر النتيجة بمائة عملية تقطير وتصفية، حتى يبقى في المبادرة عندما تبرز بعد هذه العمليات، أقل ما يمكن من الصواب وأكثر ما يمكن من الخطأ، يعني من الناحية العملية أقل ما يمكن من العوامل الميسرة للتطبيق وأكثر ما يمكن لجعله متعسرًا أو مستحيلاً.
ومن الواضح أن أول صورة تبرز فيها مبادرة هي صورة فكرية تشتمل على أفكار توجيهية من حيث مبررات العمل وكيفيته، فإذا تسممت المبررات بالريب والتشكيك أو فقدت الكيفية ما يجب من الوضوح، صعب العمل أو استحال.
إذن قضية الأفكار التوجيهية قضية رئيسية، وقد يكون التوجيه من حيث المبررات، إما إلى الأمام وإما إلى الخلف، إذا كان ملتفتًا بصورة مرضية إلى الوراء.
_____________________
المصدر: مجلة «الوعي الإسلامي»، عام 1969م.