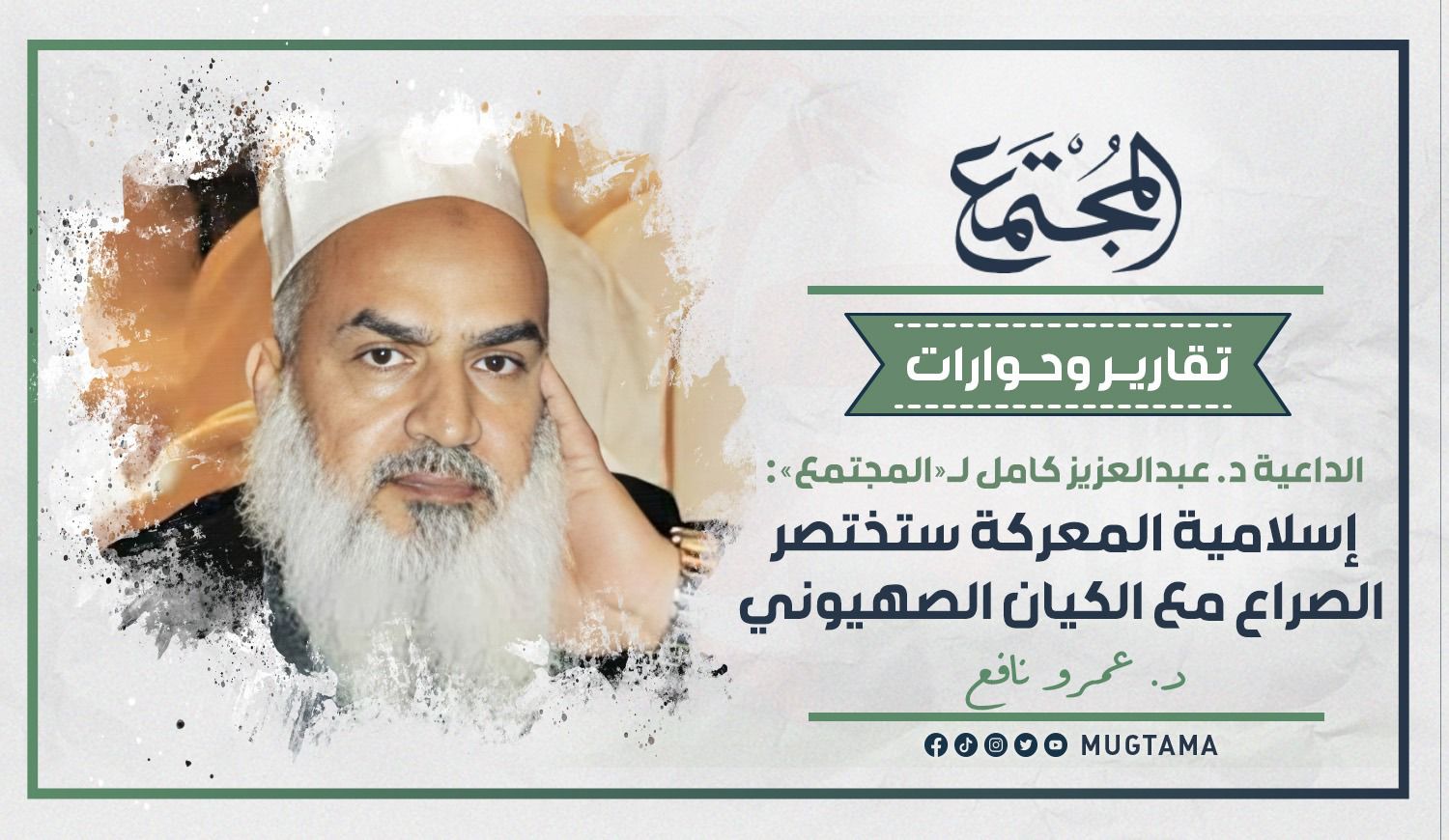د. عبدالعزيز كامل، داعية وكاتب إسلامي مصري، ومحاضر سابق بجامعة الملك سعود، له مؤلفات حول القضية الفلسطينية وعلاقتها بالعلمانية المصرية والعربية، منها «قبل أن يهدم الأقصى»، و«العلمانيون وفلسطين.. ستون عاماً من الفشل».
«المجتمع» تطرح عليه، في هذا الحوار، العديد من التساؤلات حول الصراع مع اليهود، ودلالات حرب غزة، وطبيعة موازين القوى.. وغيرها من المواضيع.
العدو «الإسرائيلي» يعاني من فجيعة وجرح غائر بفضل المقاومة
بعد حالة الجدل التي أعقبت الدمار الشامل لغزة والتطهير العرقي لأهلها، كيف يمكن أن نقيس حسابات الربح والخسارة بميزان المقاومة؟
– معركة «طوفان الأقصى» مثلت الإجابة النموذجية عن هذا السؤال؛ فحسابات العدو لخسائره تظهر أنه يعاني من فجيعة وجرح غائر، ليس فقط لجيشه الذي تجسد ضعفه في جبن جنده أمام جسارة المستضعفين الأقوياء؛ بل كذلك في التهديد الوجودي لأصل مشروعه الذي فقد الكثير من مشروعيته المدّعاة أمام العالم، وفي تقويض نظرية «أمن إسرائيل» التي نظّر لها بن جوريون وطبقها خلفاؤه في كل حروبهم ضد العرب منذ أكثر من 70 عاماً.
وما ركائز نظرية اليهود في صراعهم مع العرب؟
– وضع بن جوريون في اعتباره قلة عدد اليهود، وسط محيط هادر معاد لهم، مع موارد محدودة في أرض فلسطين الضيقة المساحة، ولتحقيق ذلك كان لا بد من تطبيق تلك الخطة:
أولاً: كل الشعب اليهودي جنود في الجيش، ورفع لذلك شعار «الشعب المسلح يضمن أمنه».
ثانياً: يتوجب على هذا الشعب المسلح كلما حارب أن ينقل الحرب إلى أرض أعدائه.
ثالثاً: لا بد من بذل كل مستطاع لتفريق صفوف الأعداء وتمزيق وحدتهم.
رابعاً: أن تكون الحروب سريعة وقصيرة لتقليل الاستنزاف في الأرواح والعتاد والاقتصاد.
خامساً: من الضرورة الوجودية بناء علاقات تحالف حقيقية مع كل أعداء العرب، ودفعهم لتحالفات وهمية مع أصدقاء مزيفين.
والحروب السابقة ضد العرب أكدت السير على بنود تلك النظرية، حتى جاءت عملية «طوفان الأقصى» فبددت كثيراً من فاعليتها ومستقبل تطبيقها، وفي كل الأحوال فنحن نؤمن، وينبغي أن نظل نوقن بالسُّنة الإلهية القدرية القائلة: (كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة: 249).
لولا المواقف المخزية لأكثر الحكومات لرأينا اندفاعاً شعبياً لدعم غزة
ما البوصلة التي ينبغي أن نتوجه بها لتحقيق مشروع المقاومة العربية الإسلامية ومن ثم النصر؟
– ثقافياً؛ مطلوب تدعيم حالة الرفض لثقافة التطبيع الدخيلة التي أريد فرضها على شعوب العرب والمسلمين، خاصة أن قطاعات عريضة عبّرت عن أصالة وعيها فترجمته إلى حالة «المقاطعة» التي صارت روحاً عامة بين مختلف الطبقات الاجتماعية بدرجاتها العمرية، حتى بين الأطفال الذين أصبحوا يتحرون ما يشترون من سلع، ويحترزون من دعم أي اقتصاد مؤيد للمعتدين.
أما سياسياً؛ فالتعويل الأساسي برأيي على التوجه الإسلامي، لمواصلة الجهود لصنع رأي عام مناهض سياسياً لأكاذيب السلام التي اقتربت قبل المعركة أن تنسي الناس أن هناك قضية مقدسة كادت تتعرض للنسيان شعبياً، بعد أن تعرضت للتقزيم والتهوين رسمياً.
وأما اجتماعياً؛ فإن الأحداث كشفت عن أن روح المجتمعات لا تزال حية مع قضايا الأمة، وكان للمساجد دور بارز رغم حصار الدعوة، وشهدنا حالة الاستمرار بلا ملل في القنوت والدعاء في الصلوات والخطب، ولولا المواقف المخزية لأكثر الحكومات، لرأينا اندفاعاً غير مسبوق لدعم المجاهدين بكل غال وثمين.
وما جرى يثبت عظيم أثر القرآن في تثبيت العداء لـ«أشد الناس عداوة للذين آمنوا»، وهو ما يجب توظيفه لتحصين المجتمعات من الدعوات التي تذيب الفوارق العقدية الفاصلة تحت أوهام السلام، ومعظمها من قبل العلمانيين.
تمكين صهاينة اليهود يجري بدعم من صهاينة النصارى والعرب
إلى أي مدى ساهم تهميش البعد الديني بمواجهتنا للصهيونية في مد أمد الصراع لأجل غير معلوم؟
– لا شك أن تضخيم الأعداء للبعد الديني في صراعهم غير المتكافئ عددياً ولا مادياً ضد محيط غالب من العرب المسلمين؛ حشد حول العدو قوة إلى قوتهم، واختصر ذلك البعد الديني كثيراً من مراحل مشروعهم، وضبط إيقاع تنفيذها في التوسع والاختراق، وقد أثبتت معركة «طوفان الأقصى» أن «إسلامية المعركة» لو روعيت من العرب بصدق منذ بداية الصراع؛ لاختصر ذلك مراحل المعركة التي زادت عن 75 عاماً من الفشل، في ميادين الحرب أو موائد السلام، فاليهود كانوا ولا يزالون يحاربون بعقيدة، ولا شك أن من يحارب بعقيدة دينية ولو كانت باطلة؛ يكون أداؤه وعطاؤه أكثر ممن يلقن مفاهيم علمانية غير مستحقة للبذل والتضحية.
كيف يمكن الرد على اتهام المقاومة الإسلامية الفلسطينية بالإرهاب، وهي من التهم الجاهزة لدى الغرب؟
– المقاومة في المقام الأول «جهاد»، ولا شك أن هذه الكلمة تحمل من المضامين العقدية والشرعية والقيمية أضعاف أضعاف ما تحمل كلمة «المقاومة»، فكل صنف من الناس يمكن أن يكون مقاوماً في قضية إسلامية أو غير إسلامية، لكن الجهاد لا يكون ولا يقوم إلا تحت راية عقدية إسلامية، وقواعد شرعية غير مصروفة إلى غيرها، وعندما يطلق المعاندون للدين وصف «الإرهاب» على حق الدفاع عن الحقوق، فإنهم يجهلون أو يتجاهلون أن «الإرهاب» نفسه منه ما هو شرعي واجب، كما قال الله تعالى: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ) (الأنفال: 60)، فإرهاب المعتدين الغاصبين شرع ودين.
هل تؤمن في كتابك بحتمية صراع الشرق والغرب على أساس ديني، وهو ما يؤمن به أيضاً فريق من المستشرقين الأمريكيين أمثال صمويل هنتنجنتون، وبرنارد لويس؟
– هذا الصراع لم يعد مجرد حتمية تاريخية، بل أصبح حقيقة واقعية، بعد أن عادت بقوة أجواء الحرب الباردة بين معسكر غربي قائم ومستقر في تحالفاته، ومعسكر شرقي ناشئ ومستمر في تمكين مساراته؛ اقتصادياً وسياسياً وإستراتيجياً، ممثلاً حتى الآن في قوى عالمية غير هامشية، وهي الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.
ومعلوم أن كثيراً من ساسة ومفكري الغرب طالما تحدثوا عن صراعات المستقبل ضد ما أسموه «محور الشر»، ولا شك أن لذلك خلفيات دينية، تتعلق بصلب معتقدات النصارى المرتبطة بعودة مسيحهم المنتظر، ليحارب قوى الشر في الشرق، ضمن ما يعرف عندهم بمعركة «هرمجدون» الوارد ذكرها في الإنجيل، حيث يعتقدون أنها معركة بين الحق الذي يدعون تمثيله، والباطل الذي يلحقوننا زوراً به.
ومعروف أن معتقدنا الإسلامي يؤكد حتمية هذا الصراع، لا بين شرق وغرب، ولكن بين أهل حق من الموحدين، وأهل باطل من الصليبيين، وهو ما يعرف بملاحم آخر الزمان.
كيف يمكن النظر لـ«إسرائيل» بوصفها آخر جيب استيطاني غربي بالنظر لاستقوائها حالياً في غزة بترسانة الغرب؟
– ما نعتقده أن هذا الجيب الأخير تجسيد لمقدمات ما يسميه أهل الكتاب بـ«الأيام الأخيرة»، أو ما نسميه نحن علامات اليوم الآخر، أو أشراط الساعة، فالحقيقة أن قدوم ثم تمكين صهاينة اليهود بدعم ودفع من صهاينة النصارى ثم صهاينة العرب؛ قد اختصر أو سرع الكثير من تلك الأشراط والعلامات، التي منها ما أخبر عنه نبيينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله».
وأيضاً في سنن الطبراني والبزار بإسناد رواته ثقات: «لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه».
فهذه الأحاديث تخبر عن مصير هذا «الجيب الأخير» المدعوم من «المشركين» النصارى غرب نهر الأردن، حيث سيقاتلهم المسلمون القتال الأخير، وهم على جبهة شرق الأردن.