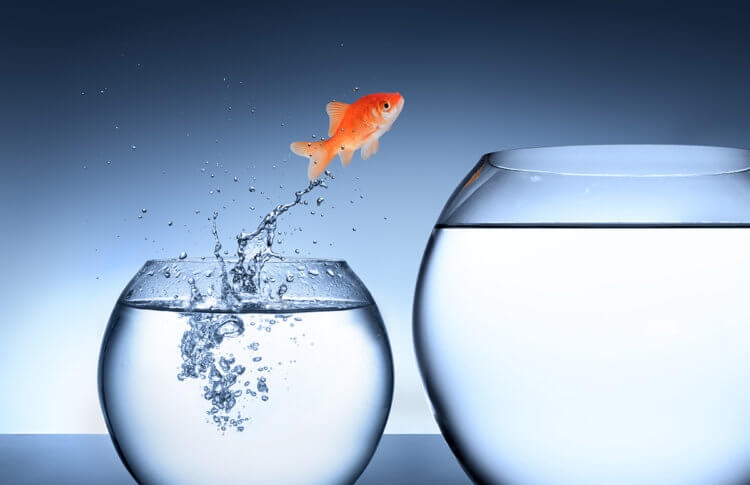يحيا كل إنسان في بيئة مشحونة بالأفكار والعقائد والتقاليد والرموز والمعلومات، ومن مجموع تلك الأمور تتكون ثقافته العامة، ومن تلك الثقافة تتولد رؤيته لأمور كثيرة، كما تتشكل لديه الصور الذهنية التي يرى من خلالها نفسه والعالم من حوله، وإن كل صورة ذهنية تبدأ بالتشكل نتيجة الخواطر التي يتكرر ورودها على الواحد منها، وكثيراً ما تأتي الأحداث اليومية لتؤكد صحة تلك الخواطر، ومن هنا فإن الواحد منا مطالب بأن يعي الصور الذهنية الخاطئة حتى يتمكن من مجابهة الخواطر التي تؤدي إلى تشكيل تلك الصور وقطع الطريق عليها.
تؤكد الكثير من البحوث التي أجريت في علم النفس المعرفي على أن تغيير الأفكار هو المدخل الصحيح لتغيير الاستجابات الشعورية والسلوكية لدى الإنسان، والحقيقة أن الصور الذهنية التي تحتاج إلى التغيير، أو نحتاج إلى التخلص منها على نحو نهائي كثيرة جداً، لكن أكثرها حيوية وتأثيراً في مسار حياتنا الشخصية هي تلك الصور التي كوّناها عن أنفسنا وذواتنا؛ إذ إنها تؤثر على نحو جوهري في أسلوب رؤيتنا للحياة وفي نوعية مبادراتنا ونوعية ردود أفعالنا.
ولعلّي أشير هنا إلى بعض تلك الصور والمفاهيم في الآتي:
1- مشاعر الإحباط وعدم الأهلية:
كثيرون أولئك الذين تسيطر عليهم مشاعر الإحباط، ومشاعر عدم الأهلية للقيام بالأعمال التي يقوم بها نظراؤهم من الناس ولذا فإنهم بالتالي يشعرون أنهم لا يستحقون النجاح والتفوق، وينعكس هذا الشعور بالضآلة على نفسياتهم وسلوكياتهم، حيث إنك تجد الواحد منهم فاقداً للحيوية، فهو يؤدي أعماله بتثاقل وتباطؤ ومن غير أي حماس أو اندفاع، وإذا بدأ بإنجاز عمل أو مشروع فإنه قلَّما ينهيه، وإذا أنهاه لم ينجزه على الوجه المطلوب، وحين يفكر الواحد منهم، فإن تفكيره يفقد المسحة الإبداعية، ويتسم بالرتابة والتكرار إذ لا حافز يدعو إلى التجديد، وهذا الصنف من الناس كثيراً ما يحدثك عن العقبات التي تعترض سبيله، وكثيراً ما يزعم أنها عقبات طارئة وغير متوقعة.
وأخيراً فإن الذين يفقدون الشعور بالأهلية للقيام بالأعمال الجيدة يحملون في نفوسهم الكثير من مشاعر اللوم للآخرين والعتب عليهم؛ لأنهم في توهمهم يخذلونهم ويحجبون عنهم العون الذي كان ينبغي أن يقدموه إليهم، وهذا يؤدي إلى عزلتهم، وابتعاد الناس عنهم مما يضاعف في مشكلاتهم، ويشعرهم بالاغتراب.
أنا لا أشك أن مواهب الناس وإمكانياتهم وظروفهم متفاوتة، لكن أعتقد مع هذا أن هناك دائماً أكثر من طريقة ووسيلة لإدخال تحسينات على كل ذلك، لكن السلبية التي ورثها الكثيرون منا من بيئاتهم تمنعهم من رؤية الآفاق الممتدة التي أمامهم، وأظن أن تخفيض الطموحات سوف يقرب المسافة بين الأهداف وبين الإمكانيات المتوافرة، مما يحفز الإنسان على العمل والدأب، كما أن توضيح ما يريده الإنسان على نحو جيد يساعد هو الآخر على إزالة الأوهام التي تعشش في أذهان الناس، وتصبح مصدراً لتوليد الإحساس بصعوبات غير موجودة، ومن المؤسف في هذا السياق أن معظمنا يفكرون غالباً في الأشياء التي لا يريدونها، مما يجعلهم يشعرون بالمشكلات أكثر من شعورهم بالنتائج الجيدة.
أخيراً فإن العزيمة على إنجاز أشياء محددة في زمان محدد، تجعل المرء يضع قدمه على بداية طريق النجاح، وبمجرد أن يشعر بأنه بدأ يتقدم تتولد لديه طاقات جديدة، تساعده على المضي نحو الأمام باطمئنان وثبات.
2- الكفاءة الشخصية والإنجاز العالي:
بعض الناس يحملون صوراً ذهنية مبالغاً فيها حول الكفاءة الشخصية والإنجاز العالي، ويعتقدون أن الإنسان إذا لم يحقق نجاحات كبرى، فإنه لن تكون له قيمة بين الناس، وهذا غير صحيح، فالمرء لا يحترم لإنجازاته فحسب بل إن هناك الكثير من السمات التي ترفع من قدر الواحد منا في عيون إخوانه أكثر مما يرفع النجاح، وذلك مثل: الطيبة والتعفف وحب الخير للناس وبذل المعروف والاستقامة على أمر الله – تعالى – وما شابه ذلك.
3- سير الرياح بما لا نشتهي:
يغلب على كثير من الناس مفهوم يقضي بأن تسير الأمور على ما يشتهون ويرغبون، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحياة تصبح شيئاً لا يطاق، وهذا وهم كبير، فنحن لا نملك زمام الأحداث، ولسنا نحن الذين نحرك الأشياء، ولذا فإن علينا أن نتوقع دائماً أن يحدث ما ليس في الحسبان.
ومن وجه آخر فمن الذي يزعم أن عدم حدوث ما نرغب فيه يشكل كارثة أو انتكاسة؟
إن الله – جل وعلا – وحده هو الذي يعلم خواتيم الأمور وعواقب الأحداث والأوضاع، ولذا فإننا طالما خشينا من وقوع الكثير من الأحداث، لكن بعد أن تقع نلمس فيها من لطف الله – تعالى – ورحمته وخيره، ونرتاح لذلك ونسرّ به، وإذا تأملت حياة الناس وجدت أعداداً لا تحصى منهم استاؤوا مثلاً عند فصلهم من وظائفهم، وعدٌّوا ذلك مصيبة كبرى، لكن بعد أن انطلقوا في الأعمال الحرة عدوا وقت فصلهم بداية رائعة لمرحلة مثمرة وعظيمة.
يقول الله – جل وعلا – معلماً لنا هذه الحقيقة الناصعة: {وَعَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيرٌ لَكُم وَعَسَى أَن تُحِبٌّوا شَيئاً وَهُوَ شَرُّ لَكُم وَاللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمُونَ} (البقرة: 216).
ثم إن الله – تعالى – أعطانا قدرة هائلة على التكيف مع الأمور الصعبة، وحين يقع ما لا نحبه أو نتوقعه، فإننا إذا استطعنا امتصاص الصدمة الأولى، سنجد أنفسنا متوافقين مع الأشياء الجديدة، وسنجد إذا استخدمنا البصيرة أنها لا تخلو من إيجابيات وحسنات.
4- المبالغة في البحث عن الحل المثالي:
الحضارة الحديثة مكّنت الإنسان من السيطرة على الكثير الكثير من مظاهر الطبيعة، ورسخت في عقله ومشاعره أن هناك دائماً العديد من الخيارات، كما أن من حقه أن يتطلع إلى ما هو أكثر وأمتع وأرفه وأجود… وهذا كله جعلنا كلما واجهنا مشكلة طلبنا لها حلاً مثالياً كاملاً، وإذا لم نجد ذلك الحل، فإننا نشعر بالكثير من الأسى والفجيعة!
لا ريب أن التطلع إلى ما هو أحسن وأكثر، شيء ليس خاطئاً من حيث المبدأ لكن يجب علينا أن ندرك أن ذلك لا يخلو في كثير من الأحيان من المثالية والمبالغة، ولذا فإن الإصرار على الحصول على الأفضل دائماً يجب أن يصحب بالاعتقاد أن لله – تعالى – الكلمة العليا والنهائية في هذا الوجود، وأنه لن يحدث إلا ما أراده وقدَّره، وهذا الذي أراده قد يوافق رغباتنا، وقد لا يوافقها، ثم إن الوصول إلى أي حل عاجل أو آجل لمشكلة صغيرة أو كبيرة، لا يمكن إلا أن يظل خاضعاً للبيئة والمعطيات السائدة، وبما أن شروط حياتنا الشخصية وشروط الحياة العامة تظل دائماً دون طموحاتنا وتطلعاتنا، فإننا سنظل نشعر أن الوسط الذي نعيش فيه هو أقل مما نريد، وأقل مما ينبغي أن يكون وهذا يعني أننا لن نصل أبداً إلى حلول كاملة ومثالية لأن الحل الكامل يتطلب وسطاً كاملاً، ولذا فإن علينا دائماً أن نتوقع حلولاً منقوصة ونتائج محدودة، والناس الذين لا يعرفون هذا المعنى سيظلون يشعرون بالخيبة والسخط!
5- الاضطلاع بالمسؤوليات الجسام:
لو تساءلنا لماذا يعيش أشخاص في مركز الضوء وفي لُجَّة الأحداث، على حين يظل آخرون على هامش الحياة أخذاً وعطاءً وتأثراً وتأثيراً، لوجدنا أن لذلك العديد من الأسباب، لكن قد يكون من أهمها أن كثيرين منا يختارون تجنب المشكلات والتحديات، والابتعاد عن دائرة الضوء قدر الإمكان، ولهم في ذلك فلسفتهم الخاصة، وأعتقد أن هذا المفهوم يحتاج إلى تغيير، حيث إن مواجهة الصعوبات والقيام بالمهمات والمسؤوليات، كثيراً ما يكون السبيل الوحيد لتنمية الشخصية وبلورة الإمكانيات والقدرات، وفتح مجالات جديدة للعطاء والنفع العام.
تصور معي ماذا كان يحدث لو أن رجلاً مثل أبي بكر أو عمر – رضي الله عنهما – رفض إمرة المؤمنين، ولو أن رجلاً مثل خالد بن الوليد رفض قيادة جيوش المسلمين، ولو أن رجلاً مثل الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة اشتغل بالزراعة، ولم يدخل المجال العلمي؟ إن المتوقع آنذاك أن يكون كل واحد من هؤلاء العظماء في وضعية أقل أهمية وأقل ملاءمة للعطاء الكبير الذي قدموه.
إن التاريخ يُصنع من وراء التصدي للمهمات الجليلة، ومن وراء التغييرات الكبيرة التي نُدخلها على حياتنا الشخصية من أجل الاضطلاع بالأعمال العظيمة. لا ريب أن البعد عن تحمٌّل المسؤوليات والإعراض عما يسبب الصعوبات، يجلب لنا الكثير من الراحة والهدوء، ويجعلنا أقل احتياجاً لاستنفار الإمكانات وتحرير الطاقات، كما أنه لا يتطلب منا كثيراً من التعديل في برامجنا الخاصة.. لكن علينا أن نتذكر أن البعد عن مركز النشاط الحضاري والرضا بالعيش الهادئ الهانئ، كثيراً ما يتسبب في الضمور والترهل، وفقدان البيئة التي تمكِّن الإنسان من النمو والعطاء، وعلينا ألا ننسى أيضاً أن تواري الصالحين والأكفاء عن محاور الحركة في الحياة، يتيح للآخرين التقدم إليها وملء الفراغ الذي تركه الأخيار بالأمور السيئة والضارة.
6- تعليق الفشل على الغير:
لو سألنا الناس الذين لم يحققوا إنجازات جيدة عن الأسباب التي حالت دون ذلك، لوجدنا أن السواد الأعظم منهم يُحيل ذلك إلى عوامل وأسباب خارجية لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها، وتلك الأسباب قد تكون مادية أو اجتماعية أو أسرية… وقليلون جداً أولئك الذين يقولون: إنهم لم يحققوا تقدماً أو تفوقاً على أقرانهم بسبب عدم امتلاكهم الاهتمام أو التنظيم الذاتي أو العادات الجيدة أو الآفاق الرحبة… وهذا يعود على ما يبدو إلى أن إدراك العوامل الحسية أسهل من إدراك العوامل المعنوية، ثم إن لدينا ميلاً غريزياً إلى جعل أسباب قصورنا أو إخفاقنا تتعلق بالآخرين، أو بأشياء خارجة عن سيطرتنا أو مسؤوليتنا، وهذه الفكرة تحتاج إلى تعديل، فنحن مع أننا لا نتجاهل تأثير العوامل البيئية والظرفية إلا أنا نعتقد أن المشكلة الأساسية تكمُن في عقولنا ونفوسنا وسلوكاتنا، وحين يحدث تحسن جيد على هذه الأصعدة، فإن تأثير العوامل الخارجية يتضاءل، بل إن الظروف المعاكسة تتحول من معوقات للتقدم إلى محفزات ومحرضات عليه، وكثيرون أولئك الذين صنعت منهم الأوضاع الصعبة رجالاً عصاميين من الطراز الرفيع.
7- الوقوع في أسر الماضي:
نحن على نحو ما جزء من الماضي، وكثير مما نحمله من أفكار ومشاعر وعادات موروثة من أزمنة الطفولة والمراهقة والشباب، ونحن نتمسك بذلك الموروث لأننا نرى فيه استمرارية وجودنا ورسوخ ذواتنا، وهذا يجعلنا نعتقد أن الماضي بكل أحداثه ومؤثراته ومعطياته هو الذي يصوغ سلوكنا في الحاضر، وربما في المستقبل، والحقيقة أن معظم الناس يخضعون لتأثير أحداث الماضي وما أبقته في النفوس من مشاعر وصور وانطباعات، وربما تعاملوا معها على أنها نوع من الخبرة العزيزة التي يجب الاستفادة منها والسير على هديها.
ويمكن القول: إنه كلما امتدت المساحات التي أفلتت من قبضة الوعي، فصار التعامل معها عن طريق (اللاشعور)، وجدنا أنفسنا في أَسر المشاعر والأفكار القديمة، المشكلة تتمثل في أن تلك المشاعر والانطباعات كثيراً ما تكون غير صحيحة، أو غير ناضجة، أو تكون قد تكونت في ظروف مغايرة كثيراً لما نحن فيه اليوم، وتؤدي الأمثال والمقولات الشعبية المأثورة عن السابقين دوراً سيئاً في هذا المقام لأن كثيراً منها كان عبارة عن إطلاقات بَدَهية لا تستند إلى خبرة عريقة، ولم تتعرض لأي دراسة أو تمحيص جيد.
إن انطباعي عن زيد من الناس بأنه مهمل أو حقود أو كذاب أو سريع الغضب، قد يكون تولد من موقف واحد معه أو نتيجة إخبار بعض الناس لي، ويكون ذلك الموقف استثنائياً، لا يمثل وضعيته العامة، أو يكون الذي أخبرني غير صادق أو غير دقيق فيما يقول، وقد يكون الرجل أقلع عما كان عليه، وحسن حاله، وحينئذ فإن انطباعاتي وأحاسيسي عنه قد تكون متخلفة وظالمة!
بعض الأفكار الموروثة نشأ بسبب وجود الأمية، أو بسبب أسلوب متصلب في التربية، أو بسبب عرف اجتماعي غير صحيح.. وعلى سبيل المثال فإن قول العامة: “أكبر منك بشهر أعرف منك بدهر” نشأ نتيجة انتشار الأمية، حيث يكون لكبر السن أثر كبير في حصيلة الإنسان العلمية، أما اليوم فإن العلم الغزير ليس مرتبطاً بالأعمار على نحو مطرد… إلخ.
نحن في حاجة ماسة إلى غربلة ما ورثناه من مفاهيم ومقولات ومشاعر وانطباعات عن طريق النقد الدقيق والتأمل العميق والتحاكم إلى الخبرات الجديدة، وأعتقد أننا إذا فعلنا ذلك فإننا سنكتشف زيف الكثير من ذلك، كما أننا سنكتشف أن خضوعنا له قد غمرنا بالكثير من الأوهام!
إن جوهر التقدم العقلي يرتكز إلى حدٍّ, بعيد على مدى قدرتنا على امتحان الأفكار والمفاهيم والمشاعر الموروثة، والتأكد من الوضعية المناسبة لها في منظوماتنا الثقافية والقيمية الجديدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
المصدر: “إسلام ويب”.