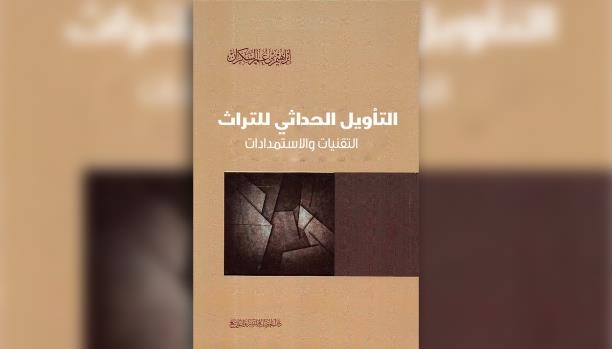ثمة مفارقة لافتة إزاء رموز التيار العريض من المثقفين العرب الذين حملوا على عواتقهم عبء إعادة قراءة التراث ونقده، باعتبارهم لم يكونوا في الأصل ممّن صرفوا أعمارهم في تحقيقه ودراسته، فلم تكن منطلقاتهم التأويلية، عادة، نابعةً من معاناة من عايش التراث، واختبر حلوه ومرّه! في المقابل، لم يكن المنكبّون على هذا التراث تحقيقاً لمخطوطاته ودراسة لنصوصه، كإحسان عباس مثلاً، معنيين أصلاً بطرح منظورات تأويلية للتراث مثلما يفعل من هم خارج دائرة هذه المعاناة!
الأطروحات الحداثية حول التراث وجَدَتْ صدىً كبيراً لدى الشباب على امتداد العالم الإسلامي، وأصبح لها مريدوها من المثقفين الناشئين، بل تحوّل الأمر إلى مدارس فكرية في بعض الأحيان. وانطلاقاً من هذا الصدى الكبير، والرواج البالغ، قدّم الكاتب السعودي إبراهيم السكران كتابه “التأويل الحداثي للتراث: التقنيات والاستمدادات“.
لم يحاول السكران أن يقيّم عمليات التأويل التي مارسها هؤلاء التنويريون، فللتقييم موضع آخر، وإنما اكتفى بالوقوف على مصادرهم التي استمدّوا منها أفكارهم، والتقنيات التي استخدموها في بثها. ولا ينفي الكاتب أحياناً أن تلك الأفكار فيها ما يستحق الوقوف أمامها بتأنٍ ومراجعة.
الشباب والتراث
تواضع الحداثيون على تسمية برامجهم (مشروعات إعادة قراءة التراث)، فزاد الطلب على مؤلفات محمد عابد الجابري ومحمد أركون وحسن حنفي وفهمي جدعان وغيرهم. يتنبّه المؤلف إلى أن الشباب المثقف الذين جذبتهم تلك البرامج من أجل إعادة قراءة التراث الإسلامي لم يستمروا في طريقهم الذي رسمه لهم رموزهم، فبدلاً من الغوص في أعماق تراثهم العربي والإسلامي، انطلقوا لكي ينهلوا من التراث الفلسفي الغربي.
السبب في ذلك أن مؤلفات الحداثيين تضخ تضخيماً هائلاً لمنزلة الفلسفة، ولا يتوافر في المكتبة العربية سوى مترجمات عن الفلاسفة الغربيين منذ القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر. ووفقاً لتعبير السكران، فإن برامج الحداثيين تلك كانت مركباً نقلت مريديها من القراءة في الموروث الإسلامي إلى القراءة في الموروث الغربي! وهي نتيجة لم يقصد إليها الحداثيون أنفسهم!
التوفيد والتسييس
البرامج الحداثية استمدت تحليلاتها ومادتها الأساسية من أعمال المستشرقين، خاصة الأعمال الاستشراقية المصوغة بالمناهج الفيلولوجية (فقه اللغة) التي تدرس تكوينات الثقافة عبر تحقيق المخطوطات وتحليلها.
وتبدو العلاقة الجلية بين “التأويل الحداثي للتراث” و”الاستشراق الفيلولوجي” في مصطلحين نحتهما المؤلف هما “التوفيد” و”التسييس”، حيث تخلص عامة المناهج المشار إليها في الوصول بالتراث إلى إحدى نهايتين؛ إما إلى ردّ علوم التراث إلى كونها اقتراض من ثقافات سابقة وافدة وإما إلى ردّ علوم التراث إلى أنها حصيلة صراع سياسي.
وينتقد المؤلف ترجمة اللفظ الغربي “فيلولوجيا” بـ”فقه اللغة”؛ لأن كلا المصطلحين في الثقافتين الغربية والعربية، كان لهما سياقهما المختلف، ومن العسير تقبّل أن تكون إحداهما ترجمة للأخرى. لذا فقد قرر استخدام المصطلح الغربي لحين إزالة ذلك الالتباس!
مستشرقو الفيلولوجيا
تضاعف انهماك المستشرقين في الفيلولوجيا حتى جعلها رود بارت أحد مكونات الاستشراق حين قال: “الاستشراق هو علم يختص بالفيلولوجيا (علم اللغة) خاصة”. ويقول إدوارد سعيد: “وبلا استثناء تقريباً، كان كل مستشرق يبدأ حياته العلمية باحثاً في فقه اللغة (الفيلولوجيا)”.
أبرز مستشرقي الفيلولوجيا الذين تسربت أفكارهم إلى الحداثيين العرب هو أرنست رينان (ت1892) القائل: “من غير الفيلولوجيا لن يكون العالم الحديث كما هو عليه الآن، وقد مثلت الفيلولوجيا الفارق الأبرز بين القرون الوسطى والعصر الحديث”. ورينان هو صاحب النظرية العنصرية التمييزية بين السامية والآرية التي راجت بعد أن تبناها ونشرها بصيغة مخففة أحمد أمين ثم محمد عابد الجابري، وملخّص النظرية أن الغرب الآري عظيم متقدم، والشرق السامي على النقيض. وفيها يهجو اللغة العربية ويصفها بأنها لغة مفتّتة عاجزة عن استخلاص الكليات والتجريد الذهني.
ورينان نفسه، الذي يعدّ مصدراً لحداثيينا العرب، لم يكن موضوعياً في إنتاجه، فهو يعترف بعنصريته قائلاً: “أنا المعروف بوداعتي مع جميع الناس، والذي أعاتب نفسي على عدم كرهي للشر، أعلن أني لست أشفق على الإسلام، وإني أتمنى للإسلام الموت المخزي، أتمنى إذلاله”! ويقول في موضع آخر: “إن الشرط الضروري الوحيد، في عصرنا الحاضر، لنشر الحضارة الأوروبية هو تحطيم العنصر السامي، تحطيم القوة الثيوقراطية للإسلام، وبالتالي تحطيم الإسلام نفسه، ثم حرب لا تتوقف، ولن تتوقف هذه الحرب إلا فقط حينما يموت آخر ولد من ذرية إسماعيل بؤساً، أو أن يدفع الإرهاب إلى أعماق الصحراء“!
ثمة أزمة أخرى عانت منها موضوعية كثير من مستشرقي الفيلولوجيا، فقد تحدث المستشرق ماكسيم رودنسون عن “حقبة الاستشراق الكلاسيكي” منوهاً إلى أن المستشرق كان مضطراً لتعلّم اللغة الأجنبية، ودراسة المخطوطات، وكونها تلتهم عمره العلمي، فلا يتسع له الوقت للتزوّد بأدوت علمية أخرى! أما برنارد لويس فله عبارة معبّرة عن واقع المنجز الاستشراقي فيقول: “المستشرق الكلاسيكي كان قد تربى في أحضان علم اللاهوت والفيلولوجيا، وأحياناً علم التاريخ، وفجأة راحوا يطلبون منه أن يتحمّل مسؤولية السياسة الحديثة والاقتصاد والمجتمع، وقَبِلَ المستشرق بذلك طوعاً أو كرهاً، وراح يتدخل في كل شيء، ويناقش كل شيء، من المعلّقات الجاهلية، إلى الصناعات البترولية والبنك الحديث! وظهرت نواقص هذه العملية بسرعة جليّة للعيان“!
كما يتطرق المؤلف إلى قصور تعامل المستشرق مع (النص)، فيقول إن المستشرق يتماس داخل أضابير التراث الإسلامي مع نصوص دينية مؤسسة، قرآنية ونبوية، مع نصوص فنية في الشعر والنثر، ومع آداب حكمية أنشأها فلاسفة، ومع نماذج نصية حوارية تقتبسها كتب التراجم تتجسّد فيها طبيعة حياة الناس وأنماط تفكيرهم وخيالهم اللغوي وكامل آفاقهم الدلالية. ومع كل هذا الغنى النصوصي، كان عامة المستشرقين يقرأون هذه المعطيات النصية بما يمكن تسميته بـ”أدوات المثقف العام”، فلا يوظِّف بشكل منهجي منظّم كل المخزون التنظيري في علوم الدلالة في الفكر الغربي (فلسفة اللغة، اللسانيات، النقد الأدبي، الهرمنيوطيقا).
الاستشراق الفيلولوجي لم يكن وحده هو ما قدمته المدارس الغربية، وإن كان وحده الذي تأثر به الحداثيون العرب، فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين مدرستان استشراقيتان هما: مدرسة “أنثروبولوجيا الإسلام”، وتهتم بدراسة المجتمعات المسلمة المعاصرة بتوظيف بعض النماذج التفسيرية في العلوم الاجتماعية، ومدرسة “المراجعين”، وتقوم على الشك في المصادر الإسلامية، وتبحث عن مصادر تاريخية أخرى لدى الأمم المجايلة لحقبة ظهور الإسلام! لكن حتى الآن لا يوجد لصوتِ هاتين المدرستين صدىً في كتابات الحداثيين العرب!
التسريبات الأولى
يقال إن أول من طبّق الفيلولوجيا في المحيط العربي هو جورجي زيدان في كتابه “فلسفة اللغة العربية” سنة 1886م. وتحت عنوان البرامج العربية الشاملة لتأريخ التراث، وضعه المؤلف من أوائل من اعتمد على التركة الاستشراقية بشكل صريح ومبكر، فلم يكن زيدان يخفي تأثره بالمستشرقين. في المقابل كان هناك من يخفي ذلك، فينقل عنهم نتائج بحوثهم دون أن يشير إلى ذلك، مثلما كان يفعل أحمد أمين، الذي استلم الراية بعد زيدان، وكان أكثر تأثيراً منه.
ووفقاً للمؤلف، فإن أحمد أمين في سلسلته المشهورة في تاريخ الإسلام، كان مهزوماً أمام تحليلات المستشرقين مذعناً لطعونهم في العلوم الإسلامية، خاصة السنّة النبوية، لكنه كان يعيد تحليلاتهم بلغة ديبلوماسية، فلا يجرح القارئ ولا يثير سكينته!
يروي السكران موقفاً يدل على أن أسلوب أحمد أمين في عرض آرائه لم يكن عفوياً، بل كان استراتيجية واعية. ففي نهاية ثلاثينيات القرن الماضي ألقى الأستاذ علي حسن عبد القادر محاضرة لخّص فيها بحثاً لجولدزيهر يطعن به في الإمام الزهري؛ فثار الأزهر ضده، فكان أن نصحه أحمد أمين قائلاً: “إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة، فخير طريقة لبث ما تراه مناسباً من آراء المستشرقين ألا تنسبها إليهم بصراحة، ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك، وألبسها ثوباً رقيقاً لا يزعجهم مسّها، كما فعلت أنا في فجر الإسلام وضحى الإسلام“.
عقيدة المؤلف
بذل المؤلف جهداً كبيراً في التعريف بجهود الحداثيين في مجال قراءة التراث، وتعرّض لبعضهم بالتفصيل والتحليل، مثلما فعل مع طيب تيزيني وحسين مروة وحسن حنفي ونصر أبو زيد ومحمد عابد الجابري وأدونيس وغيرهم.
وعلى الرغم من أن المؤلف آل على نفسه الموضوعية في عرض مسألة الاستمدادات، وكيف تسرّبت أفكار المستشرقين إلى الحداثيين العرب دون الخوض في متانة الأطروحات المستمدة من عدمها، فإنه يظهر أحياناً بصورة الشيخ المتديّن الناقد لأي أطروحة تعارض قناعاته الإيمانية، دون تقديم أي مناقشة علمية تذكر، مثل قوله: “يندر جداً من المستشرقين من يرحّب بالصورة الصحيحة وهي مذهب أهل السنّة”. فنتيجة أن الصورة الصحيحة للإسلام هي مذهب أهل السنة ليست موضوع الكتاب أصلاً، وإذ طرحت فإنها تحتاج إلى مقدمة أكثر عمقاً من مجرد إصدارها في هيئة (فرمان).
أو كلامه عن وائل حلاق، بأنه يتعامل مع رسول الله “بلغة غير مهذبة، ولا يتحرّى الأدب، وهذا مفهوم، للأسف، لكونه نصرانياً عربياً”. معترضاً على قوله: “ولم يكن بإمكان محمد أن يفكر في تشريع من خلال هذه المصطلحات المتطورة”! ويقول أيضاً عن حلاق: “وهكذا يتعامل بقلّة أدب مع أئمة السلف كقوله عن الإمام شريح: القاضي شريح عرف بممارساته التي تتضمن خرقاً صارخاً للقرآن”. وهي عبارات عاطفية تفتقر إلى ما تحتاجه من تفنيد لادعاءات حلاق! ومثل هذه الملاحظات تكاد تكون قليلة ولا تضر بالجهود الكبيرة المبذولة في الكتاب، وهدفه الأساس في رصد رؤية الاستشراق لتراث المسلمين، وكيف تسربت هذه الرؤية لكتابات الحداثيين العرب، لدرجة أنهم اقتصروا عليها وحدها حين قرروا “إعادة قراءة التراث“!
—–
* المصدر: العربي الجديد.