لا ريب أن واقع الأحداث والأزمات الكبيرة تفرض نفسها على العقل فتشحذه، وعلى الهمة فتوقظها، وعلى العزائم فتنميها، وعلى الإرادات فتقويها، وعلى الأخلاق فتلهبها، ثم هي في الوقت ذاته كاشفة ومُمتحنة لما سبق.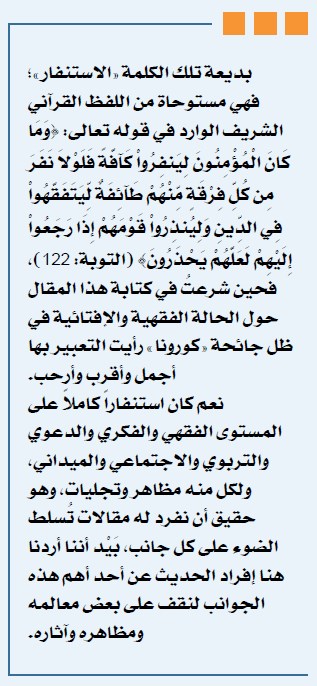
ولم يسلم من هذا الاختبار صغير أو كبير، عالم أو مقلد، سياسي أو حزبي، كلٌّ على حسب قَدْره وبلائه، وتلك هي طبيعة النوازل والمدلهمات.
منذ وقعتْ واقعة الفيروس الذي حاصر الدنيا وأربك العالم وعطل مسارات الحياة -وكأنّ القيامة قد قامت- انطلق العلماء والدعاة في الشرق والغرب في غَيرة مُعجبة، وحماسة مُلهبة، وترشيد وتثقيف وتوعية جماهيرية، وحركة دائبة للتعاطي مع تلك الأزمة وما أفرزته من واقع تجلى على المشهد الديني والاجتماعي والاقتصادي، نجم عنه كثير من الأسئلة الفقهية والعقدية والأخلاقية.
انطلق الفيروس المجنون من الصين وظن العالم في الغرب والشرق أنه عنه بعيد، وانبرى بعض المسلمين شامتين مُعَلقين هذه الجائحة على ظلم أصاب المسلمين هناك، وحينما زحف على أوروبا دار جدل فقهي حول بعض المسائل، أبرزها وقف صلاة الجمعة والجماعات والمدارس والجامعات وغيرها، وفقدت الدول عوائدها الاقتصادية، وحصد الفيروس عشرات الألوف من الأرواح وأضعافهم من المصابين.
واقعٌ جديدٌ أنتج حالة لم يعشها المسلمون من قبل باعتبار امتدادها آفاق الكرة الأرضية.
وبرزت أسئلة وأجوبة كشفت مناحي القوة والضعف في الجانب المعرفي والثقافي والشرعي والأخلاقي والنفسي، منها:
– هل الفيروس عقاب من الله تعالى؟
– ما العلاقة بين القدر والأسباب؟
– هل ما وقع في الصين عقوبة لهم على ظلم المسلمين؟
– كيف نتعامل مع المصاب بفيروس «كورونا»؟
– هل يجوز تعطيل صلاة الجمعة وقاية من انتشار الفيروس؟
– هل تصح صلاة الجمعة في البيوت؟
– ما حكم الصلاة مع انقطاع الصفوف بمسافة متر ونصف متر؟
– ما واجب المسلم الاجتماعي في الواقع الأوروبي والعالمي؟
– ما حكم تغسيل المتوفى بالفيروس إن غلب على الظن العدوى؟
– ما حكم تقديم مريض على مريض آخر عند العجز عن مداواتهما معاً؟
– هل يجوز الإفطار بسبب فيروس «كورونا»؟
– كيف يصلي المسلمون التراويح في رمضان؟ هل تجوز الصلاة خلف البث المباشر؟
– هل يجوز القرض الربوي للمساجد والمؤسسات التي تضررت بسبب الفيروس؟
تلك الأسئلة أوجدت حالة من الحراك الفقهي والإفتائي والفكري والفلسفي، وكشف كثيراً من الحقائق وجوانب القوة والضعف عند عوام المسلمين ونُخَبهم، أهمها، في تقديري، الحرص العام من المسلمين على أمور دينهم؛ فكثير من المسلمين شرقاً وغرباً لم يستوعبوا أبداً أن يُحرموا من صلاة الجمعة والجماعة بعد أن عاشوا عليها ردحاً من الزمان وتعلقت قلوبهم ببيوت الله تعالى.
لهذا كثر التفاتي حول أحكام الصلاة في ظل الجائحة، وتأملتُ الجماهير لعدم تمكنهم من الصلاة في المساجد.
وانتاب الناس شعور بالخطر على الدين؛ فأقبلوا على البرامج الدعوية والتعليمية والتثقيفية والروحية التي نفرت لها المساجد والدعاة والمؤسسات الإسلامية حول العالم على نحو ألقى في النفوس الطمأنينة، وضاعف الثقة في العلماء والدعاة أنهم على قدر المسؤولية الكبيرة، وأن راية الدين والعلم والتربية ستجد من يحملها ويأخذها بحقها.
وإذا كانت فتوى صلاة الجمعة في البيوت والصلاة خلف البث المباشر مخالفة لجماهير العلماء والمجامع الفقهية، فإن باعثها ومحركها هو الحرص على الناس والخوف على الشعيرة. 
وهذا الحرص وتلك العاطفة المقدّرة كانت حاضرة خلف فكرة الصلاة المتباعدة في وقت اشتداد الأزمة وانتشار الفيروس، كحلٍّ من باب «أخف الضررين»، ولا ريب أن الفتوى بتعليق الصلوات هي الأصح والأسلم في ذلك الوقت.
النوازل تبعث على النظر والتأمل والمراجعة:
سألني الصحفي المعروف د. راين هيرمان، الكاتب في أحد أهم الصحف الألمانية «Frankfurte Algemeine Zeitung”، قائلاً: ألا تنزعجون من الفتاوى التي تنتشر عبر الإنترنت من غير المختصين، سواء في ظل أزمة “كورونا” أو غيرها؟
قلت: لا أنزعج كثيراً؛ لأن البضاعة الجيدة تدفع الرديئة، ثم إننا نعيش عصر الثورة المعرفية المفتوحة، فهو سباق، ومن شأنه أن يصنع حالة من التدافع الإيجابي الذي يحرك العقول نحو النظر والتأمل والمراجعة والبحث واقتحام تلك الساحات، وفي يدك منتج علمي قادر على الظفر بالعقول والقلوب، وهذا دورنا وتلك مهمتنا.
إنني مغتبط بالدور الكبير الذي قامت به المؤسسات الإفتائية الجماعية والجهود الفردية؛ تأصيلاً وتقعيداً وترشيداً وتوجيهاً للمسلمين، للتعامل الأمثل مع تلك الجائحة ومقتضياتها، والإجابة عن أسئلة الجماهير.
فقد قدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وغيرهما من المؤسسات العلمائية والإفتائية حول العالم، جهوداً كبيرة سابقة، وعقد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث دورتين متتاليتين عبر شبكة الإنترنت، وأصدر عدداً من الفتاوى المهمة التي تتعلق بالعبادات والمعاملات في ظل هذه الجائحة.
وهو جهد مشكور وله أجر موفور، على الرغم من ضعف الإمكانات المادية والبشرية، غير أن الشعور بالمسؤولية والحاجة الماسة للبيان والتوجيه كانت دافعاً لبذل الجهود الفكرية وتقليب الرأي والاستجابة للنازلة ومقتضياتها.
رعاية البُعد المصلحي وأثره الرسالي:
يجب أن يبرهن الاجتهاد الفقهي في النوازل خاصة على حكمة التشريع الإسلامي ورعايته لمصالح العباد في الدارين، وقدرته على معالجة القضايا المتجددة.
يُصَدر كثير من العلماء كتاباتهم بهذه العبارة الذهبية الجامعة لابن القيم التي افتتح بها كتابه العظيم «إعلام الموقعين»: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمه كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل».
ومن الخطأ والعجز أن تكون المسافة كبيرة بين التنظير والتطبيق، وأبرز اختبار حقيقي للفقه المتشبع بمقاصد الشرع هو ميدان الحركة والأحداث والنوازل، وقد تجلى واضحاً في عدد من الفتاوى، مثل تعليق الجمعة والجماعات في ظل اشتداد أزمة «كورونا»، والفتوى بعدم صحة صلاة التراويح في رمضان خلف البث المباشر.
وحينما سألني الصحفي آنف الذكر عن سبب تعليق الجمعة والجماعات قلنا: إن حفظ النفس في سلم الضرورات مُقَدَّم على حفظ الدين في مرتبة الحاجيات أو التحسينيات، بل إن حفظ النفس هو من صلب حفظ الدين نفسه، فإن زهقت الأرواح فمن يقوم بحفظ الدين؟ ثم إننا حين نؤكد أن الدين يحفظ الأرواح والحياة، فإننا نؤكد ربانيته وحاجة البشرية إليه ونرد الناس إليه ونذود عنه التهم والشبهات.
فتلك القواعد يجب أن تكون حاكمة لنا في النظر والتأصيل والاختيارات الفقهية، وقد أفتى المجلس الأوروبي بجواز ترك غسل المتوفى بفيروس «كورونا» إن غلب على الظن العدوى حفظاً لحق الحي وهو أولى وأجدر بالوقاية. 
لذلك كنا ننتقد تهاون بعض المسلمين وتعجلهم في فتح المساجد في بدايات الجائحة، وقلنا مرات: إن الأديان يجب أن تكون سابقة للقرارات السياسية، فلا تتأخر أو تتهاون، بل تؤكد حفظ الحياة والدعوة بكل سبيل على أسباب الوقاية.
تأكيد خلود وصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان:
مبدأ لا يختلف عليه مسلمان؛ أن الإسلام جاء صالحاً لمعالجة قضايا كل عصر وكل بيئة، ولا ريب في ذلك، وصدق الله مولانا العظيم: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل: 89)، ورحم الله الإمام الشافعي حين قال: «وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها».
وعمل المجتهدين هنا: الكشف عن مراد الله تعالى في المسألة رجاء إصابة الأجرين عند الصواب أو الأجر عند الخطأ.
ومن أهم ما يُنْجد الفقيه أن الشريعة اشتملت أصولاً وقواعد كلية مرنة تُسعف المجتهدين بالنظر في المستجدات والنوازل، يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه «مقاصد الشريعة»: «فعموم الشريعة لسائر البشر في سائر العصور مما أجمع عليه المسلمون، وقد أجمعوا على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان، وهي عندي بكيفيتين:
الأولى: أن هذه الشريعة قابلة بأصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال، بحيث تساير أحكامها مختلف الأحوال دون حرج ولا مشقة ولا عسر.
الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلاً للتشكيل على نحو أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسر، كما أمكن تغيير الإسلام لبعض أحوال العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتتار والهنود والصين والترك من غير أن يجدوا حرجاً ولا عسراً في الإقلاع عما نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة».
ولعل أعظم ما يعين المجتهدين في وقت الأزمات النصوص الكلية التي وردت في القرآن الكريم، والقواعد الأصولية والفقهية الجامعة التي تتخرج عليها المسائل الجزئية، فقواعد الضرورة والرخص هي التي ألجأتنا إلى القول بتعليق الجمعة والجماعات، وترك تغسيل الميت المصاب بالفيروس والدفن في مقابر غير المسلمين عند انعدام المقبرة الخاصة بالمسلمين، وقاعدة أخف الضررين وأهون الشرين جعلتنا نريد الفتح التدريجي للمساجد والصلاة مع انقطاع الصفوف أولى من تركها وبُعد الناس عن المساجد زمناً طويلاً.
وهذا هو الفقه الذي يدخل إلى القلوب بغير استئذان، كما عبر عن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ذلك الفقه الذي يستحضر المقاصد والمعاني في معالجة النوازل والمستجدات، ويعتبر مراتب الأعمال، ويُفَعل فقه الموازنة بين الأعمال والتصرفات، ويقدر المصالح والمفاسد؛ فيقدم المصلحة الغالبة على المفسدة، ويتحمل أخف الضررين وأهون الشرين.
ولا ريب أنه معترك دقيق يتداخل فيه الشرعي والإنساني والطبي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
البعد الواقعي وأثره في تغير الفتوى:
الفتوى هي ثمرة تفاعل النص مع الواقع، وبقدر الإحاطة بهذا الواقع ومعرفته تكون الفتوى أقرب للصواب، وليس ثمة واقع أشد تعقيداً من زماننا، والحكم على الشيء فرع من تصوره، والتسرع في بعض الفتاوى كان أحد أهم أسبابه ضعف تصور المسألة، وخطأ بعض المعلومات، وعدم اللجوء إلى أهل الاختصاص، وقد عقد الإمام ابن القيم فصلاً في باب تغيُّر الفتوى وعدَّ من أسباب تغيرها ستة، وأضاف العلامة الإمام القرضاوي أربعة في كتابه «موجبات تغير الفتوى».
وكلما كان المفتي أو المجالس الإفتائية قريبة من الواقع بأبعاده النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمآلاتية؛ كانت الفتوى أقرب للحق وأرعى للمصلحة وأرجى للنفع.
لكن الصعوبة هنا في التغير المتسارع للواقع خاصة عند الأزمات، فقد تابعنا وما زلنا كيف أدارت ألمانيا كنموذج ناجح أزمة «كورونا»، فكان القرار السياسي مرهوناً بالجهات المختصة، وأنا لا أريد أن أطالب المؤسسات العلمائية الإفتائية حول العالم بنفس المقدار؛ وذلك لقلة المؤونة وضعف الإمكانات المالية والبشرية، لكن المأمول والمنشود دوماً أن نلاحق الواقع ونتابعه على نحو دقيق، وحادينا إليه أهل الاختصاص في كل فن.
وما أجمل عبارة ابن القيم الذي يؤكد فيها أهمية فهم الواقع، يقول رحمه الله: ولا يتمكن المفتي، ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهْم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات «حتى يحيط به علماً».
والثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر.
ومن هناك كان القرار بفتح المساجد مع كافة الاحترازات الصحية نابعاً من القرارات الإدارات التي انطلقت من واقع الحال المؤسس على الدراسات والبحوث والإحصائيات.
في ختام هذا المقال، أؤكد أن ما أنتجته جائحة «كورونا» من حراك فقهي كبير كشف عن طاقات موفورة وقدرة على إدارة الأزمة عند المؤسسات العلمائية والإفتائية «المستقلة»، والتصدي لحاجات الناس والإجابة عن تساؤلاتهم، لكننا بحاجة إلى إحياء الفقه «الأرأيتي»؛ وهو الفقه الافتراضي أو النظر المستقبلي، ولا ريب أن فتاوى الضرورة مما تفرضه الحوادث وتقلبات الأيام.
ونرى أن الاجتهاد الجماعي أقوم قيلاً من الاجتهاد الفردي، وإن كان الأول لا يمنع الثاني ولا يحجر عليه، وحين نقلب النظر سنجد أن فتاوى المجامع الفقهية في جائحة «كورونا» أدق وأقرب لمقاصد الشرع ومصالح العباد من الاجتهادات الفردية.
ولا أدعي ولا غيري أن هناك عصمة لأحد بعد الله ورسوله، إنما هو تسديد ومقاربة، ثم بعد ذلك يبقى هامش المراجعة وتقليب الرأي والنظر، وتبقى دوماً قلوب وعقول أهل العلم والفقه منفتحة للنصيحة، وتبقى ساحات النقاش فسيحة وفق آداب الاختلاف التي ورثناها عن عظمائنا الفقهاء الذين شيدوا من سعة العلم والخلق والأدب ما يسع الناس جميعاً.






