لا يمكن فهم التوتر بين أوروبا وتركيا اليوم بدون العودة إلى التاريخ، بل إن التوتر بين أوروبا ومنطقة الشرق الأدنى أو المشرق عموماً يعود إلى ما قبل ولادة تركيا وتحديداً إلى العصر البيزنطي، حيث كانت القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية منافساً قوياً لأوروبا.
عقدة النزعة الاستعلائية الأوروبية
ويتمثل جوهر المشكل في أن القارة العجوز كما تسمَّى أوروبا لا تقبل بأي منافس لها من منطلق ثقافي حضاري، وعبر تاريخها الممتد من الحضارة اليونانية والرومانية إلى العصر الحاضر أو ما يسمّى بـ”الحداثة وما بعد الحداثة الغربية المعاصرة”، كان الطابع الاستعلائي غالباً على نخبها السياسية والدينية والفكرية، حيث تعتبر أوروبا مهد الحضارة ومنبع الأنوار، مع الإشارة في المقابل إلى وجود تيارات وشخصيات منصفة ومحبة للسلام وللحوار الحضاري.
وتسببت هذه النزعة “التفوقية” تاريخياً في العديد من الحملات الصليبية والاستعمارية والاستعبادية للشعوب، وفي ظهور تيارات فاشية وعنصرية تسببت في حربين عالميتين وكوارث إنسانية.
واليوم تنتشر الشعبوية أو اليمين المتطرف الذي يحمل في طياته عنصرية مقيتة لكل ما هو غير أوروبي وانتماء ثقافي وحضاري مغاير.
الكنسية الشرقية تتمرد على الكنسية الغربية
وعلى صعيد العلاقات الأوروبية مع الشرق الأدنى، ظهر التوتر سريعاً مع القسطنطينية التي اختارت المسيحية الأرثوذكسية ورفضت سلطة البابا الكاثوليكي على الأرثوذكس، ورأت أوروبا التي تدين بالمسيحية الكاثوليكية في ذلك شقّاً لعصا الطاعة مع البابوية في روما، فكان الانشقاق والخلاف العميق بين الطرفين منذ عام 1054م.
وساهم هذا الانشقاق المسيحي في تقوية التدافع بين بيزنطة والعالم الإسلامي، وتحديداً مع دولة السلاجقة (نسبة إلى مؤسسها سلجوق بن دقاق) وهم شعوب من أصول تركية هاجرت من آسيا الوسطى (الموطن الأصلي للقبائل التركية) وأقامت إمارات في الشرق ومن أهمها إمارة سلاجقة الروم في الأناضول شرق بيزنطة، التي بدأت تزحف تدريجياً نحو القسطنطينية، يحدوها الأمل في تحقيق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم “لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش”.
وكانت معركة “ملاذكرد” الشهيرة في عام سنة 463هـ/ 1071م، نقطة فاصلة في العلاقة بين أوروبا والعالم الإسلامي، حيث تمكّن السلطان والقائد السلجوقي ألب أرسلان من تكبيد الجيش البيزنطي هزيمة ساحقة، بل تم أسر إمبراطور الدولة البيزنطية رومانوس الرابع، وتمَّ فداؤه بألف ألف دينار، وأطلقت الدولة البيزنطية صيحة إنذار مستنجدة بأوروبا المسيحية، التي تباطأت في التضامن مع بيزنطة بالنظر إلى الخلاف العميق بينهما.

تخوف من القوة التركية السلجوقية
إلا أن أوروبا لم تُخْفِ تخوّفها من القوة السلجوقية التركية المسلمة السنّيّة الصاعدة في منطقة آسيا الصغرى، وكانت تنتظر الفرصة المناسبة لضرب هذه القوة المنافسة، كما كانت تبحث عن مسوّغ لتبرير دخول قواتها إلى منطقة الشرق الأدنى، علماً بأن الشرق بخيراته وثرواته وحضارته كان حلم الملوك والأمراء في الغرب، وكلهم كانوا يتوقون لموقع قدم في تلك الأرض التي تعدّ مهبط النبوة ومركز التجارة.
وكانت الفرصة مناسبة عندما بدأت عوارض الضعف على الأمة الإسلامية والخلافة العباسية نتيجة انتشار موجة التشيع السياسي التي حاولت التحكم في مفاصل الخلافة العباسية كما حصل مع البويهيين (بنو بويه) الذين سيطروا على الخلافة وأذلّوا كبرياء الخلفاء، وهيمنوا على سلطة القرار مما أضعف كيان الدولة، بالتزامن مع استحواذ السلطة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية على شمال أفريقيا وأسسوا في مصر مدينة القاهرة لـ”تقهر” بغداد وسيطروا على الشام وفلسطين.
أمام هذا الوضع الخطير، استنصر الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالسلاجقة الذين أزاحوا البويهيين من بغداد وأزاحوا الفاطميين من الشام وفلسطين، وكان لهم فضل كبير في رفع راية الإسلام، والقضاء على المدّ الشيعي، وإطالة عمر الخلافة العباسية السنيّة أكثر من قرنين من الزمان.
لم تكن هذه الانتعاشة السياسية والدينية للخلافة الإسلامية لتعجب أوروبا المسيحية التي كانت تتطلع إلى السيطرة على كيان في حالة ترهل وضعف، ولهذا لم تغفر أوروبا للأتراك السلاجقة دورهم منذ عهد ألب أرسلان في ظهور قوة العالم الإسلامي كقوة مرهوبة يحسب لها ألف حساب.
خطاب الكراهية والتحريض على الحروب الصليبية
انبرت السلطة الدينية في أوروبا متمثلة في البابوية للتحريض على الأتراك، في هذا السياق، يأتي الخطاب الشهير لبابا الفاتيكان أوربان الثاني يوم 27 نوفمبر 1095م أمام جمع من
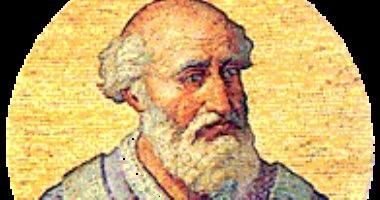
أوربان الثاني
الأساقفة في مدينة كلارمون وسط فرنسا، في هذا الخطاب فتح أوربان الثاني النار على الأتراك والمقصود بهم المسلمون، فنعتهم بأقذر النعوت مثل “الكفار” و”الجنس الخبيث واللعين”، مدّعياً أن هؤلاء يقومون باضطهاد نصارى المشرق وتعذيبهم بوحشية، ولعل هذا الخطاب يمثل بداية ما يسمى اليوم حملة “الإسلاموفوبيا” (التخويف والخوف من الإسلام) التي تعود في جذورها إلى القرن الحادي عشر، والنتيجة التعبئة لحروب باسم الصليب امتدت لحوالي قرنين 1096- 1291م، وهي من أشهر حروب التاريخ، أشعلها خطاب أوربان وأطفأها السلطان المملوكي قلاوون.
وإذا كان البابا قد تظاهر بالدعوة إلى أهداف نبيلة مثل إنقاذ قبر المسيح في فلسطين، ورفع الاضطهاد عن نصارى المشرق كما ادّعى، فإن الخلفيات الدينية والسياسية كانت تتمثل في استعادة سلطة الكنيسة العسكرية والسياسية على كامل أوروبا، والأهم من ذلك استغلال استنجاد إمبراطور الدولة البيزنطية ألكسيوس كومنين بالبابا من هجوم السلاجقة المسلمين على القسطنطينية ليجد الفرصة سانحة لضم الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية إلى كنيسته الكاثوليكية تحت كرسيه.
الطاقة الكامنة في الأمة الإسلامية
إلا أن ما لم تحسب له أوروبا النصرانية حساباً وهو الطاقة الكامنة في الأمة لاسترجاع قوتها بعد ضعف، إذ تصدت جيوش نورالدين زنكي، وصلاح الدين الأيوبي، ثم السلطان قلاوون للصليبين ودحرتهم، كما أنه لم يتم القضاء على الأتراك السلاجقة بل التحق بسلاجقة الروم قبائل تركية أخرى بقيادة أرطغرل الذي تمت مكافأته على ولائه للسلطان السلجوقي علاء الدين -في حربه ضد البيزنطيين من باب حميّة الدين- بإعطائه إمارة تقع في أقصى غرب الأناضول في منطقة سوجوت، على حدود الدولة البيزنطيَّة وحصل على لقب “محافظ الحدود”، وخلفه ابنه عثمان ليطور الإمارة ولكن بالاستقلال عن سلاجقة الروم الذين دخلوا مرحلة الضعف.
وهكذا نشأت الدولة العثمانية عام 1299م على يد عثمان بن أرطغرل، التي ستمتد ستة قرون حتى عام 1924م، ومنذ ذلك الوقت، تعاملت أوروبا مع هذا الكيان الوليد باعتباره منافساً شرساً لها، خاصة وأن هؤلاء العثمانيين دخلوا منذ منتصف القرن الرابع عشر إلى قلب أوروبا في منطقة البلقان -التي تبنت نسبة من شعوبها الإسلام- إلى حدّ التهديد بمد جسور مع الأندلس المسلمة في ذلك الوقت، قبل أن يطيحوا بقلعة المسيحية في المشرق، ألا وهي القسطنطينية التي دخلها محمد الفاتح فاتحاً يوم 29 مايو 1453م.
1453 المنعرج التاريخي الحاسم
ويُعتبر فتح القسطنطينية وتحوّلها إلى حاضرة الإسلام الكبرى (إسطنبول) منعرجاً تاريخياً، حيث أنهى هذا الفتح الوجودَ المسيحي السياسي في المشرق ممثلاً في الإمبراطورية البيزنطية التي عاشت أكثر من ألف عام، وعزّز الدور الحضاري الإسلامي، ولكنه وفي الوقت نفسه، عمّق التدافع الأوروبي/ التركي– الإسلامي، ومن مظاهر هذا التدافع صب جام غضب أوروبا النصرانية على ما تبقى من وجود إسلامي في الأندلس وإسقاط غرناطة عام 1492م آخر معقل للإسلام هناك بعد حضور دام ثمانية قرون منذ عام 711م.
وحتى العلاقة الدبلوماسية العثمانية الفرنسية الجيدة خلال القرن السادس عشر -بين السلطان سليمان الذي حكم 46 عاماً (1520- 1566م) وملك فرنسا فرانسوا الأول- لقيت معارضة شديدة من اللوبي المسيحي، إذ نُعت فرانسوا الأول بـ”جلاد المسيحية”، كما نُعت هذا التحالف الفرنسي التركي بـ”التحالف الأثيم”، رغم أنه يعدّ من أهم وأطول التحالفات الخارجية الفرنسية، وأنه خدم مصالح فرنسا في الدفاع عنها خلال الحروب الإيطالية.
لكن بعد أكثر من قرنين ونصف القرن، عاد التدافع على أشده منذ أن قام بونابارت بحملته الشهيرة على مصر الولاية العثمانية بين عامي 1798-1801م ممهّداً بذلك الحقبة الاستعمارية وما صحبها من مخططات لتقسيم أوصال الإمبراطورية العثمانية وأخطرها الاتفاقية السرية الفرنسية البريطانية المعروفة باتفاقية “سايكس بيكو” عام 1916م، ثم “وعد بلفور” عام 1917م، وانتهاء بنهج علماني مفروض بالقوة بقيادة مصطفى أتاتورك، وكانت أوروبا مطمئنة لهذا المسار العلماني بل وتشجع المؤسسة العسكرية التركية حامية العلمانية على المضي في هذا النهج لأنه يخدم مصالحها.
رياح التغيير في تركيا.. من العلمانية إلى النهج الإسلامي
لكن رياح التغيير بدأت تهب في تركيا الحديثة في اتجاه استرجاع الهوية الإسلامية، فظهرت الحركة النورسية نسبة إلى سعيد النورسي (1873 – 1960م).

ثم الحركة الإسلامية المعاصرة ممثلة في حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان (1926 – 2011م)، ثم تلميذه رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي لتركيا، الذي مضى في نهج تقليم أظافر العلمانية وتحويل بلده إلى قوة إقليمية مهيبة الجانب.

نجم الدين أربكان
ومنذ ذلك الوقت، وتركيا تحت نيران الغضب الأوروبي وتحديداً رئيسها الذي يُنعَت بـ”الدكتاتور” ووريث السلطنة العثمانية.. وغيرها من الأوصاف والنعوت التي تنمّ على قلق بالغ من تراجع المشروع العلماني في هذا البلد، ومن تراجع الامتداد الأوروبي في منطقة شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأدنى ومنطقة شمال أفريقيا ومنطقة القوقاز (الحرب الأذربيجانية/ الأرمينية)، في ظل منافسة شديدة بين أوروبا وتركيا، بل إن هذه الأخيرة تطالب الأوروبيين باحترام تعهدهم بإدماج تركيا في أوروبا، علماً بأن ملف الانضمام تعطل بسبب التذبذب داخل البيت الأوروبي في التعامل مع أنقرة خوفاً من موروثها الثقافي والحضاري ووزنها الإقليمي ومرجعيتها الدينية.
ولعل المستجدات الأخيرة وأهمها مخرجات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وانتصار أذربيجان على الأرمن الذي اعتبره بعض المحللين أهم انتصار حاول الغرب ومعه روسيا وإيران أن يمنعه ويتمثل في فتح ممر بري يربط بين العالم الإسلامي الواقع شرق أرمينيا وغربها بدون المرور عبر إيران بما يفتح الطريق بتركيا نحو تعزيز حضورها في بلاد آسيا الوسطى على تخوم الصين، لعل كل هذه المستجدات تقود إلى تعديل في السياسية الأوروبية في اتجاه تخفيض منسوب التدافع بين أوروبا وتركيا.







