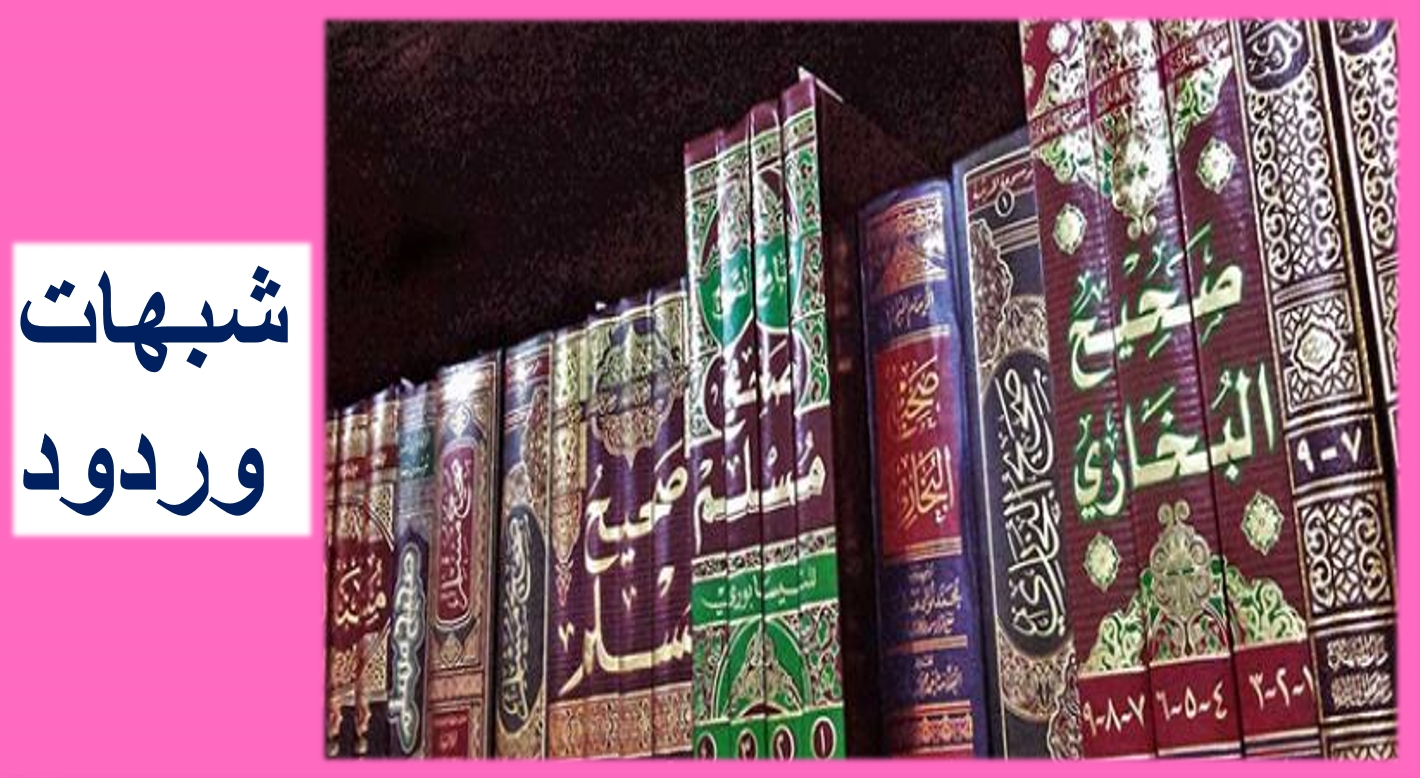قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدة: 3)، قال الإمام ابن كثير: “هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُلْف؛ كما قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا) الأنعام: 115؛ أي: صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل الدين لهم تَمَّت النعمة عليهم، ولهذا قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة: 3؛ أي: فارضوه أنتم لأنفسكم؛ فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه، وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ): هو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدًا، وقد رضيه الله فلا يَسْخَطُه أبدًا. ([1])
هذا هو تفسير العلماء لهذه الآية الكريمة إلا أن منكري السُّنَّة لهم رأي آخر استندوا فيه على هذه الآية الكريمة، وبما أن الجهل والغباء صنوان، فلقد ذهب منكرو السُّنَّة، إلى أن السُّنَّة زيادة في الدين وبدعة ضالة استناداً إلى هذه الآية الحكيمة: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)، ووجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة على إنكار السُّنَّة وأنها بدعة وزيادة في الدين:
– أن هذه الآية نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للسُّنَّة وجود، لأن السُّنَّة جُمِعَت ودونت في القرن الثالث الهجري، فلو كان الدين وكماله متوقفاً عليها ما قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)، وما كان لهذه الآية معنى على الإطلاق يوم نزلت!!!
ويتساءل أحدهم هل كانت الأمة ضالة حتى كتب البخاري ومسلم صحيحيهما؟
كما ذكر ذلك “محمد شحرور” في كتابه المسمى “الكتاب والقرآن قراءة معاصرة” وعقد فصلاً ضافياً عن السُّنَّة أخرجها عن منزلتها عند المسلمين. ([2])
تفنيد هذه الشبهة وبيان بطلانها
لسنا في حاجة، إلى كثير كلام في تفنيد هذه الشبهة وبيان بطلانها، فالرد عليها من البديهيات التي يعلمها كل طلاب العلم، ولو كان عند منكري السُّنَّة ذرة من الفهم لآثروا السكوت على النطق بهذه الشبهة، ولكن بغضهم لسُّنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم أعماهم عن البديهيات في التعامل مع السُّنَّة.
إن وجود السُّنَّة عند هؤلاء يبدأ بجمعها وتدوينها فقط لذلك جزموا بعدم وجودها في القرنين الأول والثاني الهجريين، وشطر من القرن الثالث؟!
وهنا نسألهم السؤال التالي:
من أين جمع علماء الحديث السُّنَّة في القرن الثالث؟، هل هم ابتدعوها ابتداعاً من عند أنفسهم، وانتحلوها كانتحال الشعر الجاهلي حسب مزاعم المستشرقين أسيادكم؟ أم جمعوها من حفاظها ومصادرها التي سمعتها عن الرواة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فإن قالوا: ابتدعوها ابتداعاً من عند أنفسهم فلا كلام لنا معهم، وإن قالوا: جمعوها من صدور حفاظها الثقات قلنا لهم: إذن السُّنَّة كان لها وجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وبعد الهجرة، لأن السُّنَّة هي أقواله وأفعاله وتقريراته -صلى الله عليه وسلم- فهي كانت كالزرع ينمو ويتكاثر على مدى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا هو الواقع فلماذا تفرقون بين الحفظ في الصدور، والخط في السطور؟
إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأمصار عقب وفاته صلى الله عليه وسلم، وفي صدورهم وعلى ألسنتهم أحاديث النبي عليه الصلاة السلام، وسمعها منهم التابعون في كل مصر من الأمصار التي فتحها الإسلام، وكانت هذه السُّنَّة مصابيح هدى بعد القرآن الكريم لدى المسلمين الأوائل؛ ولذلك رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جمع السُّنَّة وتدوينها، روى البخاري في صحيحه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم (والي المدينة وقاضيها في خلافته): “انظروا ما كان من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً”، كما أمر العالم الجليل ابن شهاب الزهري أن يجمع الحديث والسنن، وفي ذلك يقول الإمام الزهري: “أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنة فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا”. ([3])
وقد دبت حركات الجمع في كل الأقطار، في المدينة، وفي مكة، وفي البصرة، وفي الكوفة، وفي اليمن وفي خراسان، وفي واسط، وفي مصر، وفي غيرها، وإن النهي عن كتمان العلم، -والسُّنَّة من أشرف العلوم الإسلامية-، كان يوجب على حُفَاظ السُّنَّة من الصحابة رضي الله عنهم أن يُحدِثوا بها الناس، ويبلغوها كما يبلغون القرآن، ومن هنا يتبين لنا أن السُّنَّة كان لها وجود قوي يوم نزل قوله عز وجل: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)، وكانت هي من عناصر كمال الدين الخالد العظيم، كما كان لهذه السُّنَّة حياة، وأي حياة، في عصر الخلفاء الراشدين الأربعة، قبل عصر عمر بن عبد العزيز بأكثر من خمسين عاماً، فكل منهم – رضي الله عنهم – كان يعمل في حكمه وقضائه وسلوكه وفتاويه بالكتاب العزيز، ثم بالسُّنَّة الطاهرة إذا لم يجد في كتاب الله نصاً فيه حكم ما يعرض لهم من مشكلات.
الحفظ أمكن للوجود من التدوين
إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة الحفظ لقصرها وسداد معانيها وجمال ألفاظها وبلاغة مبانيها والعرب لأنهم كانوا أميين، كان اعتمادهم على الحفظ ملكة راسخة فيهم، وقل منهم من كان يخلو من هذه الملكة، وحفظهم للأحاديث القصار لم يكن أصعب عليهم من حفظ الأنساب ووقائع الأيام والقصائد الطوال، والذاكرة التي استطاعت حفظ كتاب الله عز وجل – على طوله – لم يكن ليعجزها أن تحفظ عشرات الأحاديث التي سمعتها من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، وحفظ السُّنَّة أمكن لوجودها قبل الجمع والتدوين من الجمع والتدوين؛ لأن الحافظ يُحدِث بما يحفظ أكثر وأيسر وأسرع من أن يحدث من كتاب، والكتب لا يحملها صاحبها أين حل، أما حفظه في صدره فهو ملازم له ملازمة الظل للعود.
إن ضخامة الخطأ في هذه الشبهة وترديدها لا ينازع فيه منصف، فكفاكم يا منكري السُّنَّة تهافتا ومكابرة، وأعلموا أنكم لن تفلحوا أبداً في إقناع المسلمين بإنكار السُّنَّة. ([4])
____________________________________________________
[1] – تفسير ابن كثير – 3 /26.
[2] – الكتاب والقرآن قراءة معاصرة – المؤلف: محمد شحرور – 1/541
[3] – صحيح البخاري (بشرح فتح الباري) – كتاب: العلم – باب: كيف يقبض العلم (1/ 234)، رقم (34).
[4] – أصل هذه الشبهات من كتاب: “هذا بيان للناس – الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية” – د. عبد العظيم المطعني – مكتبة وهبة – طبعة 1420هـ – 1999م.