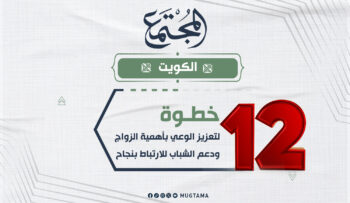واجه الفكر الإسلامي في السنوات الأخيرة جملة من القضايا غير المعهودة حملتها المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة، من قبيل: الانتحار، والإلحاد، والتحول الجنسي، والمثلية الجنسية، وما إلى ذلك من قضايا بات لزاماً خلق أو تطوير خطاب إسلامي بشأنها، وتأسيس مقاربات أخلاقية وفلسفية استمداداً من الأصول الإسلامية في مقابلة الأطروحات المضادة.
وفي السطور التالية نناقش قضية المثلية الجنسية التي فرضتها المواثيق الحقوقية الأممية، وباتت على صلة بمسألة حرية التعبير والإبداع، وذلك من جهتين؛ الأولى تطور فكرة المثلية والسياق الذي ظهرت فيه، والثانية استعراض منطلقات التحريم من المنظور الإسلامي.
موجز تاريخ المثلية في السياق الغربي
«المثلية الجنسية» (Homosexuality) مصطلح حديث صاغه العالم المجري «كارولاي بنكريت» في أواخر القرن التاسع عشر، وهو يستخدم للدلالة على الممارسة الحميمية بين فردين من نفس الجنس (رجل – رجل، امرأة – امرأة)، وقد انتشر المصطلح وشاع استخدامه في مجالات معرفية عديدة؛ كعلم النفس والطب والأنثروبولوجي، وشيئاً فشيئاً تم استبعاد المصطلح القديم الذي استقر قروناً طويلة في الحضارتين الشرقية والغربية، وهو «اللواط» (sodomy)، حيث اعتبر مصطلحاً موصوماً وغير محايد ومحملاً بالمدلولات السلبية.
وتتفق المصادر الدينية المسيحية والإسلامية على أن أول من ابتدع هذه الممارسة قوم لوط، وثمة إشارات أن اليونان القديمة عرفت مثل هذه العلاقة، حيث نجد أثراً لها في حوارات «أفلاطون»، ومسرحيات «أرسطوفانس»، أما في عهد الرومان فقد كانت هذه العلاقة غير مقبولة؛ حيث عاقب قانون «جستنيان» الصادر عام 529م مرتكبي اللواط بالإعدام(1).
نظرت المسيحية بقلق إلى الجنس بصفة عامة وحظرته على الرهبان؛ إلا أنها أباحت نوعاً واحداً هو «الجنس الإنجابي» أو الجنس في إطار الزواج، وفي المقابل نددتْ بأي علاقة تقع خارج هذا الإطار أو بين أفراد الجنس الواحد، وحمل «بولس» الرسول في رسائله على هذه الممارسة الشاذة، ووصف أربابها بأنهم الظالمون الذين لا يرثون ملكوت الله(2)، كما أدانها مجمع «لاتران» المسكوني الثالث، وشدَّد على أن «من يثبت ارتكابه للانقياد الغرائزي الشهواني الذي يخالف الطبيعة سوف يعاقب»، ومن الراجح أن مصطلح الطبيعة المستخدم بكثافة في أدبيات الكنيسة إذ ذاك كان يحيل إلى ما هو أخلاقي، حيث اعتبرت الطبيعة معياراً للأخلاق.
هيمن الخطاب اللاهوتي على المجال العام طيلة قرون؛ وانعكس ذلك على القوانين التي تحظر اللواط وتعاقب مرتكبيه بقسوة، إلا أن عصر النهضة الصناعية شهد تراجعاً في هيمنة الكنيسة وخطابها، وأخذت التفسيرات والحجج الحداثية تحل محلها، وكان الطب وما يرتبط به من مجالات فرعية كعلم النفس هو المجال الذي جرت خلاله إعادة مناقشة اللواط وتقييمه، وجاء ذلك في ظل الزيادة الكبيرة بمعدلات الالتحاق بالمدارس ومكوث الطلاب بها لفترات زمنية طويلة بعيداً عن أسرهم؛ وهو ما حفز العلاقات الجنسية بين المراهقين من نفس الجنس في ظل غياب الرقيب الأسري من جهة، وتزايد حاجة الدولة لأفراد أصحَّاء قادرين على تنفيذ المشروع الإمبريالي، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال الأسر الطبيعية المحددة الوظائف والأدوار.
ومن ثم استدعت الدولة الأطباء النفسيين لفحص المتهمين بجريمة اللواط من جهة أخرى، وقام هؤلاء بفحوصاتهم التي توصلت إلى أن اللواط توجُّه وميلٌ كامن لدى الإنسان قد يمارسه أو يكبحه، وأنه يعبر عن حالة عقلية مرضية(3)، ورغم تصنيف اللواط كمرض نفسي، فإنه تصنيف أقل حدة من تصنيف المسيحية له كإثم، فالمرض لا مدخل للإنسان فيه ولا يمكن وصفه بالقبح أو الحسن، ولا يجوز معاقبة المريض، وهكذا انفتح باب الاعتراف والقبول المجتمعي له.
شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحولاً كبيراً أو بالأحرى انقلاباً في الرؤية الغربية تجاه المثلية؛ فقد حذفتها الجمعية الأمريكية للطب النفسي من قائمة الاضطرابات النفسية، وألغيت القوانين التي حظرت اللواط في كافة البلدان، ومؤخراً نظمت تشريعات بعض الدول «الشراكة المثلية» ورتبت عليها نفس الآثار القانونية لعقد الزواج، وذهبت أخرى إلى ما هو أبعد بإقرارها «الزواج المثلي»، ومن منظور المدافعين عن هذه التطورات فإنها تعد تطبيقاً لمبدأ الحرية الفردية أحد أهم المبادئ الغربية، وتجسيداً لروح التسامح تجاه المختلف أياً ما كان.
وهذا الانقلاب في الرؤى يُمكن تفسيره على ضوء عدة أسباب، أهمها: ما يتعلق بازدراء الجنس وقمعه طويلاً في التاريخ الغربي، وصعود الفلسفات الوضعية التي تعظم من قيمة اللذة والمتعة الحسية، فحين أطيح بالإله في الفكر الفلسفي الغربي شجَّع ذلك الإنسان على الانغماس في ملذَّاته، وأصبح إشباعها غاية مستهدفة، وفي هذا الإطار ظهرت الثورة الجنسية في الستينيات، وانتشار أجنحة متطرفة من الحركة النسوية، إذ شجَّعت النسويات على التخلص من الهيمنة الجنسية الذكورية بإقامة علاقات جنسية بين النساء.
منطلقات التحريم الإسلامي
حمل الإسلام على اللواط في نصوص قطعية لا تحتمل التأويل، واعتبره أحد أسباب هلاك الأمم؛ (وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ) (الأنبياء: 74)، وروي عن رسول الله ﷺ قوله: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ لُوطٍ فاقْتُلُوا الفاعِلَ والمفعولَ بِه»(4)، ويتفق الفقهاء -باستثناء أبي حنيفة- على وجوب قتل اللواطي وإن اختلفوا في الكيفية، وهناك عدد من المصنفات التي تبَحَّر مؤلفوها في بحث قضية اللواط، ومن بينها: «ذم اللواط» للدوري (ت 307هـ)، «تحريم اللواط» للآجُرِّي (ت 360هـ)، «القول المضبوط في تحريم فعل قوم لوط» للواسطي (ت 849هـ)، «قرع السياط في قمع أهل اللواط» للسفاريني (ت 1188هـ)، وإذا كانت هذه المصنفات قد قاربت اللواط من المنظور الفقهي وبيَّنت الأحكام المرتبطة به، فإن بعض الكُتَّاب قد نظروا إلى ما هو أبعد من ذلك، فبحثوا عن علل التحريم سواء أكانت منطقية أو فطرية، وبعضهم حاول أن يُنَظِّر للمسألة فلسفياً كابن تيمية الذي مَوْضَعَ اللواط ضمن منظومة الكبائر في الإسلام وما تُحدثه من إفساد متعدد المجالات.
ولعله مما يستلفت الانتباه أن يكون الجاحظ من أوائل الذين كتبوا في ذم اللواط واستهجنوه في رسالة قصيرة له بعنوان «تفضيل البطن على الظهر»(5)، وفيها يفند دعوى أحدهم تفضيله أن يأتي غلاماً على أنْ يأتيَ امرأةً، والجاحظ يسوق بضع حُجَج عقلية ليدحض بها هذه الدعوى الباطلة، ويمكن أن نتخير منها حجتين:
الأولى: «أن اجتماع المتباينين فيما يقع بصلاحهما (أي النسل) أولى في حكم العقل، وطريق المعرفة فيما أبادهما، وعاد بالضرر (أي تضييع النسل) في اختيارهما عليهما»، وما ذهب إليه الجاحظ قريب مما ذهب إليه الإمام الغزالي بقوله: «نُصِب الزنى سبباً للرجم صيانةً للنَّسْل عن الانقطاع وزَجْراً عن تضييع الماء، وهو جارٍ في اللواط»(6).
الثانية: قوله: «والذي يدل على أن هذه الشهوة معيبة في نفسها، قبيحة في عينها، أن الله تعالى وعزَّ لم يعوض في الآخرة بشهوة الولدان من ترك لوجهه في الدنيا شهوة الغلمان، كما سقى في الآخرة الخمر من تركها له في الدنيا، ثم مدح خمر الجنة بأقصر الكلام، فنظم به جميع المعاني المكروهة في خمر الدنيا فقال: (لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ) (الواقعة: 19)، كأنه تبارك وتعالى قال: لا سكر فيها ولا خمار»، يقصد أنه مما يدلُّ على فساد شهوة الغلمان أن الله لم يعوض على الحرمان منها في الآخرة، كالخمر أو الجواري الحسان.
أما ابن تيمية فيذهب مذهباً آخر حيث يُصنِّف اللواط باعتباره فرعاً من فروع الكبائر، ويقول: إن الله تعالى جعل أكبر الكبائر ثلاث: الكفر ثم القتل ثم الزنى، وهذا الترتيب معقول؛ لأن قُوَى الإنسان ثلاث: العقل، والغضب والشهوة، «فالكفر فساد المقصود الذي له خلقوا، وقتل النفس فساد النفوس الموجودة، والزنى فساد في المنتظر من النوع، فذاك إفساد الموجود، وذاك إفساد لما لم يوجد، بمنزلة من أفسد مالاً موجوداً أو منع المنعقد أن يوجد، وإعدام الموجود أعظم فساداً؛ فلهذا كان الترتيب كذلك»، وهو يربط بين الزنى واللواط ذاهباً إلى أن الأخير أعظم فساداً؛ «لأن الزنى فسادٌ في صفة الوجود لا في أصله»(7).
المحصلة الختامية أن المصنفين الإسلاميين درسوا مسألة اللواط وبحثوا في علل التحريم سواء أكانت فطرية أم عقلية أم أخلاقية، وجُلُّ ما دوَّنُوه من أفكار يمكن أن يُشَكِّل لَبِنة أولية في بناء خطاب إسلامي معاصر حول هذه المسألة.
____________________________________________________
(1) موسوعة ستانفورد الفلسفية، homosexuality، https://plato.stanford.edu/entries/homosexuality/.
(2) عبدالإله محمد النوايسة، المثلية الجنسية الرضائية بين التحريم والإباحة، جامعة الإمارات العربية المتحدة – كلية القانون، مجلة الشريعة والقانون، ع37 ، ص258.
(3) موسوعة ستانفورد الفلسفية، homosexuality، https://plato.stanford.edu/entries/homosexuality/.
(4) أخرجه أبو داود (4462) والترمذي (1456) وابن ماجه (2561) وأحمد (2732).
(5) أبو عمرو الجاحظ، الرسائل الأدبية، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط2، 1423هـ. ص149.
(6) أبو حامد الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، دار الإرشاد، بغداد، 1971م. ص618.
(7) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1995م. 15/ 628 – 631.