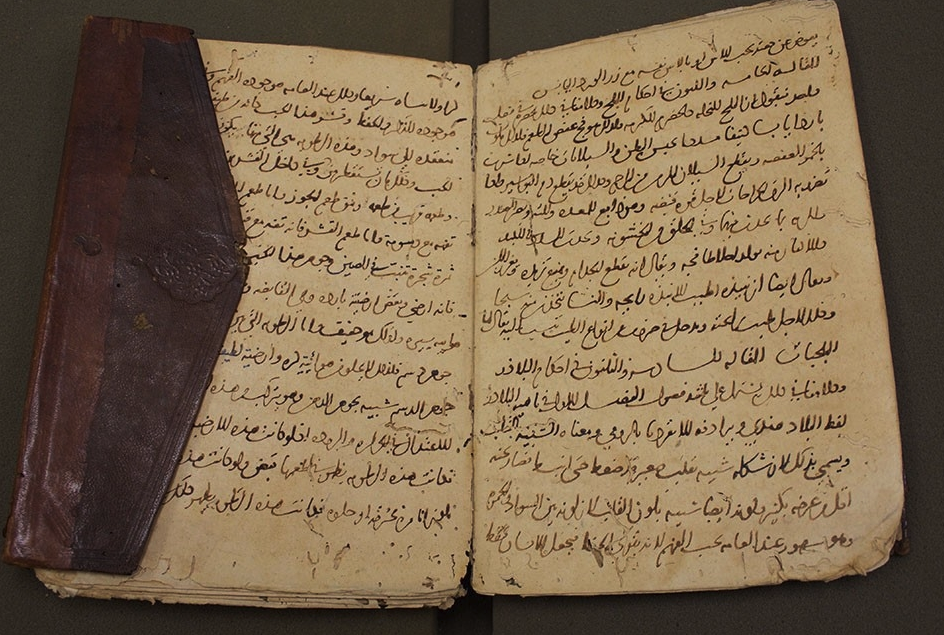المستقبل ملك لمن يستعد له، والعلم أحد المفاتيح الرئيسة للولوج إليه، والتعليم والتعلم هما أهم ركائز العلم؛ لذا فالنظر إلى التعليم ليس سؤالاً تخصصياً، ولكنه قضية مجتمعية كبرى يجب أن يتشارك الجميع للنهوض به، ومراجعة تجربة النهوض العربية في مطلع القرن الماضي تكشف أن التعليم استحوذ على جهود المصلحين، باعتباره مخرجاً من الركود الفكري والثقافي، ووسيلة للنهوض الحضاري، وأحد سبل مواجهة الاستعمار.
ومع ظهور دولة الاستقلال في أعقاب نهاية مرحلة الاستعمار المباشر، ارتفعت الآمال في التعليم، فصار مرادفاً للأمل والحراك الاجتماعي والصعود الوظيفي وتحسين المستوى الاقتصادي، لكن بعد مرور أكثر من سبعة عقود، لم يستطع التعليم أن يضع العرب في مصاف الدول الناهضة، فما زالت الغالبية العظمى من الجامعات العربية خارج التصنيف العالمي لأفضل الجامعات، وما زالت جهود التعليم في أغلب البلدان تكاد تنحصر في إزاحة أمية القراءة والكتابة، وإمداد الخريجيين بما يساعدهم في الالتحاق بالوظائف، أما البحث العلمي فهو دون المستوى.
وبعيداً عن البكائيات حول مستوى التعليم، أو رصد الحقائق والإحصاءات التي تكشف أزمته الهيكلية العميقة الجذور، فإن السؤال هو: كيفية استشراف مستقبل التعليم العربي، والعوائق التي تغلق آفاق المستقبل في وجهه، ومسؤولية السياسة عن مأزقه، باعتبار أن التعليم ما هو إلا رؤية سياسية في المقام الأول؟
فتش عن السياسة
في أغلب التجارب العالمية، السياسة هي مفتاح التعليم الناجح، وهي العائق الأكبر للتعليم، وقد حرصت السياسة في تجارب عربية أن تُبقي إرث النجاحات في التعليم محدودة، فلم تقترن الزيادة الكبيرة في الالتحاق بالتعليم الأساسي بوقف التسريب الدراسي، ولم تنجح في ربط التعليم بالتنمية.
ويلاحظ أن غالبية قرارات إصلاح التعليم قرارات فوقية، لم يشارك المجتمع في صناعة رؤيتها، فهي أوامر واجبة التنفيذ، والقرارات التي لا يشارك فيها المجتمع تواجه استعصاء في التنفيذ خاصة من الجهاز البيروقراطي، ولا تجد الحاضنة الشعبية المتبنية لها المؤمنة بها، ومن ناحية أخرى فإن بعض القرارات التعليمية الكبرى لم تأت لمعالجة مشكلات حقيقية، بل لم تنظر للمجتمع نفسه وتطوره وإمكاناته، لذا كان تأثيرها محدوداً للغاية، فتحت شعار الدخول للعصر الرقمي، تم إمداد مئات الآلاف من الطلاب بأجهزة لوحية، دون أن تكون هناك بنية قوية في مجال الاتصالات الرقمية لتغطية هذا الضغط الكبير على شبكة الاتصال، ودون إعداد كاف وحقيقي للمعلم، فكانت النتائج متواضعة، والاستجابات راكدة.
ومفهوم المشاركة في صوغ الرؤي والقرارات التعليمية مرتبط بالسياسة، فإذا كانت السياسة مُحتكرة من حفنة قليلة، ويغلب عليها النمط الاستبدادي النفعي، فمن غير المتوقع أن يكون التعليم قائماً على التشاركية، ومن ناحية أخرى تُدرك النخبة المحتكرة للقرار السياسي والاقتصادي أن إحداث ثورة في المجال التعليمي لن تتوقف نتائجها وآثارها عند حدود التعليم، أو أسوار الجامعة، ولكنها ستنعكس في حراك اجتماعي وسياسي واقتصادي، ورفع مستوى المطالب والضغوط السياسية، والنقد والمعارضة.
ليس ذلك فحسب، فمع ارتقاء التعليم يكون هناك طرح بدائل للرؤى والتوجهات السياسية، من النخبة المتعلمة الجديدة، ذات القدرات والعلاقات والمؤهلات، والقادرة أن تحُل مكان القديمة في مواقع السلطة؛ وهو ما يخلق مخاوف أمام إفساح المجال أمام تعليم حقيقي تعليم قادر على النهوض وفتح آفاق التنمية، وتوسيع الخيارات والفرص أمام المجتمع.
وأمام تلك المخاوف، تجد النخبة الحاكمة أن خصخصة التعليم من الأفضل إتاحتها للفئات القادرة على تحمل التكلفة، والمتوقع أن ترتبط بتلك النخبة مستقبلاً، ومن ثم تعيد النخبة المُمسكة بالسلطة إنتاج نفسها من جديد، وضمان استمرارها بطريقة أخرى، فبدلاً من أن تسمح للتعليم بأن يُوسع آفاق المشاركة بكافة أشكالها، فإن خصخصة التعليم تعيد إنتاج تلك النخبة بقيمها مرة أخرى، وهو ما يشكل أكبر إعاقة أمام إنشاء تعليم عصري وحديث وقادر على التناغم مع التطورات العلمية المتلاحقة في العالم، أما المجتمع فيجد نفسه أمام تعليم خاص مرتفع الكلفة، وتعليم حكومي منخفض الكلفة أو مجاني، لكنه لا يقدم شيئاً حقيقياً.
أما مسار البعثات التعليمية للخارج، فوصل في دولة عربية واحدة إلى أكثر من 93 ألف مبتعث على نفقة الدولة في عام واحد، بميزانية ضخمة، يزيد فيها راتب الفرد الواحد على ثلاثة آلاف دولار شهرياً، وفي دول أخرى تبلغ كلفة الفرد المبتعث 43 ألف دولار سنوياً، تتضاعف إذا كان متزوجاً، وهي ميزانية ضخمة للغاية، لو وُجهت لإنشاء جامعات حديثة لكانت الكلفة أقل، ورغم ذلك فإن هؤلاء لم يستطيعوا أن يغيروا شيئاً من مسار العملية التعليمية، وكان الأوفر حظاً منهم من التحق بوظيفة حكومية مرموقة؛ لذا لم تغير تجربة الابتعاث شيئاً في رفع الكفاءة التعليمية، ولم تستطع تلك المسارات أن تدمج التعليم في التنمية، لنجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى النقطة الفاصلة، وهي أن السياسة هي المسؤول الأول عن النهوض التعليمي.
أما البلدان العربية الفقيرة، فإن خصخصة التعليم لم تعن إلا تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية، وهو اتجاه متصاعد عربياً، خاصة مع تحول جزء كبير من النفقات المخصصة للتعليم إلى بنود مرتبطة بالأجور والإنشاءات، ولا تصب في رفع الكفاءة التعليمية؛ مما يفتح الباب أمام التسرب التعليمي المتزايد، الذي لا تعترض الحكومات طريقه.
أشعل النار أولاً
في عام 2018م، نشر مركز «كارنيجي» ورقة مهمة عن التعليم، ذكر فيها أن الأنظمة التعليمية العربية الحالية تعتمد على المؤشرات الكمية بدلاً من الجودة، وبالتالي تفشل في تحقيق هدف الإصلاح التعليمي، وأكد التقرير أن غالبية أنظمة التعليم العربية ليست مصممة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة.
والحقيقة أن دولاً في العالم مثل أمريكا اللاتينية قد تكون أقل في المستوى الاقتصادي من كثير من الدول العربية، لكنها استطاعت أن تُحدث ثغرات في السياسة، ومن خلالها نفذت إلى إصلاح التعليم، كما كان التعليم حاضراً في البرامج السياسية في الانتخابات بكافة مستوياتها، ونجحت تلك التجارب ألا تحول التعليم لمُنتج للاستبداد، وكانت الرؤية أن ضعف التعليم ناتج عن ضعف السياسة.
في كتاب «الاقتصاد السياسي للتعليم في العالم العربي» الذي حرره هشام العلوي، وروبرت سبرينغبورغ، الصادر عام 2021م، كان السؤال المطروح: إنه على الرغم من الإنفاق الكبير على التعليم، فإن جودة التعليم في غالبية البلدان العربية منخفضة، لماذا؟
وحسب الكتاب، فإنه يمكن العثور على الإجابة في الاقتصاد والسياسة الاستبدادية، فالنخب الحاكمة تحقق قوتها السياسية والاقتصادية على حساب الصالح العام، وفي مقدمتها مفهوم المواطنة، وأن الحديث أن عائق التعليم هو نقص التمويل أو سوء تخصيص هذا التمويل، والإفراط في المركزية، وضعف التعليم في المجالات التكنولوجية والعلمية، ليس صحيحاً بالكامل؛ لأن السياق الحاكم لهذا الضعف هو سياسي واقتصادي.
وتطرح تجارب تكشف أن عمق الإيمان بأهمية التعليم ودوره الإصلاحي من وسائل الإصلاح السياسي الكامنة، لأنه يعيد تشكيل قوى الحراك الاجتماعي، مع إبراز قيم جديد فاعلة داخل المجتمعات، وكما يقول غاندي: «تعلم كأنك ستعيش للأبد».
ونشير هنا إلى تجربة للنجاح والاستلهام، قد تفتح باباً الأمل، للمصلح البرزيلي باولو فريري الذي رفض أن يُنظر للتعليم كأنه «عملية مصرفية»؛ أي تُودع المعلومات في أذهان الأطفال والطلاب الفارغة ثم تنتظر عوائدها بعد حين، ولكن التعليم عملية تحرر للعقل، قائمة على التفاعل والقدرة على النقد؛ أي أن التعليم ممارسة للحرية، وعملية يكتشف بها الإنسان كيفية المشاركة في تغيير عالمه المحيط به، وعملية تغيير الشخص باستعادة إنسانيته؛ لذا، أكد دور الإنسان في تحرير نفسه وتحقيق خلاصه من خلال التعليم، ومن ثم لا يمكن فصل التعليم عن السياسة؛ لأن التعليم والتعلم هما فعل سياسي بالأساس، كما أن المعلمين يجلبون معهم إلى الفصل مفاهيم السياسة، وهو ما يؤكد أن المدخل لإصلاح التعليم هو إصلاح السياسة.
التعليم الحقيقي هو روح ثورية وتغييرية، قد يبدو للبعض أنها تسير ببطء، لكن الإيمان بالهدف هو ركيزة الوصول، وكما في نصيحة الفيلسوف اليوناني القديم بلوتارخ: العقل ليس إناء يجب ملؤه، بل نار يجب إشعالها.