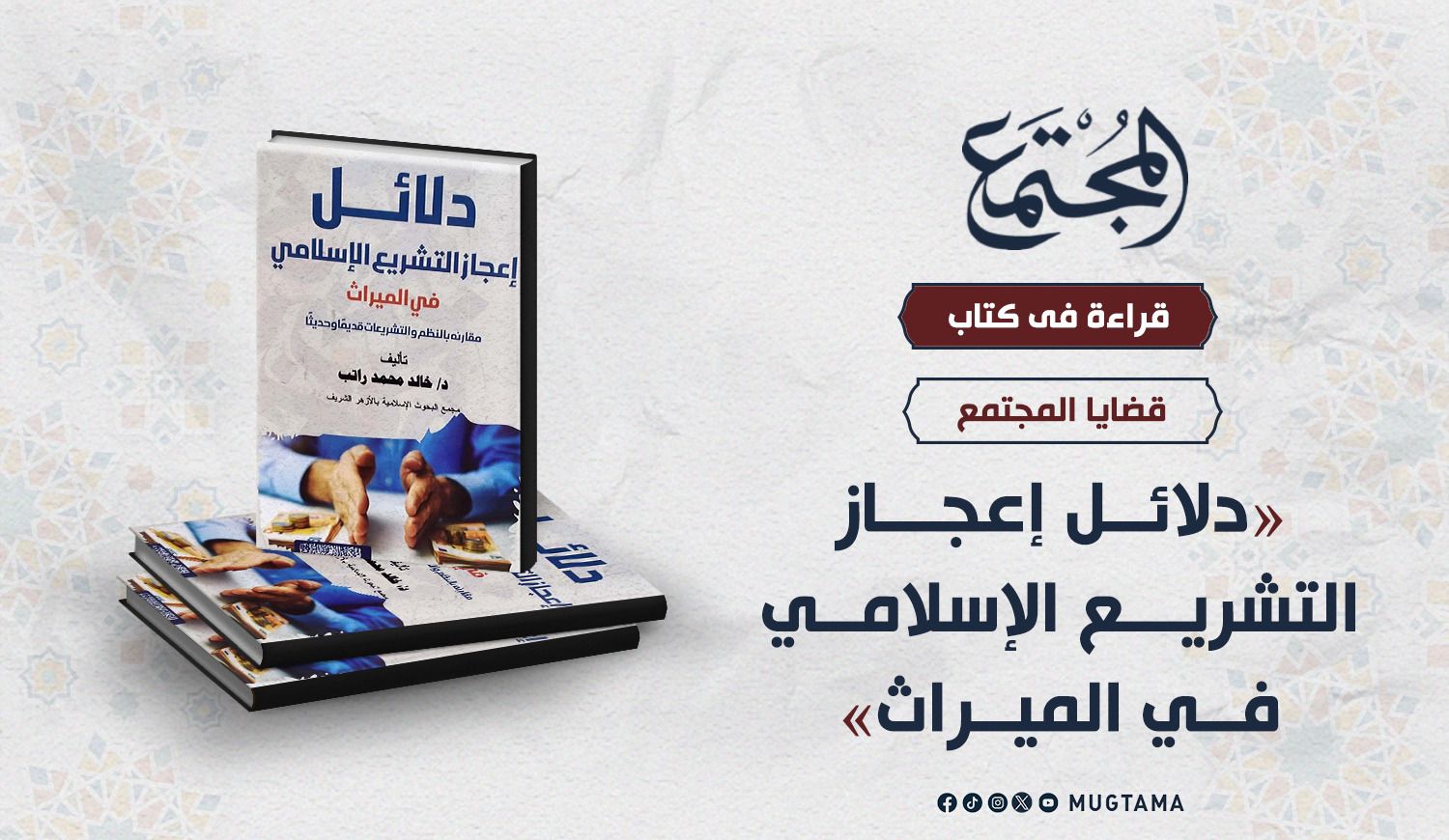كلمة «برستيج» (Prestige) فرنسية الأصل؛ وتعني المكانة الرفيعة، وقد شاع استخدامها كثيراً في المجتمعات العربية؛ للدلالة على علو المكانة، وارتفاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ربما في كثير من الأحيان على غير ما يخالف الواقع.
وتضاهي الكلمة الفرنسية معاني في القواميس العربية، مثل الهيئة أو الشكل أو الوضع، لذلك تجد من يستخدمها كمفردة أجنبية ضمن حديثه بالعربية أو العامية، قائلاً: إن «برستيجي لا يسمح لي بكذا»، و«برستيجي يفرض عليَّ فعل كذا».
وخلال العقود الأخيرة، انتشرت المفردة كالنار في الهشيم، لتصبح ذات دلالة على الوضع الاجتماعي، ومكانة الإنسان داخل مجتمع ما، بصرف النظر عن أخلاقه ومؤهلاته العلمية، ومدى موافقة أفعاله للكتاب والسُّنة، والقوانين النظامية.
زاد الهوس بالكلمة الفرنسية لتصبح نمط حياة، خاصة عند الأجيال الجديدة من الشباب والفتيات، وقد طالت مجالات مختلفة، من المظهر والملبس إلى الطعام والشراب، ومن مكان السكن إلى العمل إلى وجهة السفر، وغير ذلك، لتجد من يدعي قائلاً: «برستيجي لا يسمح لي بالعمل في وظيفة كذا»، بينما يحبذ أن يظل عاطلاً عالة على أهله، أو أن تجد امرأة تقول: «برستيجي لا يسمح لي بالزواج من فلان»، دون التزام بمعايير الشرع في ذلك، لتظل عانساً أو ضائعة في متاهات الحب والعشق الحرام.
ومن مظاهر «البرستيج» الدخيلة على مجتمعاتنا اعتبار ارتياد «المولات» والمراكز التجارية الكبرى، واقتناء «الماركات» و«البراندات» من مظاهر المكانة الرفيعة، خاصة بين النساء، والطبقات الثرية، التي تتباهى باقتناء ما تريد من أكبر المولات في العواصم العربية والأوروبية.
وهناك من لا يملك المال للتبضع من المولات الضخمة في بلده، لكنه يذهب بدافع التقليد والوجاهة، في محاولة للادعاء بأنه من مرتادي «مول» كذا وكذا، وأنه يهوى التسوق من المراكز التجارية الشهيرة، في محاولة لكسب مكانة زائفة.
هنا لا تتحقق المكانة الرفيعة، من خلال الالتزام بالأخلاق الحميدة والقيم العليا، أو نيل أرقى الشهادات العلمية، أو تحقيق إنجاز ما، والفوز بجائزة دولية، بل تتحقق تلك المكانة وفق المفهوم الجديد الشائع في مجتمعاتنا العربية والمسلمة، من خلال ارتياد «مول»، أو التبضع من مركز تجاري شهير، أو التسوق بفاتورة مالية باهظة.
تقول كونسيومر ريبورتس (منظمة أمريكية): إن المراكز التجارية تعد من أفضل 50 اختراعاً أحدثت ثورة في حياة المستهلك، وقد أحدثت تأثيراً في العالم كله، يتمثل هذا التأثير في أن نحو 60% من عمليات الشراء تحدث لمنتجات لم يكن الزبائن قد خططوا لشرائها، فيما يعد تغذية لنمط استهلاكي شره لا يعتد بقيم الاعتدال وعدم الإسراف والتبذير.
آثار سلبية
ما لا يدركه الكثيرون، أن هناك توجهاً عالمياً منذ عقود، لتغذية هذا النمط الاستهلاكي، وزيادة عناصر الإلهاء والجذب داخل المراكز التجارية، لتتحول إلى وجهة مفضلة للترفيه والسياحة، ومنصة لخدمات اقتصادية ومالية وفنية ورياضية، مع طرح عروض وفعاليات خاصة لاستقطاب عملائها، بما يجعل من «المول» حاضنة اجتماعية وثقافية، يتعاظم تأثيرها يوماً بعد الآخر.
ومع تمدد ثقافة «المول»، باتت مراكز التسوق أحد أبرز مكونات الفضاء الحضري، ومركزاً لجذب الناس على اختلاف الطبقات الاجتماعية، مع تطور دورها من التسوق إلى التسلية والترفيه ومشاهدة السينما والتزلج وتناول الطعام والتفاعل مع الآخرين، بحسب دراسة نشرتها مجلة «إي جي بي داتا ساينس».
وتعد منطقة الخليج على وجه الخصوص مركزاً للعديد من مراكز التسوق الكبرى، كونها وجهة مفضلة لشركات تجارة التجزئة العالمية، بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط، وطبيعة الإنفاق المرتفع في أوساط الأسر الخليجية.
تفيد دراسة حكومية حول أثر المستوى التعليمي والاجتماعي للأم على النمط الاستهلاكي للأسرة العمانية، بأن 57% من العينة ترجح أن النساء هن الأكثر استهلاكاً في المجتمع، ثم الأطفال، ويليهم الرجال، ويعود ذلك إلى ارتباط كثير من قرارات الاستهلاك الأسرية بها.
وتصنف مراكز التسوق كوجهة أولى ومفضلة للعائلات وأفراد المجتمع في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بعملية شراء المنتجات الغذائية والملابس والأجهزة الإلكترونية، حيث يفضل 88.7% من العائلات والأفراد شراء احتياجاتهم الشخصية من مراكز التسوق، كما أن 54.2% من الزوار هم من العائلات، و58.6% من الأفراد والأسر يفضلون الذهاب إلى مراكز التسوق في نهاية الأسبوع، و62.9% يقضون أقل من 3 ساعات في مراكز التسوق عند زيارتها، أسبوعياً أو شهرياً، بينما قال 33.3%: إنهم يقضون ما بين 3 إلى 5 ساعات، بينما يقضي 3.8% أكثر من 5 ساعات في مراكز التسوق، بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة «الخليج» الإماراتية، عام 2023م.
هذا الارتفاع في معدلات الإقبال على «المولات» خلق بلا شك ثقافة جديدة، تغذي هذا النمط من الوجاهة الزائفة، لدى أسر عديدة، التي قد تقترض مثلاً، أو تثقل كاهلها بأعباء مالية، نظير الزهو بأنها تتسوق من «مول» شهير، أو أنها قضت يوماً داخل مركز تسوق ضخم.
ويتعزز هذا التوجه البغيض بواسطة وسائل الإعلام والتواصل التي تستهدف تغذية واستثارة النساء تحديداً، باتجاه التقليد والمحاكاة، واتباع الموضة وصيحات التجميل، ومجاراة الصديقات وزميلات العمل، دون تشبث بقيمة أو دين.
وتتعدد التداعيات السلبية الناجمة عن تلك الوجاهة الزائفة، لعل أخطرها تلوث الشخصية بمعايير جديدة، تغض الطرف عن قيم العمل والإنتاج والتفوق العلمي، وبناء الشخصية، وتطوير الذات، واكتساب المهارات، والوقوع في أسر نمط استهلاكي؛ لكسب إحساس كاذب ومزيف بالارتقاء اجتماعياً واقتصادياً.
الأمر يزداد خطورة لدى الصغير والمراهق، فيقع ضحية للإصابة بأمراض نفسية واجتماعية، إما مشاعر من عدم الرضا عن حياته، وعدم القناعة بما توفره له أسرته، ومن ثم التمرد عليها، أو الاستسلام والرضوخ لشكل زائف من الوجاهة، واعتبار ذلك رقياً اجتماعياً، فيتنمر على أقرانه، ويسخر من الآخرين، أو إدمان هذا النمط الاستهلاكي، دون مقومات، فيلجأ للمال الحرام تحت إلحاح الرغبة في المحافظة على «البرستيج».
تقتضي الحكمة منا جميعاً تصحيح المفاهيم، وتصويب الفهم الخاطئ لـ«البرستيج»، وإعادة الاعتبار إلى الجوهر والمضمون، والتخلص من المظاهر الشكلية والاستهلاكية، والتمسك بالقيم والأخلاق، فهي أفضل «برستيج» لمن شاء أن يستقيم.