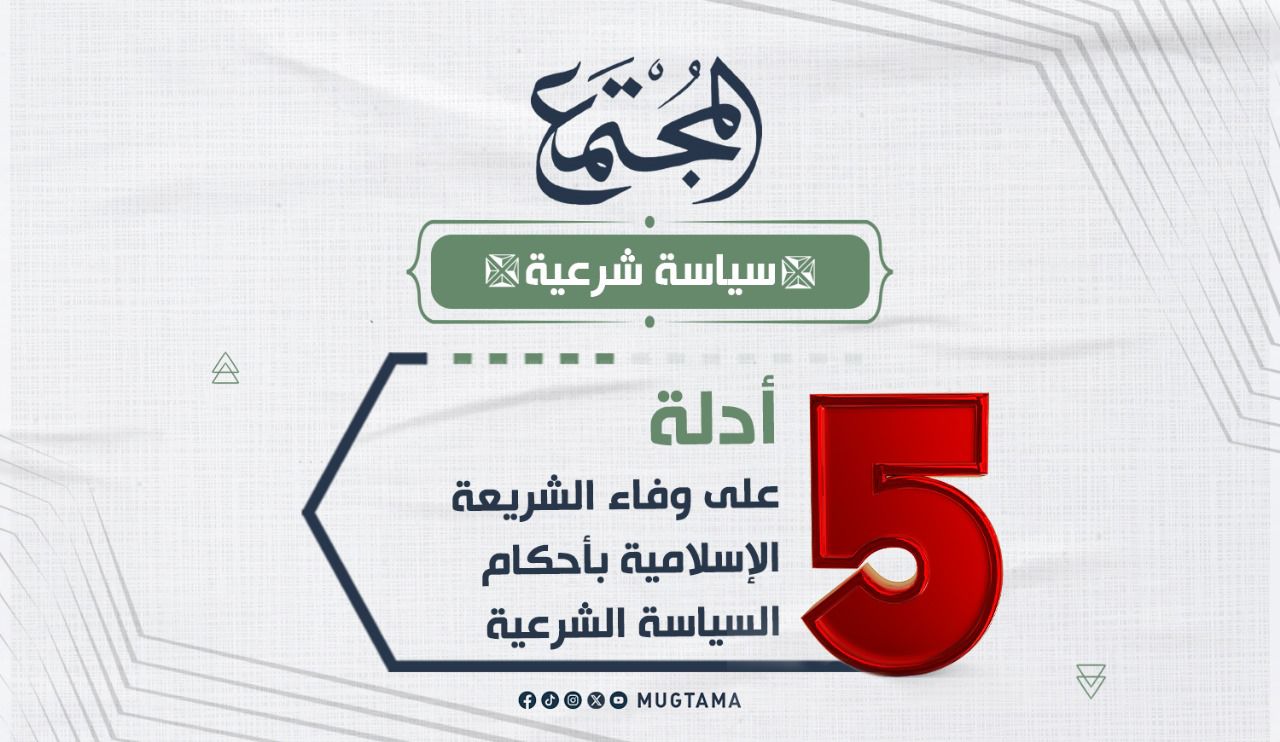ليست السياسة الشرعية في الإسلام أمراً هامشياً يمكن الاستغناء عنه والاتكال فيه على استيراد النظم الغربية أو الشرقية وتوظيفها في واقع حياة المسلمين، فإن الإسلام دين يشمل حياة الناس ويستوعب جميع شؤونهم، ولم يترك جانباً واحداً من الحياة دون بيان القواعد العامة والأحكام الضابطة له، التي تضمن حسن سيره وحمايته من الأخطار.
ولم يترك الإسلام الإنسان سدى، كمّاً مهملاً، لا يكلف بأمر أو نهي، ولا يبعث ولا يجازى، بل اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته أن يعينه بالهداية والإرشاد إلى ما يصلحه في دنياه وآخرته، على يد رسل اختارهم ليكونوا قدوة للناس، بما يحملونه من شرائع ونظم تسعد بها الأفراد والجماعات، كل رسول يحمل من التعاليم ما يصلح به عصره، ويعده لتعاليم رسول آخر يأتي من بعده، يقرر القواعد والأصول العامة التي سبقه بها صاحبه، التي لا تختلف باختلاف العصور وتبدل الأحوال؛ قال تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) (الشورى: 13).
ويجدد لهم الأحكام الجزئية التي تقتضيها حاجاتهم وتتطلبها أزمانهم، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) (المائدة: 48)،
وهكذا كان شأن الشرائع السماوية في تتابعها، حتى جاءت شريعة الإسلام، وكانت هي آخر الشرائع، ورسولها آخر المرسلين: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) (الأحزاب: 40)، فلا شريعة بعدها، ولا رسول بعد رسولها، ومن ثم وجب أن تكون وافية بجميع الأحكام التي تحتاج إليها الأمم والشعوب في تدبير شؤونها، وتنظيم حياتها، صالحة لمسايرة الحياة في تطورها، ومراحل تقدمها ورقيها، ودليل ذلك ما يلي(1):
1- قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (المائدة: 3)؛ إن الكمال والتمام يقتضيان الوفاء بجميع الأحكام الصالحة لإسعاد الأفراد والمجتمعات في جميع العصور والأحوال، وإلا انتفى التمام والكمال.
2- قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل: 89)؛ وليس معنى التبيان بيان حكم كل جزئية من الوقائع التي تحدث من وقت نزول التشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فإن الواقع والاستقراء يشهدان بأن القرآن -في الغالب- لم يتعرض لأحكام تلك الجزئيات، بل جاءت أحكامه قواعد عامة كلية صالحة للتطبيق في كل ما يعرض للناس في حياتهم اليومية، فهو تبيان لكل شيء، من حيث:
أ- أنه أحاط بجميع الأصول والقواعد التي لا بد منها في كل قانون ونظام، كوجوب العدل والشورى، ورفع الحرج، ودفع الضرر، وأداء الأمانات إلى أهلها، ورعاية الحقوق لأصحابها، والرجوع في مهام الأمور ومعضلاتها إلى أهل الذكر والاختصاص والخبرة، إلى غير ذلك من القواعد العامة التي لا يستطيع أن يشذ عنها قانون أو نظام يراد به صلاح الأمم وإسعادها.
ب- وهو تبيان لكل شيء من حيث إنه قد أحاط بأصول ما يلزم لحفظ المقاصد التي لم تأت الشرائع السماوية إلا لخدمتها والمحافظة عليها، وهذه هي المقاصد الخمسة أو الستة الكبرى، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والعرض، فقد جاء القرآن بأحكامها في قواعد كلية وعموميات شمولية، ومع ذلك لم يغفل تفصيل ما يراه في حاجة إلى تفصيل كأحكام المواريث والنكاح، والطلاق والنفقات.
3- قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وغيره: «تركتُ فيكم أمرين لن تضلُّوا بعدهما: كتابَ الله، وسُنَّةَ نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ»؛ فقد أفاد الحديث أن عدم الضلال والفلاح في التمسك بما جاء في الكتاب والسُّنة، وليس بعد الفلاح غاية لمستزيد في هذا الميدان، ومعنى هذا بوضوح كامل وفاء ما جاء في الكتاب والسُّنة من أحكام تحقق مصالح الأفراد والجماعات، وتلبي مطالب الحياة المتجددة التي تنفع الناس وتسعدهم في الدنيا والآخرة.
وبيان ذلك أن الكتاب جاء بالأحكام التي تحقق مصالح الأفراد والجماعات على الوجه الذي بيناه آنفاً، ولكن هذه الأحكام جاءت في الأعم الأغلب منها عموميات كلية، فجاءت السُّنة المطهرة تكمل هذه الأحكام وتوفيها حقها شرحاً وبياناً، وتعليلاً وتنظيراً، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله أحكام ما كان يعرض للناس من حوادث ووقائع تارة بالوحي، وتارة باجتهاده المسدد من قبل الله تعالى، فبين للناس أحكام علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الحاكم بالمحكومين، وعلاقة الإنسان بغيره في سائر المجالات من معاملات وجنايات وأحوال شخصية وغيرها، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي السلم والحرب، وبين حكم كل ما يعرض للإنسان في حياته، حتى أداب الأكل والشرب والتخلي والنوم وآداب السلام والرد والحديث، وما ينبغي أن يكون عليه في حالة الإقامة والسفر، والصحة والمرض، والغنى والفقر.
4- أن شريعة الإسلام شريعة عامة ودائمة؛ عامة في المرسل إليهم، تخاطب كل أصناف البشر، لا تخص فريقاً دون فريق، وعامة في المرسل به من أحكام ونظم، بمعنى أنه روعي فيها جميع حاجات الأمم في جميع العصور والأحوال، فوجب أن تكون وافية بهذه الحاجات في كل عصر وأمة، فإنها إذا لم تكن كذلك لكان أحد أمرين، إما أنها شذت عن الشرائع السماوية السابقة، فلا تعنى بمصالح الناس، ولا تراعي مطالبهم الدينية والدنيوية، وإما أنها ليست خاتمة الشرائع السماوية، وكلا الأمرين يتنافى مع نصوص القرآن، ويتناقض مع عقيدة الإسلام.
5- استقراء مصادر الشريعة الإسلامية يدلنا دلالة واضحة على ما يلي:
أ- أن ما جاء بهما من أحكام قد طرق أبواب الحياة وجميع مناهجها على وجه يكفل سلامة المقاصد الكبرى التي يقوم عليها أمر الدين والدنيا.
ب- أنهما أرشدا إلى استخدام المقاييس الشرعية بما جاء في نصوصهما من التعليل والتنظير وضرب الأمثال عندما يحتاج الأمر إلى هذه المقاييس.
جـ- أن النصوص الكثيرة الواردة فيهما تقرر أن الشريعة راعت في تكاليفها التخفيف عن الناس، ورفع الحرج عنهم، وأنها لم تقصد إلا إلى النفع ودفع الضرر، فأشارت بذلك إلى مبدأ استخدام المصالح المرسلة والاستحسان في الاجتهاد واستنباط الأحكام، كما أشارت إلى قاعدة سد الذرائع وتحكيم العرف وما تجري به عادة كل أمة إذا لم يؤدّ استخدامهما في الاجتهاد إلى مخالفة نص أو إجماع أو قياس.
د- كما جاءت نصوص القرآن والسُّنة فيما لا يختلف باختلاف الظروف والأحوال من الوقائع بمبادئ لا يصح الإخلال بها، مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة والأحوال، مثل مبادئ الشورى، والعدل، والمساواة، وغيرها، مما لا يقبل التغيير بحال، جاءت بها مبادئ عامة، وترك طريقة تنظيمها والأساليب التي تتحقق بها إلى أولي الأمر في كل أمة، حسب ما تقتضيه ظروف كل قوم ومصلحتهم.
وبهذا كله صح للشريعة الإسلامية -بفقهها وسياستها- أن تسع بأحكامها ونظامها مطالب الأمة وحاجاتها، واستقام لأولي الأمر أن يجدوا فيها قواعد وأصولاً يعتمدون عليها في سياسة الأمة وتدبير شؤونها، من غير أن يشعروا بوجود نقص فيها، يدفعهم إلى الاقتباس من قوانين غيرهم.
____________________
(1) المدخل إلى السياسة الشرعية: د. عبدالعال أحمد عطوة، ص 110.