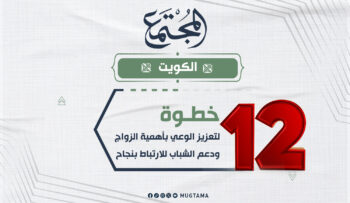أحياناً كنت أقطع الأميال سفراً بغير طعامٍ أو شراب حتى أستمع خطبةً له
كنت في السابعة عشرة من عمري حين سمعته أوّل مرة، لم أتمالك مشاعري من البكاء المُتَجاوِبِ مع إيقاعات صوته بينما كان يتغنَّى بقصيدة شعرية مُثيرة، اعتقدت يومها من فرط تأثُّرِهِ بأبياتها الملحونة أنها من إنشائه، وظللت على هذا الاعتقاد لِقلة اطلاعي حتى اكتشفت بعد ذلك أنها لشاعر!
أحياناً كنت أقطع الأميال سفراً بغير طعامٍ أو شراب حتى أستمع خطبةً له، فأفخر بها بين رفاقي، معتقداً التميز بحضورها عليهم، وكُنتُ إذا أُهديتُ ثوباً أو تصدّق به أحدٌ إشفاقاً عليَّ وإحساناً، عَمَدتُّ إلى قَصِّهِ وتقصيره، تشبُّهاً بالصالحين، مُطلِقاً لحيتي، مُتَّسِماً بالسمت الإسلامي؛ ذلك الذي كنت أعتقد أنَّ مِن ألزمِ لوازمه: أن أتأبّطَ مُجَلَّداً لا أكاد أنطق عنوانَه أو اسم مُؤلّفه – فضلاً عن محتواه – بطريقةٍ صحيحة! مع قلمٍ – بلا أوراق -يزيّنُ جيبي، ومسواكٍ لم أستفد منه على الوجه الأحسن في تطييب رائحةَ فمي.. لكنه حُبُّ السُّمعةِ حيناً، ومجاراة نُظَرائي حيناً، وقليلٌ من التأسِّي بِمَنْ وصفه الله تعالى في القرآنِ عظيمَ الأخلاق [ أحياناً أُخرى!
مع الوقت قادتني مشاعري إلى متابعة الشيخ، فكنت لا أتوانى عن حضور دروسه مهما بلغ بِيَ جهدُ السفر، ومهما تكبّدت مصاريفه وأنا الذي لا ألوي على شيء من مال.. كنت أستمتع بشغفٍ، وأتكلّف أحياناً التأثُّرَ والانفعال المُحَفِّزَ على البكاء، ذلك الذي كان يُشَجّع عليه موجات النحيب المُتَّسِقَةِ التي تتنامى إلى أسماعي فتغريني بالمشاركة حتى ولو لم أجد باعثاً حقيقياً ولا داعياً للبكاء، وعلى الرغم من انهماكي في التأوُّهِ والأنين لكنَّ شيئاً ما كان يعبث بقناعتي ووجدي، فيحول دون تأثُّرِي المخلص، لكنني كنت أتجاوز تلك الحال فلا أكترث أو ألتفت.
تماهيت مع تلك الإيقاعات الأخّاذة وذلك التيار الجاذب الذي يدغدغ المشاعر، ويلعب على وتر التواضعُ وخفضِ الجناح، ولين الجانب والصبر على الأذى، واحتمال المظالم واحتساب الأجر عند الله تعالى، رجاء المثوبة في الآخرة، وهكذا تربينا حيناً من الدهر على تلك الثقافة الاختفائية التي لم تزد إنساناً مثلي تقلَّبَ في ذل اليُتمِ والفقر والمسكنة إلا ذِلّةً وقلةَ حيلةٍ وانكساراً وانهزاماً.. لم أكن على وعيٍّ بالترسُّبات الكارثية لتلك الثقافة في وجداننا البريء ومآلاتها المُضِرَّةِ بإنسانية الإنسان!
كَرَّسَ من تكثيف هذا النمط الثقافي الذي يلبس لبوس الدين من حالتي النفسية والمزاجية الحائرة، ذلك النمط الذي بدا وكأنه لا يتسق مع روح الممانعة التي حرص الإسلام على غرسها في الضمير المؤمن صيانة له من الوهن والتراجع والانحطاط والخذلان، وضمانةً لحياته مُقبلاً مِقداماً، حُرّاً كريماً ذا نخوةٍ ومروءةٍ.
وقد كان ملحوظاً أن زادَت التقنيات الصوتية من تغلغل تلك الثقافة بين قطاعات المتدينين، وصار هذا اللون الثقافي محلّ تفضيل شعبي في سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب والمقاهي وعربات الباعة الجائلين في الأسواق والأماكن العامة.. صراخٌ يتعالى، ومقاطع صوتية مختلطة بإيقاعاتٌ مُؤثّرة، لا تكاد تفهم منها شيئاً سوى أنَّ الله تعالى يتربص بالإنسان ويترصده في كُلِّ خطوةٍ يخطوها، متحيّناً لحظات ضعفه من أجل الإيقاع به، وقد بدت الانطباعات تتخلق في وجدان العوام وكثير من المتدينين عن فكرة الألوهية التي ليس لديها إلا النار وسعيرها وزَقّومها وقيحها وصديدها، وشُجاعها الأقرع، حتى لقد قامت بهذه الوسائل علاقات مُشَوّهة بين الناس وربهم، علاقة قائمة على الرعب والهلع أكثر منها على الخوف والرجاء، علاقة إنسانٍ يَفِرُّ مِنْ ربِّه ومولاه لا أن يَفِرَّ إليه!
ولقد انسحب هذا الشعور من فضاء العلاقة مع الله تعالى إلى دنيا الناس بصورة تبعث في نفس أمثالي القلق وعدم الارتياح بل وبالضيق والنفور مِمّن حولي من رواد الشيخ.. إذْ بدوا لي كمخلوقاتٍ جبانةٍ عن التحفُّزِ، متحفِّظةً تَخْشَى من الإقدام حتى لا تقع في محظور! أولئك الذين كانت حياة كثير منهم تكشف عن سطحية التأثر الذي أثمر في المجمل عن تدين واه، وزُهد زائفٍ، وتقوى مغشوشة!
مع تصاعُدِ موجة المَدِّ الإسلامي بين قطاعات الشباب، كانت الظروف مواتية لتسويق الحالة الإسلامية في المجتمع على نحو مُغرِضٍ يخدم خصومها؛ إذْ كانت سيول أشرطة الكاسيت تمزج العقل المسلم دون تفطُّنٍ منه بِشُبَهِ ثقافة الإرجاء الحضاري تحت عناوين تزكية النفوس وترقيق القلوب، والزهد في الدنيا بحسبان المسلم في هذه الدنيا غريباً أو عابرَ سبيل، حينئذٍ لاح لي أنَّ الوعظ نوعٌ من المزايدات الرخيصة في سوقٍ لَغِطَةٍ أشبه ما يكون كلامُها بالحَقِّ الذي يُراد به باطل! لكنني لم أكن أجرؤ على مواجهة ذاتي بهذه الحقائق أو حتى أثير الكلام والنقاش حتى بين رفاق هذا الدرب، أولئك الذين لم يكن يجمعنا سوى محاضرات الشيخ ودروسه!
عند تعرُّفِي إليهم بِشَكلٍ جَيِّدٍ، لَمست في البعض القليل مِمَّنْ حولي الطيبة وحُسنَ النية والإخلاص للدعوة ولرجالاتها ودعاتها، بيد أنني لم أجد لغالبيتهم حَظاً من التعليم أو العلم، والبعض الآخر يفتقر لأدنى درجات الأدب والتربية أو اللياقة، إذْ كنت بين الحين والآخر ألتقط لفظاً بذيئاً عابراً في سياق دعاباتٍ مُعتادة، ومرة ألتقط طرفاً من حديث يلمز في بعضِ الدعاة الذين لم نسمع عنهم إلاّ الخير في حقلِ الدعوة، كانت همزات ولمزات بغير دليلٍ أو بينة، ولاسيما أنني أعرف بعض أولئك الدُّعاة عَنْ كثبٍ فما لمستُ فيهم ما يُقال عنهم! فكنت أتوقَّف أحياناً، وأحياناً أتجاوزُ ملتَفِتاً إلى ما يمكن أن ينفعني من قراءةٍ كُتَيّباتٍ أو متابعة دروس العلماء.. لكنني، على أية حالٍ، كنت أشعر بوخذات نفسية كانت تؤزّني بتأنيب وتوبيخٍ وسخرية، وحديث نفسٍ يتهمني بين حينٍ وآخر بالحمق والاستعجال بالمُضِيِّ في هذا الطريق بعاطفة الطفل الساذج أو المُراهق الذي لا يخلو سلوكه من الرعونة وقلة التدبر وسوء التدبير، مضى زمنٌ غيرُ قصيرٍ، جرت في بحر الحياة مياهٌ كثيــرةٌ؛ إذْ كبر الشيخ، وكَبرنا حوله، فَمِنّا مَنْ كَبرَ به، وَمنّا مَنْ كَبرَ معه، وَمَنْ كَبرَ عليه، وِمِنّا مَنْ حاد عن الطريق فاختار طريقاً آخر، فيما استرسل البعض الآخر مُضِيّاً في هذا الطريق صادقاً مخلصاً، منهم مَنْ أطفأ مصباح عقله ولم يزل يتبع الشيخ وهو أعمى، ومنا مَنْ صار انتهازِياً لم تُغَيِّر الدعوة من خِسّة طبعه وسوء تربيته في بيئة لا دين لها سوى المصالح، ولا دينونة إلا لحظوظ النفس وشهواتها، لكنَّ التأثير الأسوأ لتجربتنا جميعاً قد بدا على فئةٍ مِنّا وقد باتت – مع تحديات الحياة وشِدَّتها – تستمرئ الذل، وتستسيغ القهر، وتستعذب الهوان، وتتلذذ بالنكال، وتحتفي بالاستعباد، وتبارك الشمولية وتشارك الاستبداد.. تجربةٌ كانت أشبه بالملهاة.. لكنها دروس الحياة الآخرة والأولى!>