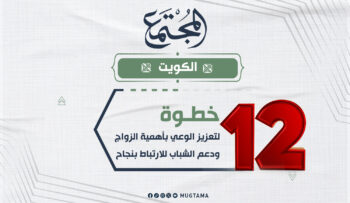كثير من الناس يتغنون بالديمقراطية، ويرون أنها حل لكثير من مشكلاتنا
كثير من الناس يتغنون بالديمقراطية، ويرون أنها حل لكثير من مشكلاتنا، في العمل السياسي، والأحكام السلطانية، وشكل إدارة الدولة، وأن أهم صورة من صورها، أنها تفرز القادة الذين يمثلون الشعب، وأهل الرأي الذين ينوبون عن الناس، في مجالس الشعب أو البرلمانات، أو البلديات، أو أي شكل من أشكال، ما لا بد من تمثيله، من خلال الانتخاب المباشر الحر النزيه.
لتمضي قافلة الحياة، على بساط من حرير، حيث الحقوق محفوظة، والواجبات معروفة، في جو من الحرية، تضاء فيها حياة البشر، من خلال قناديل حقوق الإنسان، حيث مدماكها الأصيل؛ ما يتجلى في قيم العدل!
ويعتبرون هذا من دواعي الاستقرار، ويمثل حالة ضرورة، لا بد من سلوكها، كوعاء عمل، وآلية توصل إلى التداول السلمي للسلطة، من خلال تعددية تعبر عن حالة إيجاب، في اختلاف التنوع الاجتهادي، بمعطيات دائرة الوطن وخصوصياته، لمزيد من الرأي والرأي الآخر، الذي يعمل على إثراء الحياة السياسية، ويسعى إلى ترسيخ قيم التداول السلمي، والتخلص من الاستبداد والدكتاتورية، بمزيد من الرؤى المفيدة، والإضاءات النافعة.
وحتى لو حدث اختلاف، فإنه حالة تعبير، عن جملة المعاني، التي تصب في النهاية، في الصالح العام، كما أنها تمثل صورة وردية من صور إنعاش الحياة العامة، بمثل هذا التداول والتنوع، وفي الأول والأخير، فإن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.
وفي فترة من الفترات، كان الجدل محتدماً، بين عشاق الديمقراطية، وأنصارها والمنافحين عنها، والمبشرين بخيرها، وبين بعض الإسلاميين، حول شرعية هذا الأمر، وكلاهما في طرف مناقض تماماً للآخر من حيث الرؤية والمنهج، وفهم المسألة والتأصيل لها، وبقي الأمر معلقاً لم يحسم الجدل فيه، بالنسبة للطرفين، وصار له ما بعده من أبعاد منتجة، خصوصاً من الإسلاميين، الذين لا يرون شرعية الديمقراطية، بكل معانيها، وسلالها كافة.
وجاءت النواتج لتؤكد، لهذا الفريق من الإسلاميين، أن “الديمقراطية” درب عقيمة، وطريق مغلقة، ينتهي إلى ما انتهت إليه بعض تجاربه المرة، ليقولوا: دعكم من السير وراء سرابها المخادع، فلن تجنوا منه، سوى الأفق الوردي، الذي يصنعه سحرة هياكلها بلغة معمدة بالتمويه والعبث، فمع كل صندوق اقتراع، تبنى زنزانة منفردة، ومع كل حالة انتخاب، تصنع أجهزة قمعية، توازي الحدث، فهي لم تولد فينا، ولا كانت منا، ولن تكون حلاً لما نصبو إليه من معالم الأمل الذي نرجوه، في عالمنا، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، والثمار الطيبة، لا تكون إلاّ عندما، تتحقق الشروط الموضوعية، للمسألة برمتها.
لكن أصحاب الفهم الوسطي، للإسلام، قبلوا بهذه الطريقة (الديمقراطية)، من خلال إشاعة المطلوب من قانون الحريات السياسية، والقبول بعملية القبول بصناديق الاقتراع، سبيلاً لفرز من يمثل الشعب، وطريقة من طرق الوصول إلى من يحكم، ولو في الإطار النسبي للقضية، ورغم كل ما يكتنف هذا من بعض جوانب النقص، وعوامل القصور، وتعاطوا معها بإيجابية، وراحوا يجعلون برامجهم السياسية، تتعامل مع قوانينها بواقعية، ودخلوا في كثير من الدول، لعبتها بحاملها القانوني، من خلال امتدادات شعبية، تطول أو تقصر، تتسع أو تضيق، من خلال البعد الواحد، أو الرؤية التحالفية، كل حسب ما يبدو له من اجتهاد، وما يقدر من مصلحة.
وأفرزت لهم نتائج مقبولة نسبياً، بالنسبة لهم ولخصومهم بآن واحد، علماً بأنهم يخفقون أحياناً، وينجحون في بعض الأحيان، بحكم أن هذه اللعبة، تحتاج إلى مراس ودربة وخبرة، ربما افتقدها بعضهم، في عالم الممارسة، لكنهم كانوا يقبلونها، ضمن قواعدها المعروفة.
ورغم التزوير الذي يحدث أحياناً، لم يخرجوا عن طور التعاطي معها، بصورة سلمية، كما هو الجاري عملاً، في مثل هذه الحالات، من طرائق التنافس، أو المحاكم، أو غير ذلك من الأشكال والصور.
ثم لما تطور الأمر، في التعاطي مع هذه “الديمقراطية”، حتى صار الإسلاميون يحصلون على نسب كبيرة، أو مريحة، في المجالس النيابية، أو غيرها، فإذا الدنيا تقوم، ولا تقعد، وتستنفر ولا تهدأ، ويقوم أنصار الديمقراطية وأحبابها!! بقلب الطاولة على رؤوس هؤلاء الذين حصلوا على هذه النسب العالية، بإرادة شعبية، وضمن القوانين التي ربما لهم ملاحظات كثيرة عليها، ولكن قبلوا التعاطي معها كما قلنا.
فإذا الديمقراطية لها وجه آخر، وتفسيرات ثانية، وقراءات متعددة، ونظرات متنوعة، ومفاهيم مطاطية، وصور تفصل على المقاس المطلوب، وبدل الرأي والرأي الآخر، يكون القمع، ويحل الانتقام، وبدلاً من احترام إرادة الناس، يتحول الأمر إلى شغب على العملية برمتها، والأصل أن يهنأ الفائز الأكثر بالمقاعد – كما هي أصول اللعبة – تفتح السجون أبوابها، ويكون الاستنفار الأمني، الذي يكثر فيه زوار الفجر، وتنتهك من خلاله حقوق الإنسان بكل أنواع الانتهاك، وتظلم الحياة من جديد – كعقاب – على هؤلاء الذين ما ذنبهم إلاّ أن الناس اختاروهم، ثم نفاجأ بمقولات وفلسفات وتقويمات مذهلة وغريبة ومدهشة.
حاكم عربي يقول: الديمقراطية لها أنياب، لم يرها الذين دخلوا لعبتها.
وفعلاً قامت هذه الديمقراطية، بعض المتعاملين معها، بأنيابها الحادة.
كاتب يوصف بالمفكر الكبير، يقول: الديمقراطية التي تأتي بالإسلاميين، لا نعرفها، ولا نتعامل معها.
ويقول آخر: نريد الديمقراطية، التي تأتي بالتنويريين، لا بالظلاميين.
وتشدق أديب!! من بعيد، فقال: الحرية، التي تنطلق من المساجد، لا نعترف بها، بل هي خطر على حياتنا السياسية.
إنه الكيل بالمكاييل المتعددة، والظلم الذي له وجوه متنوعة، والخداع الذي سيأتي على أصحابه بالويل الثبور (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ {227}) (الشعراء).
وحالة الخلل، لا تعود على الأصل بالإبطال، وتبقى الحرية أصلاً من أصول الخير، ومن الخطأ اليأس من مخرجاتها الإيجابية، وأن المنقلبين عليها هم وضع استثنائي، لا يمكن أن يستمر.