المُعلِّم.. من أيقونة إلى مادة للسخرية في الدراما العربية!
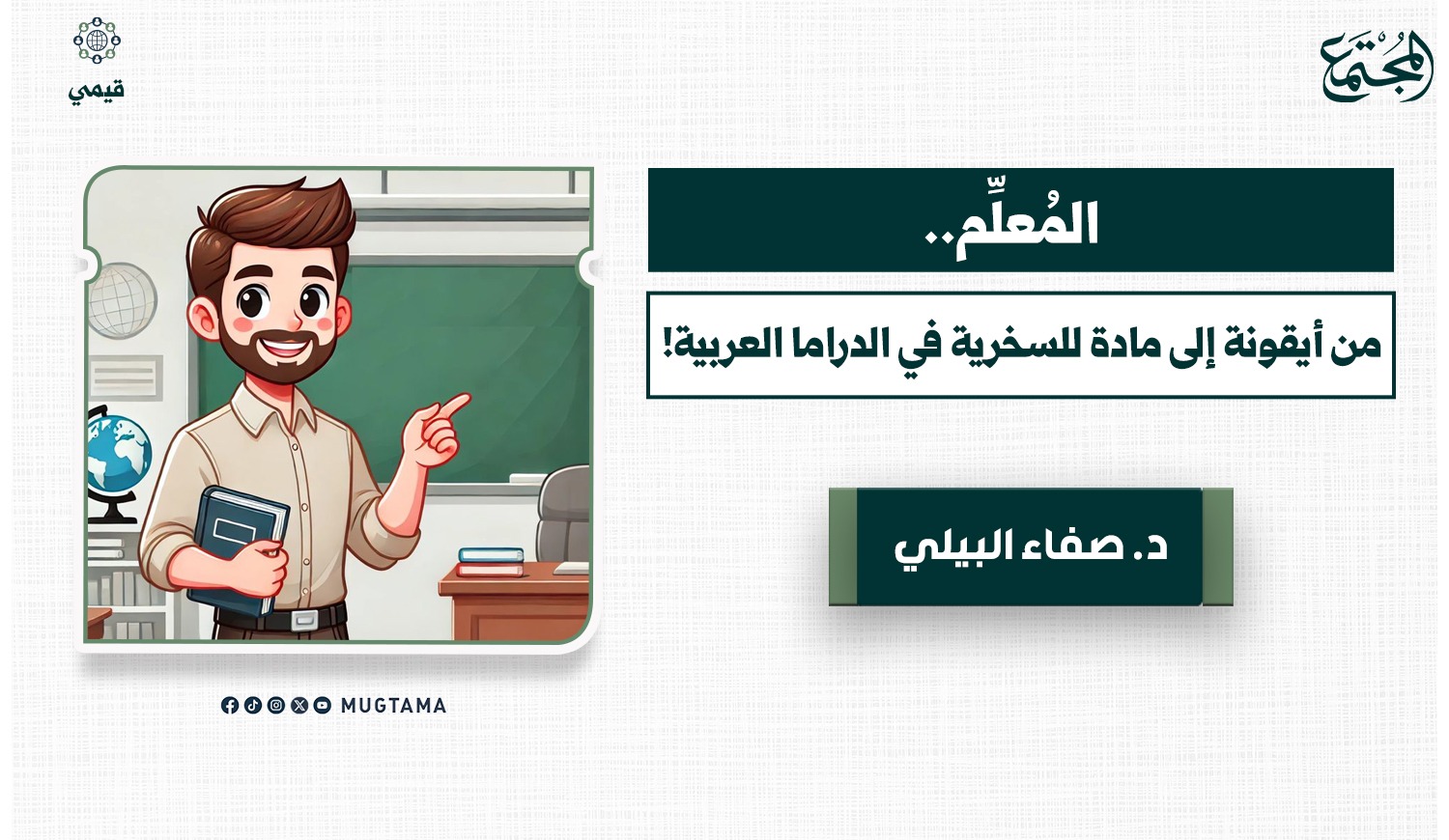
ما زالت صورة
معلمتي الأولى محفورة في ذاكرتي، راسخة في مكنون ذاتي، إنها حارسة حلمي الأول
ومهندسة حياتي بعد أمي؛ غرَست في أرضي البكر جمالاً إنسانياً، لم أدرك قيمته إلا
بعد سنوات طويلة من معاركة الحياة،
والدراما جزءً
لا يتجزأ من المنهل المعرفي للمجتمع؛ تأثيراً وتأثراً، ومن خلالها تجسدت شخصية
المعلم (في المسرح، والسينما، والتلفزيون) كرمز لذاكرة مجتمع بأكمله، والعجيب
أن صورة المعلم تجلت عبر خليط من مظاهر الإجلال الذي يصل إلى حد التقديس، والقلق
الذي يصل إلى حد الشفقة على كرامته.
ونحن عندما
نتطرق لرصد صورته في الدراما، نكون بصدد رصد نبض المجتمع وعلاقته بأغلى ما يمتلك،
من القيمة المعرفية التي هي جزء أصيل من تاريخنا وذاكرتنا الوجدانية، وتحوله إلى ضحية للنظام المادي بعد أن كان
النموذج الإنساني الأمثل الذي زرع فينا بذور الشغف.
ومع إيماننا
العميق بأن كل واحد منا يحمل بداخله فضلَ معلمٍ ترك بصمة لا يمكن أن تزول آثارها؛
كسنديانة القيم التي نحتمي بظلها، فإن ثمة سؤالاً يتردد: هل حافظت الدراما على هذه
الصورة النبيلة؟
المسرح.. انتقاد المؤسسة لا المعلم
على الرغم من أن
المسرح هو المجال الأكثر جرأة في طرح قضايا المجتمع، فإن قضايا التعليم والمعلم
كانت شحيحة على خشباته، ويكفينا المثال الصارخ لمسرحية «مدرسة المشاغبين» (مصر،
1971م) التي تجاوزت حد الكوميديا لتصبح نقطة تحوّلٍ مدوية في تاريخ الدراما
العربية، إذ شكلت زلزالاً اجتماعياً هزّ قداسة صورة المعلم، ممثلاً في «الأستاذة
عفت» سهير البابلي، في وضع الضعف الإنساني والعجز التربوي، التي لم تخسر المعركة
لقلة كفاءتها أو خبرتها، لكنها سُحقت نفسياً أمام تمرد الطلاب الذين رمزوا إلى جيل
فقَدَ الثقة بالسلطة بعد نكسة عام 1967م.
كما لم تستهدف
نقد صورة المعلم بقدر ما استهدفت المؤسسة التعليمية وكشف هشاشة البنية التربوية، إلا
إنها وللأسف أسست لنهاية زمن الإجلال والتوقير المطلق للمعلم، وفتحت المجال أمام
أعمال لاحقة ومزيد من النقد الهدّام، كما ساهمت في انزياح دلالة لقب «المُعلم»
(بضم الميم) في الوعي الشعبي كونه حاملاً للرسالة إلى «المِعلم» (بكسرها) للدلالة
على الشخصية النافذة المسيطرة في عالم المال والتجارة.
لتأتي بعد فترة
طويلة مسرحية «المدرسين والدروس الخصوصية» (مصر، 2002م)، لتعالج ظاهرة الدروس
الخصوصية.
السينما.. التحول من الرمزية الإنسانية للسخرية
في سياق آخر،
نجحت السينما المصرية في تكثيف الرمزية الإنسانية والاجتماعية لشخصية المعلم،
مستعرضة تحولاً طبقياً وقيمياً واسعاً نلمسه تدريجياً بداية من النموذج الكلاسيكي
الذي رسخته الأفلام القديمة حيث الكرامة التي تتجاوز قسوة الفقر والحاجة، في شخصية
«الأستاذ حمام» في فيلم «غزل البنات» (مصر، 1949م) لنجيب الريحاني؛ الذي احتفظ
بكرامته رغم فقره، واستمر هذا الإجلال الأخلاقي مع «الأستاذ فرجاني» نور الشريف في
فيلم «آخر الرجال المحترمين» (مصر، 1984م)، الذي مثَّل الحارس الأخلاقي للقيم
والمبادئ في زمن تراجع فيه النبل!
ومع مرور
السنوات، بدأت السينما في طرح النموذج الساخر أو فلنقل «المهلهل» الذي يعكس ضغوط
الحياة القاسية، حيث تحوّلت شخصية المعلم الإنسانية التربوية إلى شخصية «أنوية
مادية» تركز على الدروس الخصوصية، في نقد صريح لتحوّل المهنة من رسالة سامية إلى
مصدر رزق شحيح يُتكالب عليه، ولعل هذه النظرة بلغت ذروتها حينما صورته عبر نماذج
مسحوقة، في فيلم «الشقة من حق الزوجة» (مصر، 1985م)، ليظهر «الأستاذ عبدالرحمن» جورج
سيدهم غول الدروس الخصوصية في شقته الضيقة، كشخصية مادية حوّلت رسالتها إلى تجارة.
أما ذروة
المأساة، فتجسدت في فيلم «البيضة والحجر» (مصر، 1990م)، حين قام أحمد زكي «مستطاع»،
مدرس الفلسفة الذي يكتشف أن المنطق والقيم لا يكفلان له قوت يومه، فيتحول تدريجياً
إلى دجالٍ ومشَعْوِذ باسم «الشيخ مستطاع» فيحقق النفوذ المادي الذي عجز عن تحقيقه
بكرامة مهنته، هذا التحول الصادم من حامل لواء التنوير إلى خادم للشعوذة هو أقصى
درجات النقد الدرامي لواقعٍ حوّل قيمة المعرفة إلى سلعة كاسدة وتجسيداً لصورة
المعلم في أوج يأسه!
في مطلع القرن
الحادي والعشرين، استمرت السينما في رصد هشاشة الصورة وفقدان السيطرة على أدبياتها،
فقدم فيلم «الناظر» (مصر، 2000م) لعلاء ولي الدين، رؤية ساخرة لواقع المعلم،
وأظهره بصورة كاريكاتيرية، كشخصية «ميس إنشراح»، التي تحوّل اهتمامها إلى البحث عن
الزواج متناسية رسالتها التربوية؛ ما جعلها مادة للفكاهة المُرة وهو ما يسمى بـ«الكوميديا
السوداء» لتصوير المعلم كشخصية خاوية.
وهناك فيلم «درس
خصوصي» (مصر، 2005م)، قدم بعداً كوميدياً اعتمد فيه على صدمة الأجيال وتغيُّر
القيم من جيل لجيل، والصدام بين قيم الماضي وتحديات الحاضر، باعثاً تساؤلات عميقة
حول التغير القيمي لدى الأجيال.
كذلك فيلم «رمضان
مبروك أبو العلمين حمودة» (مصر، 2008م) كنموذج للكوميديا الساخرة القائمة على
المبالغة في الانضباط، ليصبح انضباط رمضان مبروك مادة للضحك والإهانة في مدارس
الأثرياء ما يثير الشفقة والرثاء!
الدراما التلفزيونية.. التفاصيل اليومية
على مستوى آخر،
سمحت المسلسلات التلفزيونية بتناول الصراع اليومي للمعلم بعمق أكثر، فرصدت تفاصيل
حياته اليومية التي تزامنت مع تدهور وضع الطبقة الوسطى، ففي أواخر السبعينيات، رصد
مسلسل «إلى أبي وأمي مع التحية» (الكويت، 1979م) صورة المعلم حيث الاحترام المطلق،
ثم مسلسل «درس خصوصي» (الكويت، 1981م) لحياة الفهد، مستخدماً أجواء الدروس
الخصوصية لخلق مفارقات اجتماعية ساخرة، حيث تتشابك القضايا الشخصية والاجتماعية مع
بيئة التعليم في قالب فكاهي ساخر، مع ملاحظة أن السخرية أصبحت أداة درامية قاتلة
لتصوير فقدان هيبة المعلم!
وفي المرحلة
الأكثر حداثة، أظهر مسلسل «بنات الثانوية» (الكويت، 2011م) ضعف سلطة المعلم أمام
تسلط أولياء الأمور الأثرياء، كما وجه مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» (الأردن، 2021م)
النقد إلى فشل السلطة التربوية المتمثلة في المعلم في احتواء أزمة التنمر،
والانتقام بين الطالبات.
مع ذلك، فإن
الواقع المؤلم الذي رصدناه لم ينجح في محو النماذج المضيئة لصورة المعلم، التي
أظهرته في أعمال استثنائية على حقيقته، متمسكًا برسالة التنوير دون الانزلاق إلى
مستنقع المادية، من هذه النماذج مسلسل «ضمير أبلة حكمت» (مصر، 1991م) قدمت فاتن
حمامة نموذجاً للمعلم الفاضل المستميت على محاربة الفساد الإداري، كذلك «امرأة من
زمن الحب» (مصر، 1998م)، لسميرة أحمد التي قدمت المُعلمة القوية الحكيمة.
ومسلسل «حضرة
المتهم أبي» (مصر، 2006م)، الذي ارتدى خلاله نور الشريف ثوب «الأستاذ عبدالحميد»،
معلم اللغة العربية متوسط الحال الذي يكافح لتعليم أبنائه القيم والأخلاق، ليقدم
نموذجاً للنبل والأخلاق، بالإضافة إلى مسلسل «أبله نورة» (الكويت، 2008م) لحياة
الفهد الذي أظهر المعلمة وهي تجاهد للحفاظ على القيم أمام تغيرات المجتمع، فيما
قدم جمال سليمان شخصية الناظر المحترم في مسلسل «قصة حب» (مصر، 2010م).
ولعل الأمر
الأكثر ألمًا في هذا التطواف التحول القاسي لدور المعلم؛ إذ تعرضُ الدراما اليوم
واقعاً جديداً صار فيه النفوذ والقوة شديدي الصلة بالمال والسوق، فتحوّل صراعه من
أجل التنوير إلى صراع من أجل البقاء، فتآكلت صورته الرمزية وتراجعت مكانته في
ذاكرة ووجدان الوعي الجمعي، ليهبط من مقام الرسول المبجّل إلى مرارة الواقع وقسوة
العيش.
وتبقى تساؤلاتنا: هل سيستمر الفن في تقديم المعلم كضحية اقتصادية وحسب، أم أنه سيبحث عن نموذج جديد قادر على استعادة هيبته وتأثيره في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي تغولت؟ وهل يمكن للفن أن يساهم في بناء جسر إنساني قوي يعيد القيمة الروحية للمعلم دون أن يتجاهل واقعه الاقتصادي الصعب؟
اقرأ
أيضاً:
صورة رجل الدين
في الدراما والسينما العربية

















