أنفاس الوحي (2)
قصة نوح وابنه والطوفان.. تحليل لمشهد «المسافة الصفرية» في القرآن
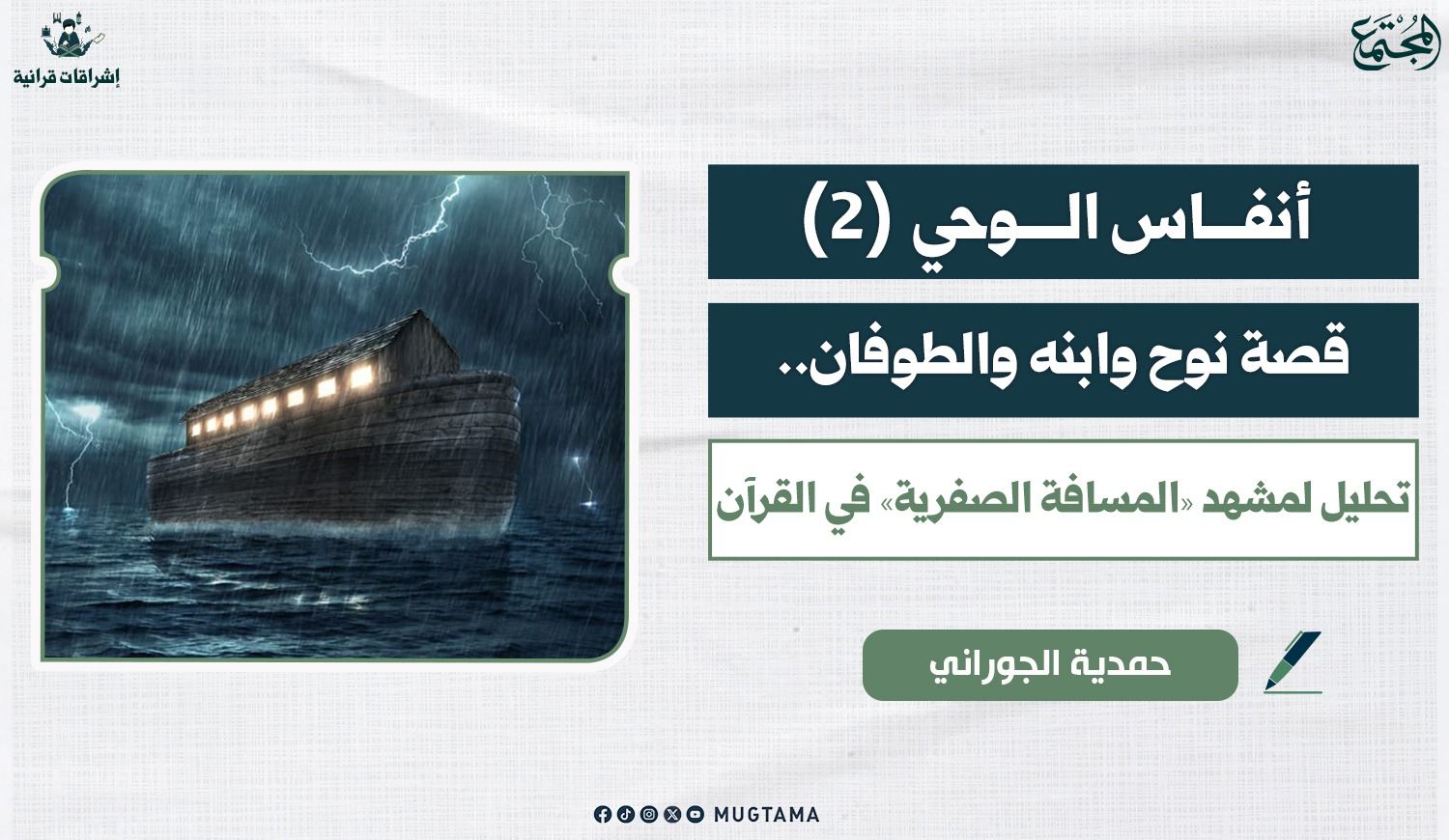
يطالعنا التعبير القرآني في سورة (هود) بمشهد إنساني يهزّ القلب، حين نادى نبي الله نوح ابنه من قلب السفينة، بينما العاصفة تبتلع اليابسة، في صورة تتجاوز حدود الزمان والمكان:
)وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۚ
وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا
تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ
الْمَاءِ. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ.
وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) (هود)
في هذا المشهد الموجز العظيم، تتجلى ذروة
التراجيديا الإنسانية في أصفى صورها القرآنية، حين تتلامس الأصوات بين نداء أبٍ
نبيٍّ يفيض رحمةً، واستعلاء ابنٍ غارق في غواية الأمان الكاذب. إننا أمام لحظة
تختصر المسافة بين الإيمان والكفر، بين النجاة والهلاك، وبين الرحمة والعناد، حتى
تصير تلك المسافة — على قصرها — مسافة صفرية، لكنها مفصولة بـطوفانٍ لا يُجيد سوى
أن يفصل بين الأرواح، كما يفصل الماء بين اليابستين.
تبدأ النفس النبوية بنداءٍ يقطر حنوّاً:
«يَا بُنَيَّ» تصغيرٌ يفتح أفق العاطفة، ويعيد الابن إلى حِضن الطفولة، حيث ما
زالت رحمة الأب تتقدّم على نبوّته، في هذا النداء تنكشف مفارقة المشاعر والوظيفة:
فنوح عليه السلام هنا ليس نبيًّا يخاطب كافرًا فحسب، بل أبًا يخاطب قطعة من روحه، نغمة
النداء تكشف انكسارًا داخليًا مكتومًا، إذ تتقاطع في النفس شعلة الأمل ووجع
اليقين.
ثم يردّ الابن، لا بعنادٍ صريح، بل بعقلٍ
منطقيٍّ مشوبٍ بالغرور: (سَآوِي
إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ).
إنه منطق الإنسان الذي يؤمن بالمادة ولا
يرى ما وراءها، عقلٌ يراهن على المرتفع الأرضي لينجو من الغرق السماوي، هنا تتجلّى
المعضلة النفسية الكبرى؛ إنه لا يرفض أباه فقط، بل يرفض نظام الكون كله الذي يقوم
على الطاعة لأمر الله، إنه لا يعاند العبد بل يعاند المعبود.
عند حدود الإيمان تنتهي الأبوة، وتتقدم
النبوة، ويأتي الرد في نبرة تقطع الأمل وتكشف الحتمية: (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن
رَّحِمَ)؛ إنها لغة النبوءة بعد انكسار العاطفة، لقد غلبت الحقيقة الرحمة،
وغلب القضاء النداء، في هذه الجملة يتجلى التسليم المطلق، والوعي بأن الرحمات لا
توهب إلا بإذن الله، لا تُكتسب بالعلو المادي، بل بالانقياد الروحي.
لكن المشهد لا يُختتم بالقول بل بالفعل: (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ)؛
يا لها من لحظة فاصلة! الموج هنا ليس مجرد ماء، وإنما قدرٌ مادي يجسّد الفصل
النفسي بين عالمين؛ عالم الإيمان، وعالم الغرور، وكأن الكون نفسه تدخل ليحسم ما
عجز النداء عن حسمه.
التحليل البلاغي
النداء العاطفي: «يَا بُنَيَّ» تركيب
ينطوي على تصغير وتحنّن وتفجع، ويشكّل مدخلًا وجدانيًّا يُهيّئ القارئ لاستقبال
صدامٍ بين الحنان والرفض.
المقابلة البلاغية: بين قول الأب: اركب معنا، وقول الابن: سآوي إلى جبلٍ يعصمني، الأولى دعوة إلى المعية والنجاة،
والثانية انفرادٌ بالذات واستغناء عن الجماعة، وهو تصوير بلاغي لفلسفة الكفر التي
تفصل الإنسان عن وحدة الوجود، ثم هنالك تقابل آخر، بين معية المؤمنين «معنا»،
ومعية الكافرين، كأنه يحدد الخيارات، فالموقف لا يحتمل الخوض في تفصيلات أخرى: إما
معية الله أو معية إبليس، التي يجسدها ما يحمله الابن من غرور وثقة عمياء بالوهم.
الإيجاز المكثّف: الجمل القصيرة
المتتابعة تشحن المشهد بطاقة توترية عالية:
- «ولا تكن مع الكافرين»: أمرٌ يحمل
تهديدًا مبطّنًا.
- «سآوي»: حرف السين يشي بأملٍ مؤجلٍ،
وكأن الابن يراهن على الزمن، بينما القدر على وشك أن يُغلق الساعة.
- التذييل المهيمن: «إِلَّا مَن رَّحِمَ»:
ذروة البلاغة في الحصر؛ حيث يُغلق كل الأبواب إلا باب الرحمة، ليُبقي الأمل في
السماء لا في الجبل.
- الختام المفاجئ: «فَكَانَ مِنَ
الْمُغْرَقِينَ»: تعبير يترك المشهد مفتوحًا على الوجدان، بلا تفاصيل، فالإيجاز
هنا هو الرصاصة البلاغية الأخيرة التي تحسم المأساة دون أن تُطيل النحيب، وكأن
المشهد يتراءى أمام المتلقي في «برومو» لدراما يتخيلها العقل، وترسمها التصورات.
التحليل الأسلوبي
الأسلوب في هذه الآيات ينتقل من الخطاب
الوجداني إلى الخطاب القدري، ثم إلى الصمت الكوني الذي يعبّر عنه الفعل «حال
بينهما الموج».
يبدأ بنداء إنساني ناعم (أسلوب إنشائي
طلبي)، ويمر بـحوار عقلي (أسلوب خبري مفعم بالتبرير)، وينتهي بـقدرٍ حتميٍّ يقطع
الكلام بالفعل (أسلوب فعلي قاطع)، إنه تصاعد أسلوبي من الصوت المتوتر إلى الصمت،
من الحوار إلى الفعل، من الرجاء إلى الفناء.
المسافة الصفرية
لماذا كانت المسافة الصفرية هي العتبة
النصية للقراءة؟
المسافة الصفرية لا تشير إلى قربٍ
مكانيٍّ فحسب، بل إلى قربٍ نفسيٍّ وروحيٍّ لم يُثمر اتصالًا، كانا قريبين جسدًا بين
سفينةٍ وجبلٍ، لكن المسافة الإيمانية كانت شاسعة، حين حال الموج بينهما، لم يفصل
ماء عن ماء، بل فصل إيمانًا عن كفر، كانت تلك اللحظة تصفيرًا للمسافة بين نداء
الأب وصمت القدر، حيث انتهى الكلام وبدأ الغرق.
في نهاية هذا المشهد، يسدل التعبير
القرآني الستار لا على الغرق المائي، بل على مأساة الانفصال الوجودي بين الرحمة
والغرور، تذوب العاطفة في الموج، ويختنق النداء في الصمت، لتبقى رسالة الآية
خالدة: إن المسافة بين الهداية والضلال ليست في الأمتار، بل في الانقياد القلبي.
فكم من قريبٍ مكانًا، بعيدٍ روحًا، وكم
من راكبٍ في السفينة، ما زال يظن أن الجبل يعصمه من أمر الله.
مفارقات المشهد
أب يُنادي ابنه إلى طريق النجاة، لا من
الغرق فقط، بل من الكفر، وابن يرفض النداء، ظنًا أن قوته، أو ما يعرفه، سيكفيه، وانفصال
بين جيلين، بين العقل والبصيرة، بين الطاعة والغرور، ثم: «فحال بينهما الموج»؛
نهاية الصلة، ليس فقط بالموت، بل بعدم الفهم.
المسافة الصفرية وطوفان اليوم
في واقعنا المعاصر، يمكن أن نرى هذا
المشهد يتكرر بأشكال عديدة، لا على ظهر سفينة، ولا عند جبل، بل في البيوت، في
الجامعات، على شاشات الهواتف.
الأب المعاصر قد لا يكون نبيًا، لكنّه
يحمل عبء التجربة، ومرارة السنين، ومحاولة توجيه الأبناء في بحرٍ لا يقل خطورة عن
طوفان نوح؛ بحر من الفتن، من الإعلام الموجّه، من الاغتراب الروحي، من الاندفاع
خلف السراب.
والابن المعاصر ليس بالضرورة كافرًا
بمعناه العقدي، لكنه أحيانًا جاحد بالحكمة، متمرد على البوصلة الأخلاقية، يرفض الركوب
في سفينة القيم، ويرى خلاصه في جبال وهمية؛ الشهرة، والمال السريع، والهجرة
العشوائية، أو مفاهيم زائفة عن الحرية.
أصوات الآباء، والمعلمين، والمرشدين،
والمثقفين، ما زالت تُردد نفس النداء: عُد إلى المعنى، تمسك بالقيم، لا تترك نفسك
للموج، لكن الموج، هذه المرة، ليس ماديًا، بل نفسياً، إعلامياً، ثقافياً.
المسافة الصفرية بين الأمس واليوم
الأب يعرف، لكن الابن لا يصدق، والغرق في
النهاية لا يكون فقط غرقًا جسديًا، بل روحيًا أو أخلاقيًا، والحب لا يكفي وحده
لإنقاذ من لا يريد النجاة.
ولكن الاختلافات: نوح كان يتحدث بأمر
إلهي، أما آباء اليوم فيخاطبون بأصوات بشرية، تُغرقها ضوضاء العصر، والطوفان كان
ظاهريًا، بينما طوفان اليوم باطني، صامت، لكنه أشد فتكًا، والابن في قصة نوح رفض
النداء بثقة في الطبيعة (الجبل)، أما اليوم فالرفض نابع من ثقة زائفة في الحداثة
أو الذات.
قصة نوح وابنه مرآة مستمرة لمأساة متكررة؛
حين تفصل الفجوة بين الجيل الذي يرى العاصفة قادمة، والجيل الذي يراها مجرّد مطرة
صيف، في النهاية، ما زالت السفينة تُبنى، ربما لا من خشب، بل من وعي، من تربية، من
حوار، من محاولة دائمة لتقليص المسافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!















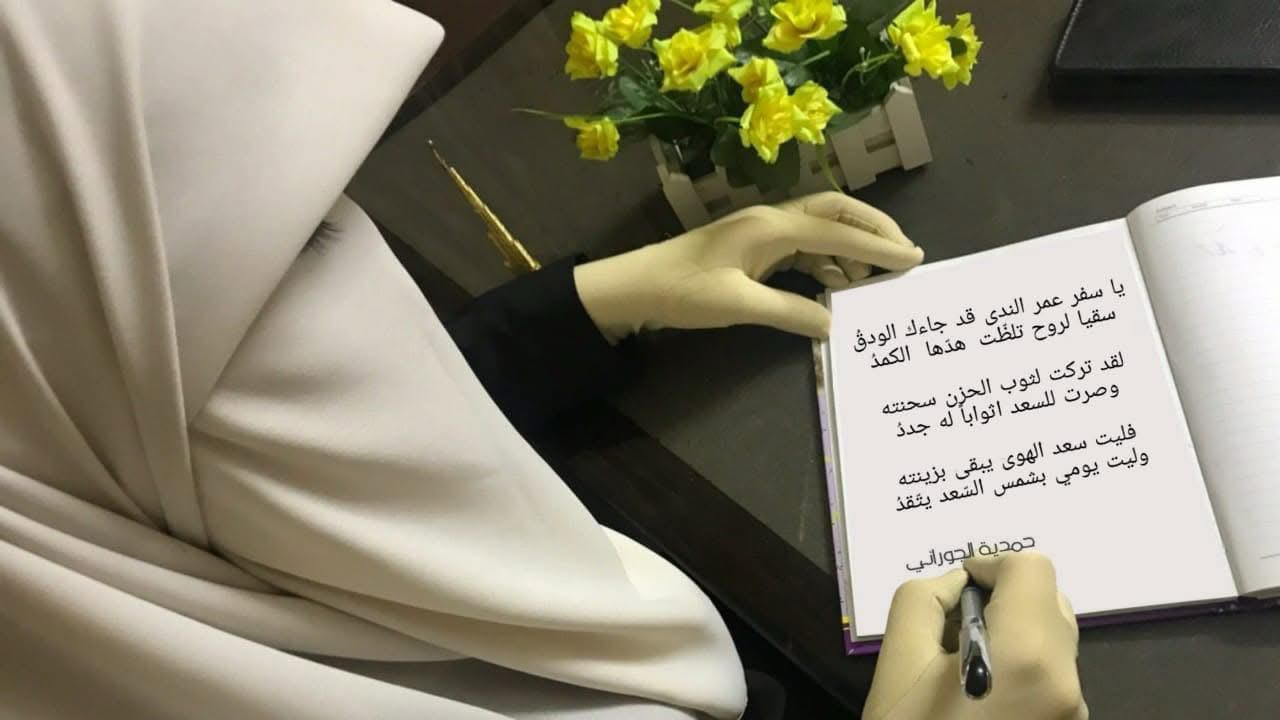


اترك تعليقاً