أيهما أهم في غزة.. الخطاب التعبوي الإيماني أم المادي الواقعي؟
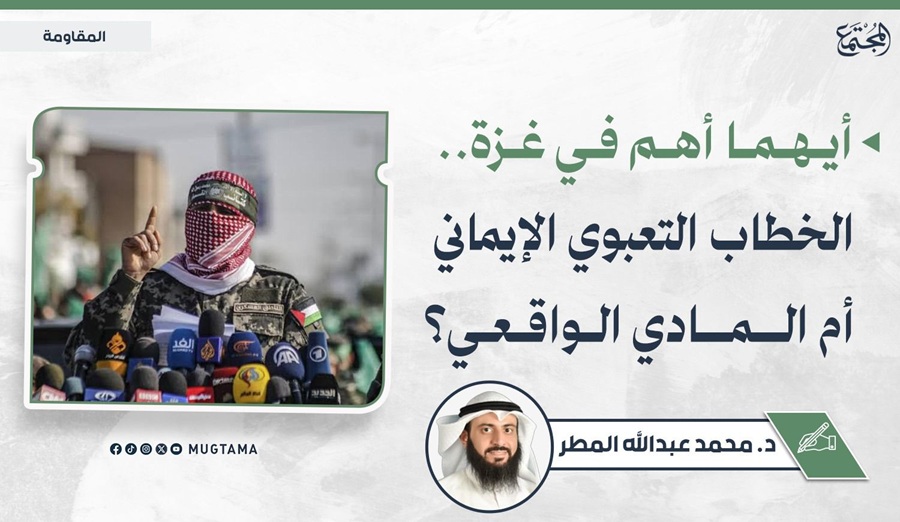
في إحدى الديوانيات الكويتية (مجالس
اجتماعية)، نُوقشت تطورات العدوان على غزة، فطُرحت رؤيتان متقابلتان؛ الأولى
ركّزت على أهمية الخطاب الإيماني التعبوي، انطلاقاً من أن قضية فلسطين ليست سياسية
فقط، بل هي قضية عقيدة وهوية، ومحل ابتلاء رباني يتطلب استحضار معاني الصبر والرضا
والتوكل والثبات، وربط الأمة بالله ووعده ونصره.
وأما الرؤية الثانية فدعت إلى التركيز
على الجانب الواقعي العملي، معتبرة أن الناس في غزة يموتون جوعاً ويُقصفون كل
لحظة، ولا وقت لديهم إلا لتدبير ما يوقف نزيف الدم ويقلل المعاناة، والأكبر من ذلك
إضعاف العدو ثم النصر عليه، فالمطلوب الآن هو خطاب عملي واقعي ينشغل بالخطط
السياسية والدبلوماسية والإغاثية.
وفي الحقيقة، فإن هذين الاتجاهين لا
ينبغي أن يتصارعا، بل أن يتكاملا؛ إذ لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالجانب الإيماني
يمد الأمة بروح الصمود والتضحية، والجانب العملي يترجم هذا الإيمان إلى فعل مؤثر
في الواقع، وقد يقول قائل من أهل القضية (وهو على حق): لن يشعر غيرنا بمرارة ما
نعيشه من واقع مؤلم، فنحن لا ننتفع بالتنظير من الخارج، ولا نحتاج إلى من يُملي
علينا، والحقيقة أنه للأسف هذا ما بأيدينا، وهناك جوانب أخرى بحسب الإمكان، فالله
يعفو عن تقصيرنا، ويلهمنا العمل والنية الصادقة.
وأما ما يتعلق بمفهومنا هنا فيوضحه
الشيخ يوسف القرضاوي يرحمه الله بقوله: «فالنصر لا يتحقق بالإيمان المجرد عن
الإعداد، ولا بالإعداد المجرد عن الإيمان، وإنما يتحقق إذا اجتمع الأمران معاً؛
الإيمان العميق، والإعداد الكامل»؛ وهي قاعدة عظيمة تضع النقاش في موضعه الصحيح؛
فالنصر في الإسلام هو نتيجة لتفاعل السنن الكونية (الأسباب المادية) مع السنن
الإيمانية (الاستجابة الروحية والارتباط بالله)، وهذه معاً تنطلق من قناعة عقدية
أصيلة مبنية على الإيمان والعمل معاً، وفي الحديث حول ذلك:
أولاً: إن الجانب الإيماني يمثل الأصالة
الداخلية التي تبعث الأمل والصبر في القلوب، وتُلهب الحماسة في النفوس، وتشد
العزائم عند المحن، فكلما زاد الإيمان بعدالة القضية وثبتت العقيدة بأن النصر من
عند الله؛ ازدادت الأمة ثباتاً ويقيناً، وقد وعد الله تعالى في كتابه فقال: (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن
يَنصُرُهُ) (الحج: 40)، وقال: (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (الصف: 13).
الجانب الإيماني يمد الأمة بروح الصمود والتضحية.. والعملي يترجم هذا الإيمان إلى فعل مؤثر في الواقع
فالنصر لا يرتبط بالقوة العددية فقط، بل
بمدى الصدق في التوكل على الله والثقة بوعده، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
أعظم أسوة في طريقنا في كل أمورنا، فقد كانت غزوة «بدر» مثالاً خالداً على هذا
المفهوم، فالمسلمون يومها كانوا قلة في العَدد والعُدّة، ولكنهم صدقوا مع الله،
فأتى نصر الله من حيث لم يحتسبوا؛ (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ) (آل عمران:
123)، فأصبحت حقيقة تاريخية متكررة بأن قلة العدد والعدة لا تمنع مقاومة
العدو.
وهنا يظهر البُعد التعبوي للخطاب
الإيماني، فالإيمان يجعل أهل غزة يَرَون ما لا يراه غيرهم، وقد قال شيخ الإسلام
ابن تيمية يرحمه الله قبل معركة «شقحب»: «إنكم لمنصورون»، فقيل له: قل إن شاء
الله، فأجاب: «أقولها تحقيقاً لا تعليقاً»، فكانت كلمته مرآة ليقين راسخ بوعد الله
مبنية على أبعاد عقدية أيديولوجية تؤدي للعمل والجهاد، ولا نغفل عن مثال قريب وهو
الثورة السورية التي أحاطها اليأس والخسائر لمدة عقد من الزمن، ولكن تحقق الحلم
بتقدير الله ثم معطيات واقعية، وبنضال وجهاد الشعب لسنوات، حتى بات من شكك بالثورة
يشارك في الفرح بها!
فهذا البعد العقدي والتعبوي ليس ترفاً
فكرياً، بل ضرورة وجودية في مثل هذه الحروب؛ لأن الإنسان في حالات القصف والدمار
والخوف يحتاج إلى قوة معنوية فوق الطاقات البشرية، وهذه لا يعطيها إلا الإيمان،
ومن ظن أن غزة تصمد بالقوة المادية وحدها فقد غفل عن سر النصر الخفي، بل إن أهل
غزة أنفسهم يُدركون ذلك.
ثانياً: الخطاب الواقعي في المقابل الذي
يركز على الجوانب العملية لا يقل أهمية، بل هو وجه آخر للتوكل الصحيح، فالله تعالى
أمر بإعداد القوة: (وَأَعِدُّواْ
لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) (الأنفال: 60)، والإعداد هنا لا
يُشترط أن يكون مساوياً لقوة العدو من قدرات قتالية وإعلامية وعددية، بل بما
نستطيع.
النصر لا يرتبط بالقوة العددية والعدة فقط بل بمدى الصدق في التوكل على الله تعالى والثقة بوعده
والنبي صلى الله عليه وسلم رغم كونه سيد
المتوكلين، أخذ بالأسباب في كل غزواته، بل حتى في الهجرة النبوية، وهي هجرة روحية
عقائدية، لم يتوكل فقط، بل اختبأ في الغار، واتخذ دليلاً، ووزع الأدوار، وأخفى
الطريق، وفي «أحد» أخذ بالشورى المؤيدة للخروج مع عدم قناعته به لتفضيله البقاء في
المدينة، وأيضاً في غزوة «الخندق» مثال على التخطيط الدفاعي المادي، إذ حُفر
الخندق وهي فكرة أجنبية كإجراء ميداني عملي، ولم يكن كافياً أن يسلك النبي صلى
الله عليه وسلم الجانب الإيماني فقط، وغيرها الكثير من الأمثلة.
وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا
تُمطر ذهباً ولا فضة»، فالرؤية الإسلامية ترى أن التوكل لا يعني الركون والكسل، بل
هو العمل بكل ما تستطيع، ثم التفويض الكامل لله.
ففي الواقع الغزي، يتجلى ذلك في سعي
المقاومة لبناء ترسانة عسكرية دفاعية، وتطوير قدراتها الاستخباراتية والتكتيكية،
والسعي لتحسين الجبهة الإعلامية والسياسية، فهذه كلها أسباب مادية مشروعة لا يُمكن
إغفالها، وقد رأينا كيف ساهم الإعلام والصورة والشهادة في تشكيل وعي الأمة من جديد
بعد نسيان وتغافل عن القضية، وذوبان بعض مفاهيمها وأهميتها، وهذا أيضاً في تطور لافت
وقفزة كبيرة في تاريخ القضية جعل كثيراً من الدول الغربية، والمؤسسات المدنية،
والجموع الشعبية عندهم تُراجع مواقفها على تفاوت وإن لم يكن ذلك متخيلاً في
السابق.
فهنا تأتي أهمية التكامل بين الجانبين؛
فكما قال الإمام ابن القيم: «لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب، وإن تركها
عجز ينافي التوكل، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجزاً»، وهذا ينطلق مما
عبّر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أحدهم: أأعقل ناقتي وأتوكل؟ فقال: «اعقِلها
وتوكّل».
النصر بغزة لا يتحقق عبر الإيمان وحده ولا الخطط وحدها وإنما عبر اندماج الرؤية العقدية بالإستراتيجية الواقعية
إن النصر في غزة لا يتحقق عبر الإيمان
وحده، ولا عبر الخطط وحدها، وإنما عبر اندماج الرؤية العقدية بالإستراتيجية
الواقعية، يقول تعالى: (تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {11} يَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {12}
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ) (الصف)، فقرن بين الإيمان والجهاد بالمال والنفس، وهذا هو
التوازن المطلوب.
وتشبع الواقع بالمنهج المادي في قلوب
الناس ووجدانها، ونسيانهم تعاليم القرآن، قد حذّر أبو الحسن الندوي من المادية
البحتة حين قال: «الإسلام لا يسمح بالنظرية المادية القائلة: «إن مملكتي ليست إلا
هذا العالم»، ولكن القرآن يرشدنا أن ندعو: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (البقرة: 201)»، فطريق الإسلام طريق وسط بينهما؛
(وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ
عِندِ اللّهِ) (الأنفال: 10).
















