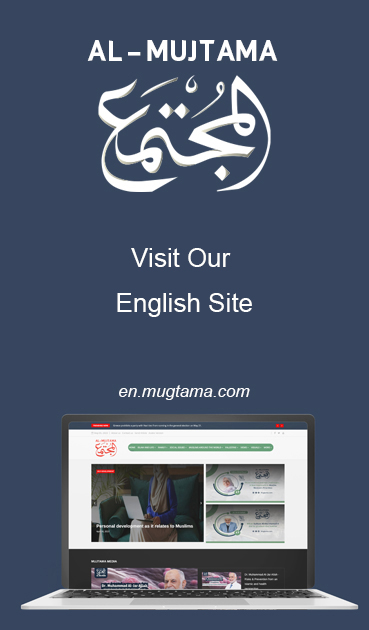لك الأمر.. في التسليم لله عز وجل للإمام البوصيري
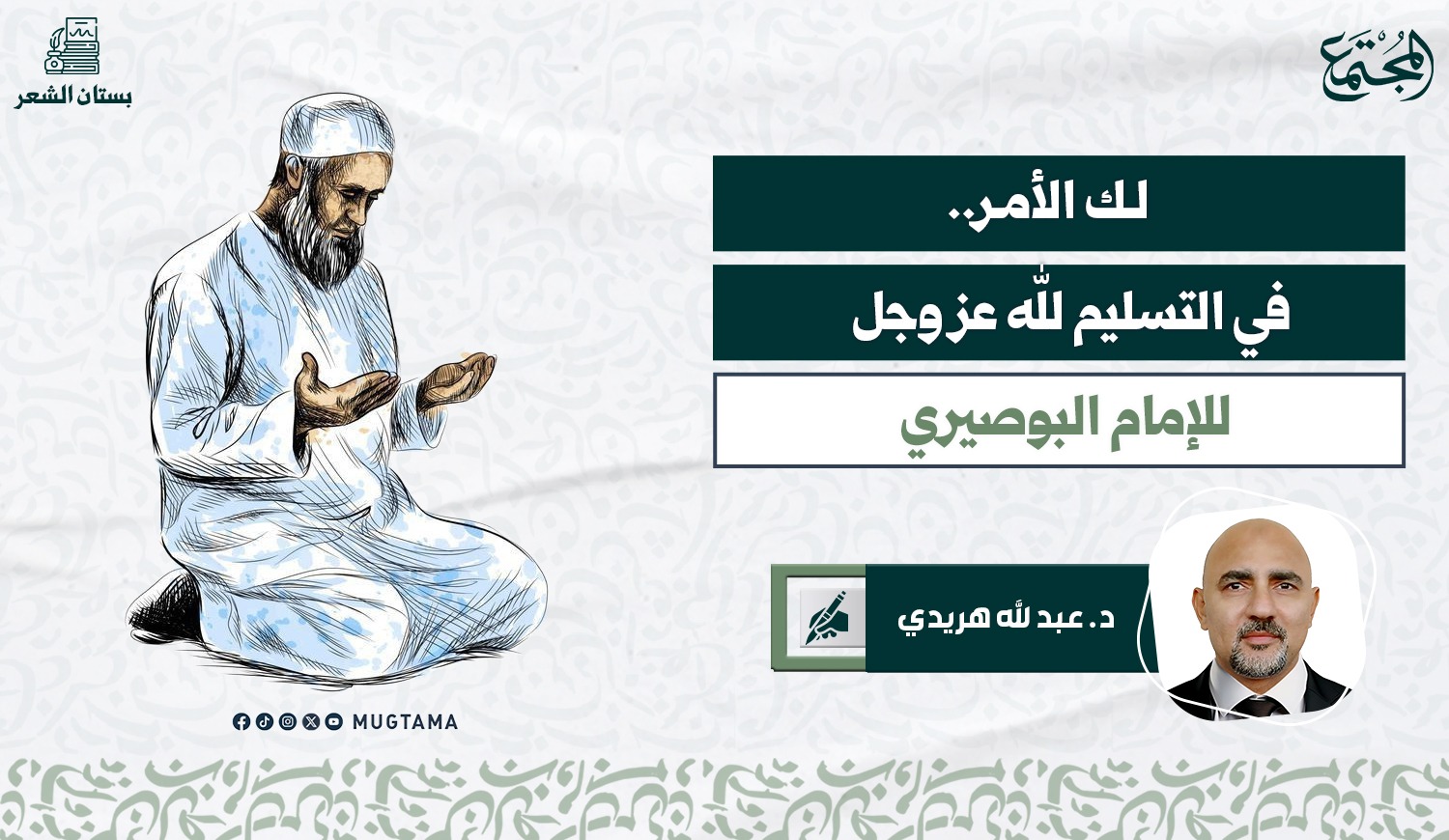
لك الأمر.. في التسليم لله عز وجل للإمام
البوصيري (بحر الطويل):
إلهي عَلَى كلِّ الأمورِ لَكَ
الحَـــمْدُ فلَيْسَ لِمَا أَوْلَيْتَ
مِــــــــــــــــــــــــــنْ نِعَمٍ حَدُّ
لَكَ الأَمرُ مِنْ قَبْل الزَّمانِ وبَـــعْدهُ وَما لكَ قَبْلٌ
كالـــــــــــــــــــــــــزَّمانِ وَلا بَعْدُ
وحُكْمُكَ ماضٍ في الخلائِقِ نَافِــــــذٌ إذا شئتَ أمرًا ليس من كونِهِ بُدُّ
تُضلُّ وتهدي منْ تشَاءُ منَ الوَرَى وما
بِيد الإِنْسَـــــــــــــــــــــــان غَيٌّ ولا رُشْدُ
حول الأبيات
هذه الأبيات ذات طابع ديني وصوفي، تُعبر
عن تقديس المولى عز وجل والاعتراف المطلق بقدرته ومشيئته وحكمته.
وتتنقل الأبيات بين محاور رئيسة، هي:
الحمد، والأزلية والأبدية، والقدرة المطلقة، والهداية والضلال.
1- فالبيت الأول يتناول الحمد على النعم غير
المحدودة:
إلهي عَلَى كلِّ الأمورِ لَكَ الحَمْدُ فلَيْسَ لِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ نِعَمٍ حَدُّ
المعنى:
يبدأ الشاعر خطابه مباشرة بـ«إلهي»؛
ما يعطي طابعًا حميميًا للدعاء والمناجاة، ويقرر أن الحمد الكامل والشامل لله على
جميع الأحوال سواء كانت سراء أو ضراء، لأن الحكمة الإلهية تتجاوز إدراك البشر، ثم
يبرر هذا الحمد الشامل بأن النعم التي أنعم الله بها لا حصر لها ولا حدود.
الأسلوب:
- الاستدراج: بدأ بالنداء «إلهي» ليخلق
جوًا من المناجاة والخشوع.
- التعميم والتخصيص: عمم الحمد على «كل
الأمور»، ثم خصص السبب بعدم محدودية النعم.
- المبالغة: في قوله: «ليس.. حد» لتأكيد
عظمة وكرم المنعم.
2- وفي البيت الثاني يتحدث عن الأزلية
والإطلاق الزماني:
لَكَ الأَمرُ مِنْ قَبْل الزَّمانِ
وبَعْدَهُ وَما لكَ قَبْلٌ كالزَّمانِ وَلا بَعْدُ
المعنى:
هذا البيت يتناول صفة القدم والأزلية
الإلهية، ويؤكد الشاعر أن الأمر والسلطان لله تعالى قبل وجود الزمان نفسه وبعد
فنائه، ثم يصل إلى ذروة العمق الفلسفي والديني بقوله: إن الله تعالى لا يوصف بـ «"قبل»
كالزمان الذي نعرفه ولا «بعد»، لأن هذه مفاهيم مخلوقة وهو خالقها، وجوده مطلق لا
يحده ماضٍ ولا مستقبل.
الأسلوب:
- الطباق: بين «قبل» و«بعد» ليشمل كل
الأزمنة التي يمكن تخيلها.
3- وفي البيت الثالث يتناول القدرة المطلقة
والمشيئة النافذة:
وحُكْمكَ ماضٍ في الخلائِقِ نَافِذٌ إذا
شئتَ أمراً ليس من كونِهِ بُدُّ
المعنى:
ينتقل الشاعر إلى صفة القدرة والمشيئة،
فحكم الله نافذ لا راد له في جميع المخلوقات، وإذا أراد الله أمرًا فلا بد أن يقع
حتمًا، وكلمة «بد» تعني: مهرب أو مانع؛ أي لا يوجد ما يمنع تحقق ما أراد الله.
الأسلوب:
- التأكيد: باستخدام كلمتي «ماض» و«نافذ»
لتأكيد حتمية وقوة المشيئة الإلهية.
- البناء اللغوي القوي: جملة «ليس من
كونه بد» جملة قاطعة ومطلقة، تنفي أي احتمال للعجز أو التعطيل.
4- وفي البيت الرابع يتحدث عن الهداية
والضلال والاستسلام للقدرة الإلهية:
تُضلُّ وتهدي منْ تشَاءُ منَ الوَرَى وما
بِيد الإِنْسَان غَيٌّ ولا رُشْدُ
المعنى:
يختتم الشاعر بأحد أعمق مفاهيم العقيدة
الإسلامية، وهو أن الهداية والضلال بيد الله تعالى، هو الذي يهدي من يستحق الهداية
ويضل من يشاء بحكمته، وفي النهاية، يقرر الشاعر عجز الإنسان المطلق، فليس بيده أن
يضل نفسه أو يهديها بمجرد مشيئته دون مشيئة الله.
الأسلوب:
- الطباق: بين «تضل» و«تهدي» وكذلك بين «غي»
و«رشد».
- الحكم الجازمة: البيت يعبر عن حقيقة
عقدية بشكل قاطع؛ ما يعزز شعور العبد بالضعف والافتقار إلى ربه.