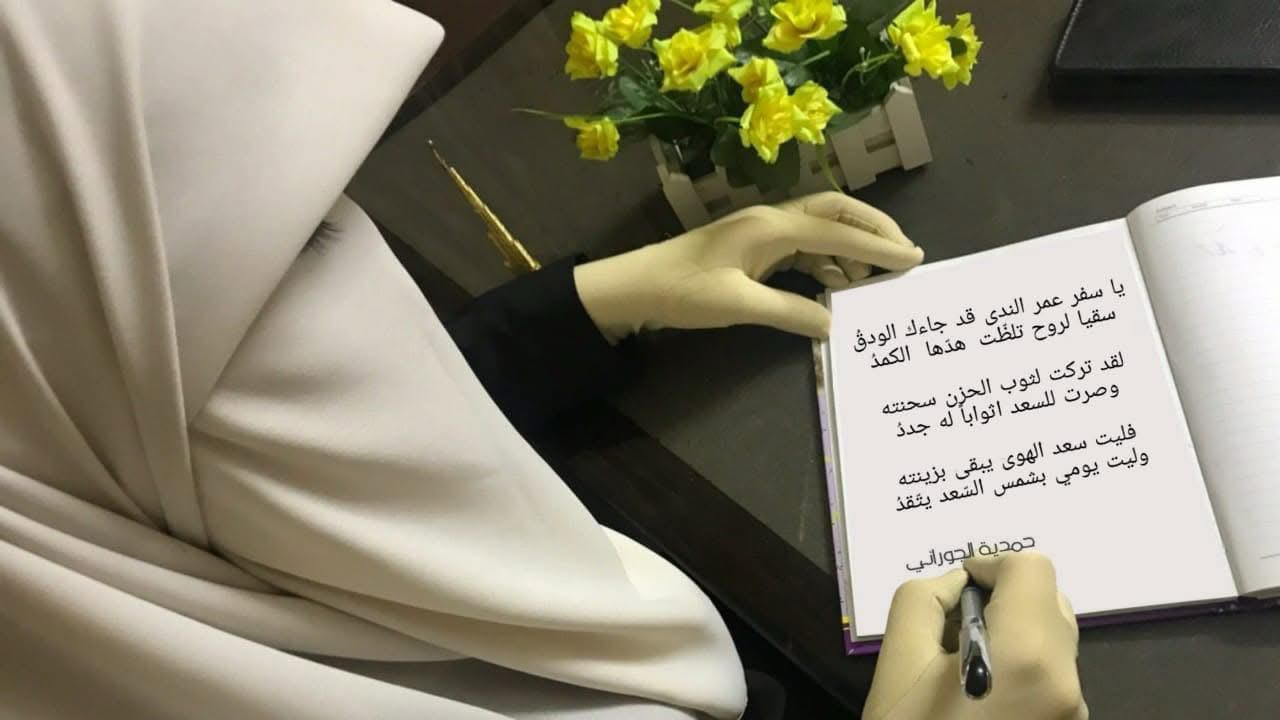أنفاس الوحي (1)
قراءة نفسية وبلاغية في مشهد يونس وكعب والشاب الحالم
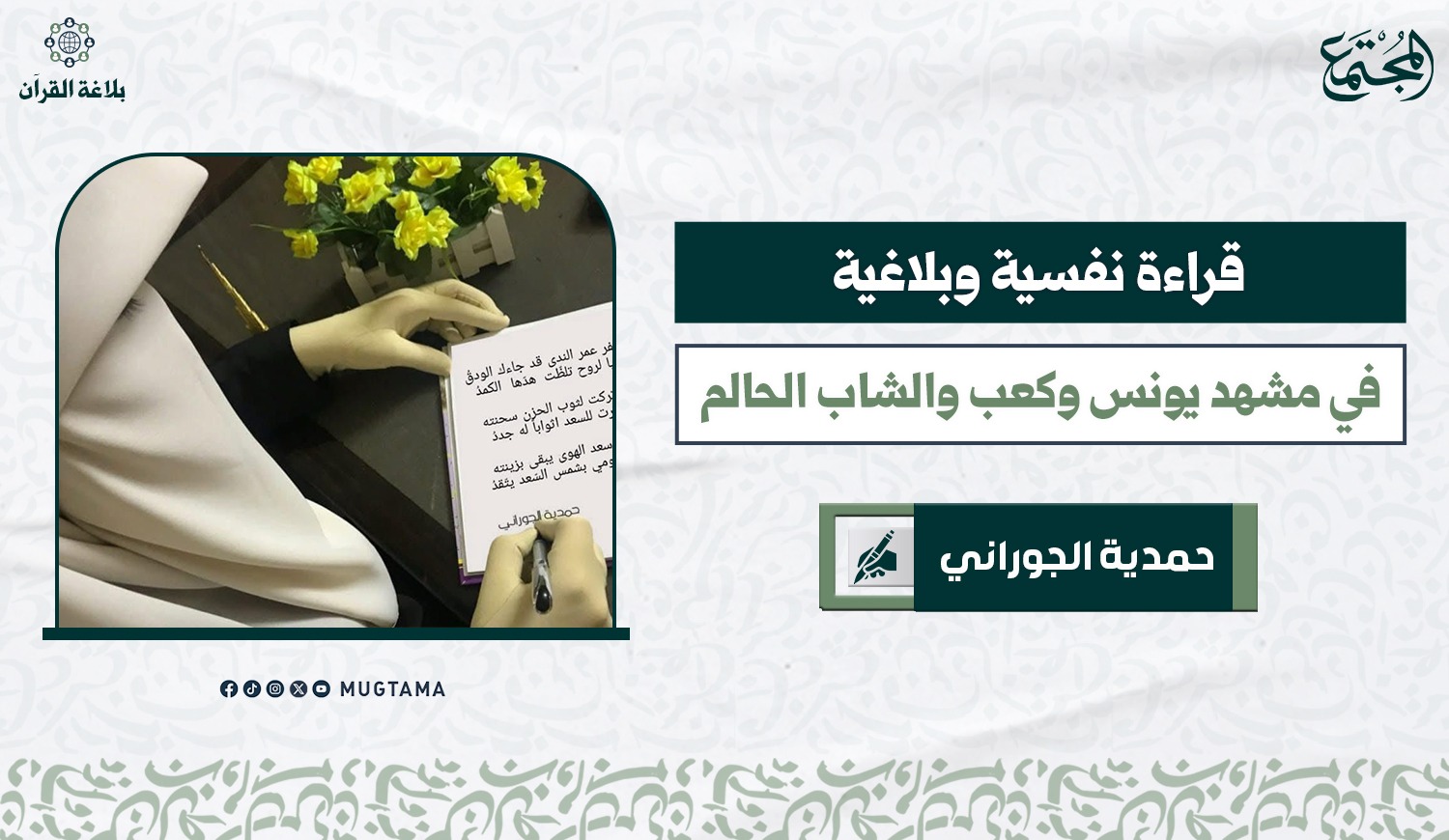
لطالما عكف القدماء والمحدثون على تأمل
كنز وارف؛ تحدى الله به أقواماً ملكوا ناصية الفصاحة وفنون الكلام، انبهرت العقول
بسلاسة ألفاظه، وإحكام أساليبه، واتساق الإيجاز والإطناب فيه، وما هي إلا ومضات من
نور رباني تنير العقول وتأسر القلوب، فكل ما فيه يقتضي التدبر، لما يحويه من أسرار
لا تتأتى إلا لمن شرح الله صدره لها، فأطال تأملها وأعمل الفكر فيها بالربط
والتحليل والاستنتاج، وليس الذي وقفوا عليه بنهاية المطاف، بل هو مَعين لا ينضب.
ولعلنا سنحاول في هذه السطور أن نضفي،
ولو بلبنة صغيرة، إلى صرح الدراسات القرآنية، علّها تكون شاهداً لنا لا علينا يوم
التلاق، تلك غاية سامية، لكن ما يجعلنا في مسار الاستخلاف هو أن نوظف طاقاتنا
لاستثمار كل نتيجة يظهرها تحليل الخطاب القرآني بما يحمله من أبعاد نفسية،
واجتماعية، وإصلاحية، في واقعنا المعاصر؛ غاية العودة إلى شاطئ الأمان من نهج
القرآن، في فوضى عارمة تعاورها العولمة والتسارع التكنولوجي واللا إنسانية.
أولًا: المشهد القرآني.. دراما الغضب والاعتراف:
يقول تعالى: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ
لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (الأنبياء: 87).
تبدأ القصة بالفعل: (ذَهَبَ مُغَاضِبًا).
الفعل «ذهب» يشي بالانفصال والانسحاب،
وكأن النبي فارق موقعه قبل أن يُؤذن له بالرحيل.
و«مغاضبًا» صيغة مفاعلة، لا غضبًا عابرًا،
هي انفعال متبادل، احتدام داخلي مع قومه، بل مع قدر الله.
ثم يجيء قوله: (فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ).
«نقدر» جاءت بلفظ يحتمل: أن لن نضيّق
عليه، أو أن لن نستطيع، والمعنى الأول هو المقصود، لكن تركُ اللفظ رحبًا يُعطي
ظلًا نفسيًا: كأن في داخله وهْمًا بأن المساحة أوسع مما هي.
هنا يظهر الخطأ الجوهري: غلبة الظنّ
البشري على بديهة العبودية.
وجاءت النتيجة مباشرة: (فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ).
«الفاء» للتعقيب: وكأن الخطأ النفسي أفضى
في الحال إلى ظلمة كونية.
و«الظلمات» جاءت معرفة بالاستغراق، جمعًا
لا مفردًا، لتوحي بالتراكم والانسداد، فهي ليست ظلمة واحدة يمكن احتمالها، بل
ظلمات تتكاثر حتى تسحق الأفق.
ثم انفجرت الجملة النورانية: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).
بُنيت على ثلاثية متوازنة: توحيد يُنير،
تسبيح يُطهّر، اعتراف يُكسر كبرياء النفس.
اختيار «كنت من الظالمين» لا «ظلمت» فقط،
هو إذعان جماعي، انتماء إلى جماعة الضعف البشري، لا ادعاء خصوصية، إنه فنّ
الاعتراف المتواضع.
ثانيًا: التحليل الصوتي.. الظلمات والظالمين:
هنا نلمس بلاغة التعبير القرآني في
الاشتراك الصوتي بين «الظلمات» و«الظالمين».
كلاهما ينهض على الجذر «ظ ل م»، وهو جذر
دلالته الأصلية الغياب والستر والضغط.
الحرف «ظ» من حروف الاستعلاء والإطباق،
ثقيل على السمع، كأنه يُحاكي ثِقل الظلمة.
النهايتان الممدودتان «ـات / ـين» توحيان
بالامتداد: الأولى في المكان والجوّ، والثانية في فعل الإنسان الممتد عبر الزمن.
كأن النص يُنشئ جسرًا صوتيًا بين الخارج
والداخل: الظلمات تحاصر الجسد، لأن الظلم يسكن النفس.
ثالثًا: ولاية النور.. الربط بالآية الأخرى:
ولم يترك القرآن هذا المشهد معلقًا، بل
قرنه بمبدأ عام خالد: (اللَّهُ
وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (البقرة:
257).
فإذا كان يونس قد نادى في الظلمات، فإن
نجاته لم تكن إلا بمصداق هذه الآية.
لقد عاد بالتوبة إلى صفّ المؤمنين،
فأعاده الله إلى ولايته.
وما إن اعترف بذنبه حتى صارت له عُروة
بالولاية الإلهية، فاخترقت دعوته طبقات البحر والليل والحوت، حتى سمعتها ملائكة
السماء، فكان الخروج إلى النور بولاية الله لا بقدرة أحد سواه.
رابعًا: المشهد الموازي في السيرة.. كعب بن مالك:
كما عرف يونس الظلمات، عرفها كعب بن مالك
يوم تخلف عن غزوة «تبوك»:
- ظلمة الوحدة حين قاطعه أقرب الناس، حتى
حبيبه ﷺ.
- ظلمة النفس حين أطبق عليه ندمه.
- ظلمة الأرض حين لم يجد موضعًا يأوي
إليه.
لم يقل لفظًا: «إني كنت من الظالمين»،
لكنه عاش معناها صدقًا، لم يعتذر بكذب ولا تجمّل بخداع، بل ثبت على الصدق، حتى جاء
الفرج: (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ
الَّذِينَ خُلِّفُوا) (التوبة: 118)، فانشقت له السماء عن نور القبول، كما
انشقت ليونس عن نور النجاة.
خامسًا: المشهد المعاصر.. الشاب المريض:
وما أشبه الليلة بالبارحة، ذلك الشاب
العشريني، المنعزل في غرفة المستشفى، عاش هو الآخر ظلمات ثلاث:
1- غربة عن الأهل.
2- جسد ينهكه المرض.
3- غرفة مغلقة تحجب أنفاس الحياة.
في هذه الظلمات، لم يكن له إلا دموعه،
وقد كانت دموعًا تقول بلسان صامت: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، غير
أن فرجه كان مختلفًا: لم ينجُ جسده كما نجا يونس، ولا طالت حياته كما طالت حياة
كعب، بل كانت نجاته أبدية، مات الجسد، لكن نوره بقي أثرًا وذكرى، شاهدًا أن من
نادى الله بصدق لا يضيع، ولو وارته الأرض.
سادساً: قانون الخلاص المتكرر:
من يونس إلى كعب إلى ذلك الشاب، نرى
قانونًا يتكرر:
- كل إنسان له بطن حوت: قد يكون مرضًا،
أو ذنبًا، أو عزلة.
- كل ظلمة خارجية مرآة لظلمة داخلية:
الغضب، التخاذل، الغفلة.
- الخروج يبدأ من الداخل: من كلمة صادقة،
من اعتراف خاشع، من دمعة نقية.
- على المستوى النفسي، الاعتراف لا يهدم
النفس بل يحررها، وعلى المستوى البلاغي، الدعاء القرآني يرسم سلمًا صاعدًا.
سابعًا: البنية الأسلوبية والبلاغية:
الإيقاع الثلاثي: الظلمات ثلاث، المشاهد
ثلاثة، الدعاء ثلاثي الأجزاء، هذا البناء المتكرر يعمّق الحفظ ويرسخ الدلالة.
- الموازاة التصويرية: مشهد قرآني، مشهد
نبوي، مشهد معاصر، في خط واحد.
- المقابلة: (الظلمات / النور)، (الذنب /
الاعتراف)، (الموت / البقاء في الأثر).
- الإيقاع الداخلي: تكرار الجذر (ظ ل م)
في صور متنوعة، يشكل منبهاً أسلوبياً يستدعي الغوص في إيحاءاته في النص.
ثامناً: الخاتمة التربوية:
العبرة أن حجم الظلمة لا يُخيف بقدر ما
يُحرّك الكلمة، فكل إنسان محاط بظلمات؛ من مرض، خسارة، غربة، عزلة، لكن الخروج لا
يكون بالقدرة البشرية، بل بالولاية الإلهية: (اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ) (البقرة: 257).
فردّد الليلة كما ردّد يونس، وكما عاش
كعب، وكما بكى ذلك الشاب: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، فلعلها
تكون كلمة النور التي تفتح لك أبواب الرحمة، وتخرجك من أعمق الظلمات، ولو رحلت قبل
أن يراك الناس ناجيًا.