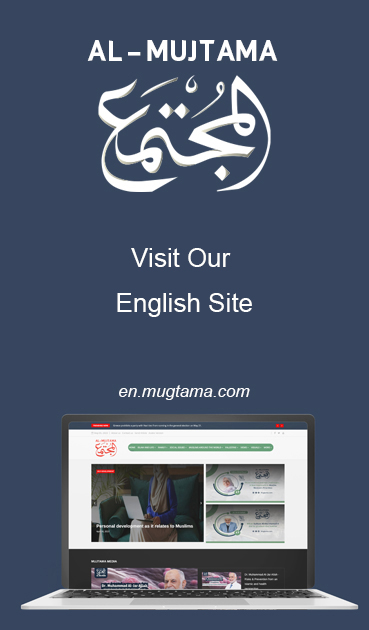بين علم النحو وعلوم الشريعة (2 - 6)
علم النحو وعلوم القرآن (1)
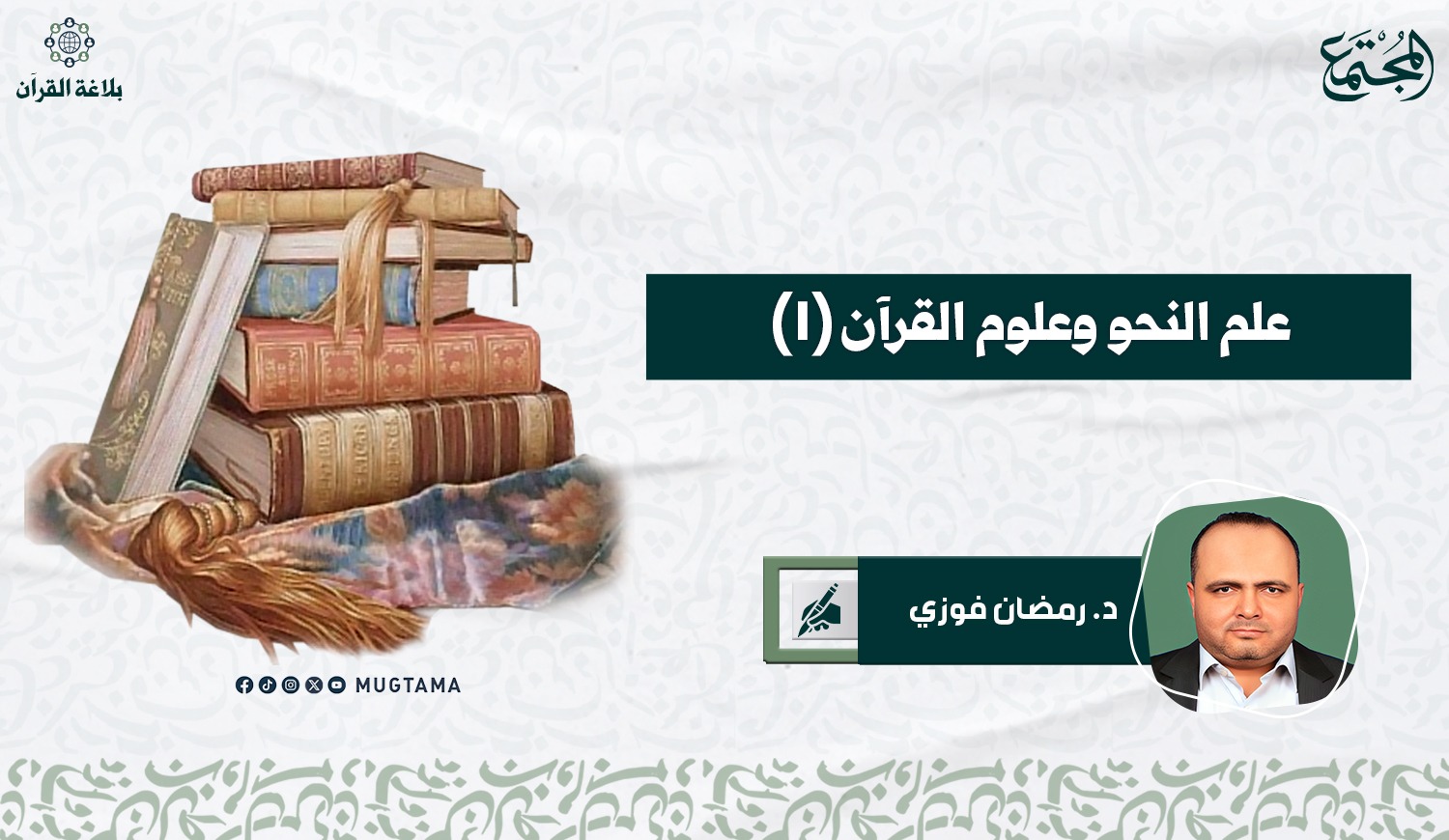
مر في المقال
السابق الحديث عن علم النحو من حيث تعريفه وأهميته، وعرفنا أن هناك علاقة وثيقة
بين علم النحو ومختلف العلوم والفنون، وعلى رأسها علوم الشريعة، وفي المقدمة منها
علوم القرآن بما تحويه من علم التفسير وعلم القراءات؛ إذ يُعد الإعراب مدخلاً مهماً
لفهم مضامين النصوص الدينية؛ حيث يترتب على اختلاف حركات الإعراب توالد معان
ودلالات متنوعة للنص.
وبناء على ذلك،
هبَّ العلماء المهتمون بتراث أمتنا -وعلى رأسه علوم القرآن- فصنفوا الكتب المتخصصة
في الإعراب في كل فن من هذه الفنون؛ فنجد الكتب المتخصصة في إعراب القرآن للفراء،
والنحاس، والزجاج، وابن سيده، وابن خالويه، والقيسي.. فضلاً عن كتب التفسير التي
لا يخلو أحدها من تأثر باللغة واستشهاد بقواعدها في تفسير مراد الله تعالى في
كلامه.
ولا تخلو مقدمات
كتب إعراب القرآن من الإشارة لأهمية أن يكون المفسر على دراية كافية بعلوم اللغة
تمكنه من الفهم الصحيح لمراد الله تعالى في كتابه، منها في هذا السياق ما ذكره مكي
بن أبي طالب: «ورأيت من أعظم ما يجب على الطالب لعلوم القرآن، الراغب في تجويد
ألفاظه، وفهم معانيه، ومعرفة قراءاته ولغاته، وأفضل ما القارئ إليه محتاجٌ؛ معرفةُ
إعرابه، والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه؛ ليكون بذلك سالماً من اللحن فيه،
مستعيناً على أحكام اللفظ به، مطلعاً على المعاني التي قد تختلف باختلاف الحركات،
متفهماً لما أراد الله به من عباده؛ إذ بمعرفة حقائق الإعراب تُعرف أكثر المعاني،
وينجلي الإشكال؛ فتظهر الفوائد، ويُفهَمُ الخطاب، وتصح معرفة حقيقة المراد» (مشكل
إعراب القرآن: 1/ 63).
النحاة.. والاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته
تعددت مصادر
الاحتجاج عند النحاة؛ فقد كانوا يعتمدون في تقعيد قواعدهم على ما جمعوه من نصوص
منثورة أو منظومة بضوابط معينة، ويأتي القرآن الكريم على رأس هذه النصوص المنثورة؛
فلم يوجد من خالف في الاحتجاج بألفاظ القرآن جميعاً، وفي جواز الاحتجاج بقراءاته
المتواترة جميعها؛ حتى إن بعض متأخري النحاة أجازوا الاحتجاج بالقراءات الشاذة؛ يقول
السيوطي: «أما القرآن الكريم فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية،
سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً، وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات
الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً؛ بل ولو خالفته يحتج بها في مثل
ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته
القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه؛ نحو: «استحوذ» و«يأبى»..» (الاقتراح
للسيوطي، ص51).
والسبب في كون
القرآن الكريم المصدر الأول للاحتجاج اللغوي راجع إلى:
1- أن القرآن
الكريم كلام الله عز وجل خالق اللغات جميعاً، الخبير بدقائق اللغة وأسرارها قبل أن
توجد أو ينفتق عنها لسان، وقد أخبر تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (يوسف:
2)؛ فكون هذا القرآن عربياً، والذي أنزله هو العالم بأسرار العربية، فإن
هذا يقتضي مطلق التسليم والاطمئنان لفصاحته وسلامته.
2- ضمان عدم
دخول أي تحريف أو تغيير أو تبديل عليه؛ فالله عز وجل الذي أنزله قرآناً عربياً
تكفل بحفظه ورعايته بنفسه؛ فقال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)
(الحجر: 9).
3- ما اكتسبه
هذا النص المعجز من قدسية وإجلال لدى هؤلاء العلماء؛ فحبهم لهذا الكتاب وتقديسهم
له مع استحضار ما ذكرناه سابقاً من أن هذا الكتاب أنزله الله عربياً، وأنه تعالى
تكفل بحفظه؛ كل هذا جعله مقدماً على غيره من النصوص والمصادر الأخرى.
يقول د. عبدالعال
سالم مكرم: «اتفق علماء اللغة على أن القرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول
الاستشهاد في وضع القواعد النحوية؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين، ولم نسمع أحداً حاول
أن يتلاعب بكلماته أو يغير في أساليبه، أو يدخل فيه ما ليس منه، فهو أصدق في
الدلالة اللغوية، وأقوى في الاستشهادات النحوية من كل النصوص اللغوية الأخرى، مهما
كانت درجة هذه النصوص من الرواية والإتقان والحفظ والضبط».
النحو.. والقراءات القرآنية
تنسحب حجية
القرآن هنا أيضاً على قراءاته المختلفة، وهو ما سنفرد له الحديث في هذا السطور
التالية؛ حيث سنتحدث عن علاقة علم النحو بعلم القراءات.
ويجدر بنا في
هذا السياق التعريج على تعريف القراءات؛ حيث عرفها الدمياطي بأنها: «علم يُعلم منه
اتفاق الناقلين لكتاب الله، واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل
والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال، وغيره من حيث السماع، أو يقال علم
بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله» (إتحاف فضلاء البشر، ص6).
فالاختلاف بين
القراءات القرآنية إنما هو اختلاف في كيفية أداء كلمات القرآن، أو اختلاف ألفاظ
الوحي من حيث التخفيف والتشديد، أو الاختلاف في الحذف والإثبات والتحريك.. إلخ،
وهذا الاختلاف له سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في ضوابط القراءات
الصحيحة.
ومن الملائم في
هذا السياق الإشارة إلى الفرق بين القرآن والقراءات؛ وهو ما ذكره الزركشي بقوله: «اعلم
أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى
الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في
كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما» (البرهان في علوم القرآن، 1/ 318).
ضوابط القراءات الصحيحة
وضع العلماء
ضوابط للقراءات؛ بها يحكمون على القراءة بالصحة والقبول، وإذا خولف أحد هذه
الضوابط حكموا عليها بالبطلان أو الضعف أو الشذوذ، بغض النظر عن صاحب هذه القراءة،
سواء كان من القراء السبعة المشهورين، أم من غيرهم.
وهذه الضوابط
التي حددها العلماء ثلاثة؛ هي:
1- صحة سند هذه
القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- موافقة أحد
المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.
3- موافقة اللغة
العربية ولو بوجه.
مظاهر العلاقة بين علم النحو والقراءات القرآنية
تتمثل أبرز
مظاهر العلاقة بين علم النحو والقراءات القرآنية فيما يلي:
أولاً: مر -منذ
قليل- أن من ضوابط القراءة الصحيحة موافقتها للغة العربية وقواعدها، ولو بوجه،
وحول هذه الضابط يقول ابن الجزري، أحد أشهر علماء القراءات: «وقولنا في الضابط: «ولو
بوجه» نريد به وجهاً من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحاً، مجمعاً عليه أم
مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله» (النشر في القراءات العشر، ص11).
ثانياً: تعد
القراءات القرآنية -خاصة المتواترة منها- من مصادر الاحتجاج عند النحاة، وقد توسع
بعضهم فاحتج ببعض القراءات الشاذة، كما فعل الكوفيون الذين أكثروا من الاستدلال
بالقراءات القرآنية لأنها عندهم أوثق من بيت شعر لم يعرف قائله، ويُذكر في هذا
السياق أن إمام مدرستهم النحوية الإمام الكسائي هو أحد القراء السبعة المشهورين.
وبناء على ذلك،
بنى النحاة بعض قواعدهم بناء على اختلاف القراءات القرآنية في الآية الواحد؛ فمن
ذلك مثلاً أن النحاة في باب النعت ذكروا أن المنعوت إن كان معلوماً بدون نعت نحو «مررت
بامرئ القيس الشاعر» جاز في النعت –وهو الشاعر في الجملة السابقة- ثلاثة أوجه:
الأول: الاتباع؛
فيكون هنا تابعاً لما قبله فيكون مجروراً «الشاعرِ».
الثاني: القطع
بالرفع على إضمار «هو»؛ أي: «هو الشاعرُ».
الثالث: النصب
على إضمار فعل «أقصد»؛ أي: «أقصد الشاعرَ».
واحتجوا على ذلك
بما ورد من قراءتي الرفع والنصب في قول الله تعالى في سورة «المسد»: (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) (المسد: 4)؛ حيث قرأها عاصم «حمالةَ الحطب» بالنصب، وقرأها الباقون
«حمالةُ الحطب» بالرفع.
فعلى القراءة
الأولى تكون مفعولاً به لفعل محذوف تقديره «أذمُّ حمالةَ الحطب» أو «أعني..»، وعلى
القراءة الثانية -قراء الرفع- فإما أن تعرب على الاتباع لـ«امرأته»، أو تكون خبراً
لمبتدأ محذوف تقديره «هي حمالةُ الحطب»، أو على أنها خبر مبتدأ لـ«امرأته».
ثالثاً: اختلاف
القراءات المبني على اختلاف في الحركة الإعرابية يتولد منه معان متنوعة؛ فمثلاً في
قول الله تعالى: (قَالَ اللهُ
هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) (المائدة: 119)، قرأ نافع
بنصب «يومَ»، وقرأ الباقون برفعها؛ فعلى قراءة نافع يكون «يوم» ظرف زمان، ويكون
معنى الآية: قال الله عز وجل هذه الأشياء، وهذا الذي ذكرناه.. تقع في يوم ينفع
الصادقين؛ أي هذا الجزاء يقع يوم نفع الصادقين.
وعلى القراءة
الثانية -قراءة الرفع- يُعرب «يوم» خبراً للمبتدأ «هذا»، ويكون المعنى هنا: أي هذا
اليوم يوم منفعة الصادقين.
بناء على ما سبق،
فإن علاقة النحو بعلوم القرآن تعد علاقة متبادلة؛ حيث يعد القرآن الكريم وقراءاته
مؤثرة في تقعيد النحو العربي باعتباره المصدر الأول من مصادر الاحتجاج اللغوي، وفي
الوقت نفسه يعد النحو بقواعده مؤثراً في استنباط المعاني والدلات المختلفة للنص
القرآني المعجز.
اقرأ أيضاً: