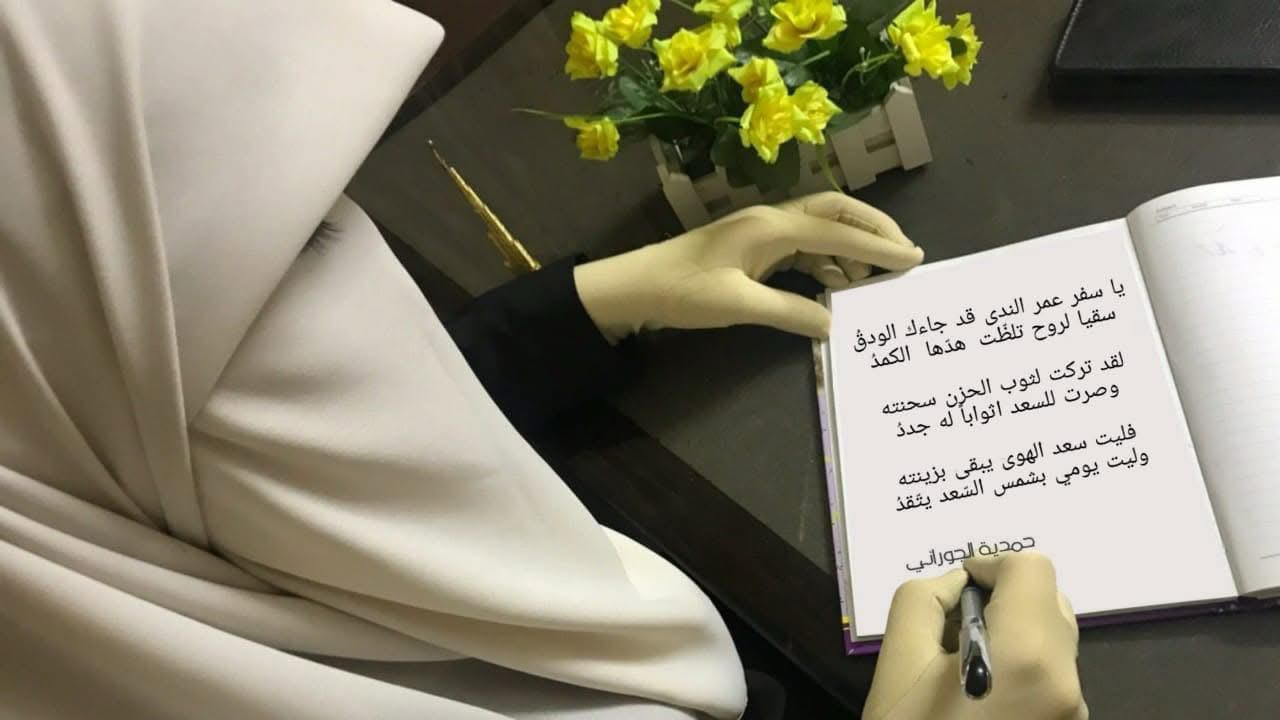أنفاس الوحي (3)
نوح.. بين رجاء الأب وحكمة الربّ
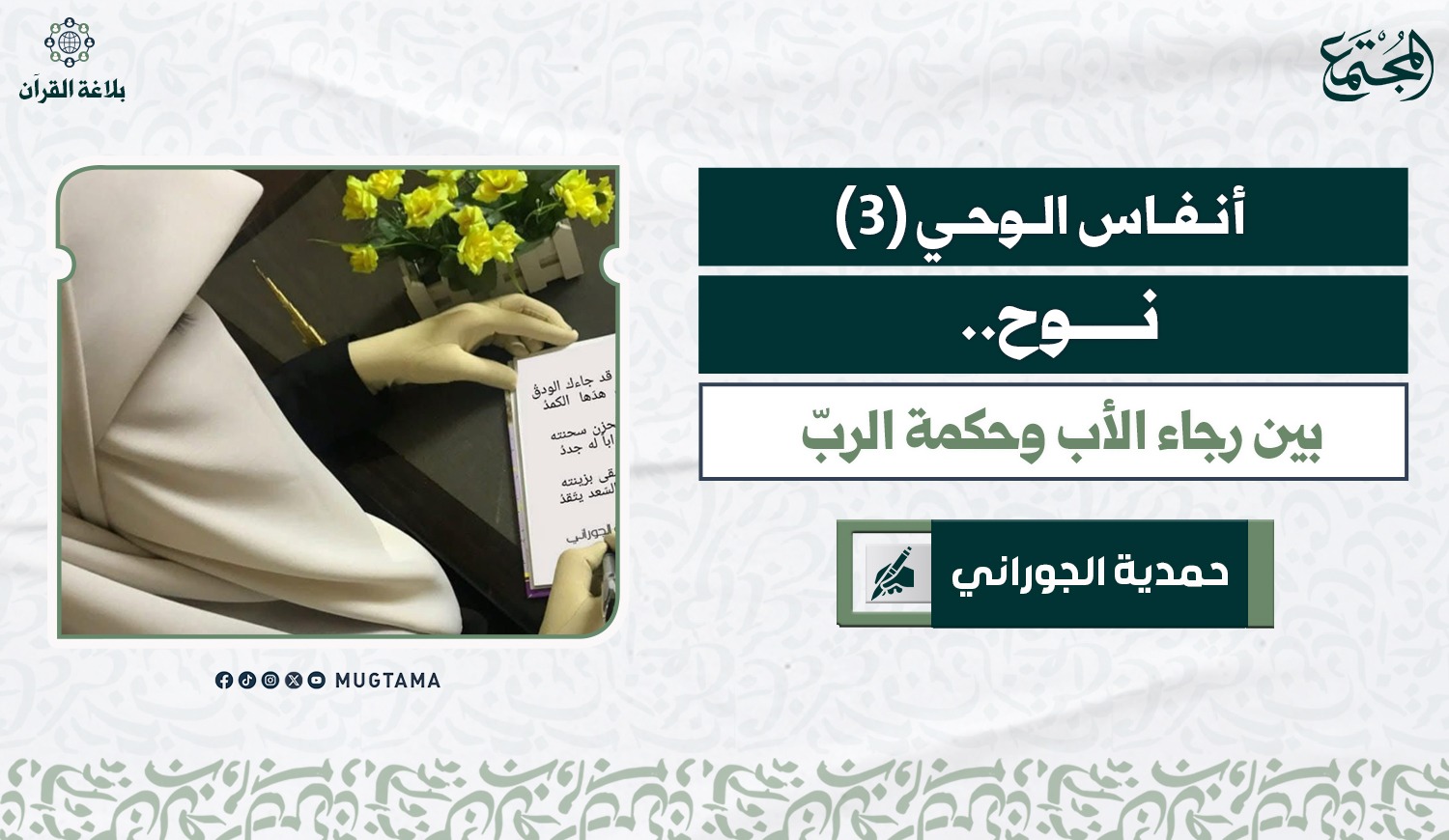
انفضَّت المعركة بين الإيمان والكفر،
وارتفعت المياه حتى صارت الجبال كالأقزام أمام زحف القدر، نوح عليه السلام، الشيخ
النبيّ، يطلّ من عتبة السفينة، والموج بينه وبين ابنه حائطٌ من مصيرٍ لا يُردّ، قبل
لحظاتٍ كان النداء الأبويّ يعلو في الهواء المشبع بالرعب: (يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ
الْكَافِرِينَ) (هود: 42)، لكنّ الابن اختار الجبل، وترك السفينة تمضي بثقل
الحزن ونجاة الإيمان.
ثمّ حين ابتلع الماءُ كلّ صوتٍ إلا صدى
الموج، نادى نوح ربّه بنداءٍ يقطر وجعًا وأدبًا، جاء استهلالاً لمشهد حواري ينقله
التعبير القرآني في الآيات: (وَنَادَى
نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ {45} قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ
مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ {46} قَالَ رَبِّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ
تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ) (هود).
مدخل بلاغي: بين الموج والعقيدة
تأتي قصة نوح وابنه في لحظة فارقة من
تاريخ الرسالات، حين تتقاطع الرحمة النبوية مع القضاء الإلهي، ويتجلّى المشهد
القرآني في ذروة الصراع بين العاطفة والإيمان ليبدأ هذا النداء: (وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ
رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ)، في هذا النداء نلمحُ نبرةَ أبٍ يتهدّج صوته بالرجاء، لكنّه
لا يخرج عن أدب النبوّة ولا يجاوز حدود الدعاء، إذ جمع بين الاسترحام والتسليم؛ الاسترحام
في قوله: (إِنَّ ابُنِي مِنْ
أَهْلِي)، والتسليم في قوله: (وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ)، ثم الإقرار بالحكمة الإلهية في: (وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ).
إنها بنية دعاء متكاملة تتّزن بين
العاطفة والعقيدة، بين الدمع والعقيدة الصلبة، في لوحة بلاغية تتجلّى فيها فصاحة
النبوّة لا عجز الأبوة، فيها رجفةُ الأب، وطمأنينةُ النبيّ، وموازنةُ من تربّى على
التسليم، لكنّ الجواب الإلهيّ جاء كالفجر بعد الليل؛ حاسمًا، واضحًا، لا غموض فيه
ولا مجاملة للعاطفة.
الجواب الإلهي: الفصل بين نسب الدم ونسب الإيمان
جاء الجواب الإلهي سريعًا، كأنّ السماء
حسمت السؤال قبل أن يكتمل الرجاء: (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ
صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن
تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)؛ يا له من خطابٍ مهيب: نداءٌ لصفة النبوّة لا
صفة الأبوة، عتابٌ في صيغة تعليم، ورحمةٌ بهيئة حزم، إنها لحظة فصلٍ بين نسبين؛
نسب الدم، ونسب الإيمان.
فالأول انقطع بالموج، والثاني امتدّ
بالوحي، حينها أطرق نوح رأسه، وقد أدرك أنّ الحبّ لا يصنع الهداية، وأنّ القرابة
لا تُغيّر القضاء، فقال في خضوعٍ يليق بأنبياء التسليم: (قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا
لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ
الْخَاسِرِينَ)، ما أبلغ هذا الختام! الذي بدأ بنداءٍ رجائيّ ختمه النبيّ
بالاستغفار، كأنّ الدعاء نفسه اغتسل في بحر التوبة، فعاد إلى الله أكثر صفاءً
وأشدّ قربًا.
البنية الأسلوبية العامة للحوار
المشهد يُبنى على تصعيدٍ عاطفي متدرّج ثم
انكسارٍ روحيّ خاشع: النداء ←
العتاب الإلهي ←
الاعتذار والاستغفار، وهو بناء ثلاثيّ يعكس حركة النفس البشرية بين الرجاء
والرجفة، وبين السؤال والخضوع.
التحليل الأسلوبي لنداء نوح لربّه
(وَنَادَىٰ
نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي):
الفعل «نادى» يوحي ببُعدٍ ومحنة؛ النداء لا يكون إلا مع مسافة أو انقطاع صوتي،
وكأنّ نوحًا ينادي من وراء طوفانٍ هادرٍ وصخبٍ مائيٍّ هائل.
إضافة «ربه» إليه تعبير عن العلاقة
الخاصة بين العبد وربه، ويفتح مدخلًا عاطفيًّا حارًّا.
النداء المتكرر «ربّ» (مرتين في الآيات
الثلاث) يحمِل توسلًا وتلطّفًا؛ فنداؤه الأول نداء رجاء، والثاني نداء توبة.
استخدم «إنَّ» لتوكيد الخبر، كأنه يذكّر
بوعد الله السابق: (احْمِلْ
فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ) (هود: 40)، الجملة
تُبنى على التذكير بالوعد لا الاعتراض عليه، أي توسل ضمني بلغة تحمل في ثناياها
مشاعر خاصة.
توظيف العبارة بطلب الإنقاذ كفرصة أخيرة
من أب فاقد لأمل النجاة بابنه توكيد تتقاسمها ألفاظ القرابة والدم (ابن، أهل)
وتكرار ضمير المتكلم (الياء) يشي بإلحاحه على هذا القرب.
(وَإِنَّ
وَعْدَكَ الْحَقُّ): توكيد ثانٍ، لكن
بمستوى أسمى؛ تحوّل من المطلب العاطفي إلى الإقرار العقائدي، وكأنه يقول: أنا لا
أشكّ في وعدك، ولكني أرجو تأويله بلطفك.
(وَأَنتَ
أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ): ختام بلاغي فيه إحالة
إلى صفة الحكمة لا إلى القدرة، ليكون سؤال نوح أدبًا لا خصومة، الجملة بتركيبها
الاسميّ تُوحي بالثبات واليقين، والتكرار الاشتقاقي بين «أحكم» و«الحاكمين» فيه
توكيد على حكمة الله في تقدير المقادير، وجاء الضمير «أنت» لقصر الحكمة على الله
جل جلاله.
تحليل جواب الرب: بنية تقويم التصور
(يَا
نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ):
أسلوب النداء الإلهي يبدأ بـ«يا نوح» نداء تقويم لا عتاب، يقطع الانفعال ويعيده
إلى ميزان العلم.
تعاضد أسلوب التوكيد وأسلوب النفي في
قوله تعالى: «إنه ليس من أهلك»، بحرف التوكيد «إنّ»، وأسلوب النفي «ليس»، ليؤكد
فكرة ثابتة أن الحقيقة في الإيمان لا في النسب.
(إِنَّهُ
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ): جملة تحمل نقلة
بلاغية من النسب إلى العمل، أي من الدم إلى القيمة، وفيها استعارة مضمَرة؛ إذ
صُوّر الابن نفسه كأنه عمل؛ أي أنّ الإنسان يُوزن بفعله وعمله لا بأصله، وتوظيف
المصدر «عمل» دون الفعل «عمل» لما في المصدر من ثبات.
(فَلَا
تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ):
أسلوب نهي لكنه خرج عن الزجر إلى أسلوب التعليم الرحيم، والتعبير بـ«ما ليس لك به
علم» أدقّ من قول «ما لا تعلم»؛ إذ يحمل معنى الاختصاص؛ أي أنّ هذا الأمر ليس من
دائرة علمك ولا ولايتك.
(إِنِّي
أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ):
جملة عاطفية شديدة اللطف؛ فالوعظ هنا بديل عن العقوبة أو الغضب، وفيها طباق بين
الحكمة والجهل، ليعيد التوازن النفسي للنبي بعد اضطراب الألم.
ختام المشهد: بنية التوبة والاستغفار
(قَالَ
رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ):
تكرار النداء «ربِّ» للمرة الثانية يعيد نغمة الخضوع بعد أن كان النداء الأول نغمة
رجاء.
أسلوب الاستعاذة أبلغ من الاعتذار، فهو
يتبرأ من نفسه قبل أن يُعاتَب، وتقديم «بك» يفيد الحصر؛ أي بك وحدك لا بغيرك.
تقديم الجار والمجرور «لي به» يفيد
الاهتمام والاختصاص بتقديمهما على اسم ليس «علم».
الجملة الشرطية في قوله: (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ) تمثل قمة الانكسار؛ إذ صاغ
التوبة في شرط وجودي يربط نجاته بالرحمة الإلهية وحدها.
توظيف الأفعال المضارعة في سياق الشرط
هنا في جملة فعل الشرط «تغفر، ترحم»، ثم ليأتي جواب الشرط «أكن» بصيغة المضارع
كذلك، غاية اقتران سبب النجاة بمغفرة الله ورحمته وانتفاء الكينونة ضمن جماعة
الخاسرين.
شواهد من السيرة النبوية والإسقاط المعاصر
يتردّد صدى هذا المشهد في موقف النبي صلى
الله عليه وسلم من عمّه أبي طالب، حين قال بحرقة الإيمان: «لأستغفرنّ لك ما لم
أُنهَ عنك»، فنزل قوله تعالى: (إِنَّكَ
لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ) (القصص: 56)،
كلا المشهدين يشهد على أن الهداية ليست امتداد الدم، بل نفحة من العلم والاختيار، وفيهما
يُربَّى الأنبياء والأمّة على أن العاطفة لا تملك تغيير القضاء، وأن المحبة لا
تُغني عن الإيمان.
في عالم اليوم، حيث تختلط الموازين بين
القرابة والمبدأ، وبين المجاملة والحق، تأتي قصة نوح لتعيد رسم الحدود؛ كم من أبٍ
يرى أبناءه يغرقون في طوفان المادة واللهو، فيناديهم بنداء نوح: يا بني اركب معنا!
لكنّ السفينة اليوم ليست من خشب، بل من قيمٍ وإيمانٍ وموقفٍ صادق، ومن أراد النجاة
فعليه أن يعتصم بالجوديّ المعنويّ: ثبات العقيدة في زمن التيه.
القيم التربوية المستخلصة
- أن الهداية بيد الله وحده، لا تنال
بالمحبّة ولا القرابة.
- أن الإيمان معيار الانتماء الحقيقيّ،
والنسب مجرّد إطارٍ دنيوي.
- أن الأبوّة الصادقة لا تُبرّر السكوت
عن الكفر، بل تدعو وتبكي وتسلّم.
- أن البلاء في الأولاد امتحان للثقة
بالوعد الإلهيّ.
- أن التربية الإيمانية أسمى من الروابط
الاجتماعية.
الموج الذي لم يطفئ الإيمان
حين انقطعت صلة نوح بابنه، لم تنقطع صلته
بالله، كان الموج يفصل بين جسدين، لكنّ الوحي كان يوصل بين قلبٍ وأمرٍ إلهيّ لا
يتبدّل، وهكذا علّمنا القرآن أن النجاة ليست من الطوفان، بل من الاضطراب الداخليّ،
وأن من أراد أن يكون من أهل الله فليجعل إيمانه سفينته، ولو غرق كلّ من حوله، (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ
إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) جملة واحدة حطّمت سلالات الدم، وبنت أمّةً
من الإيمان.
اقرأ أيضا: