منهج النبي ﷺ في التربية والتعليم.. أساليب فريدة لبناء الإنسان
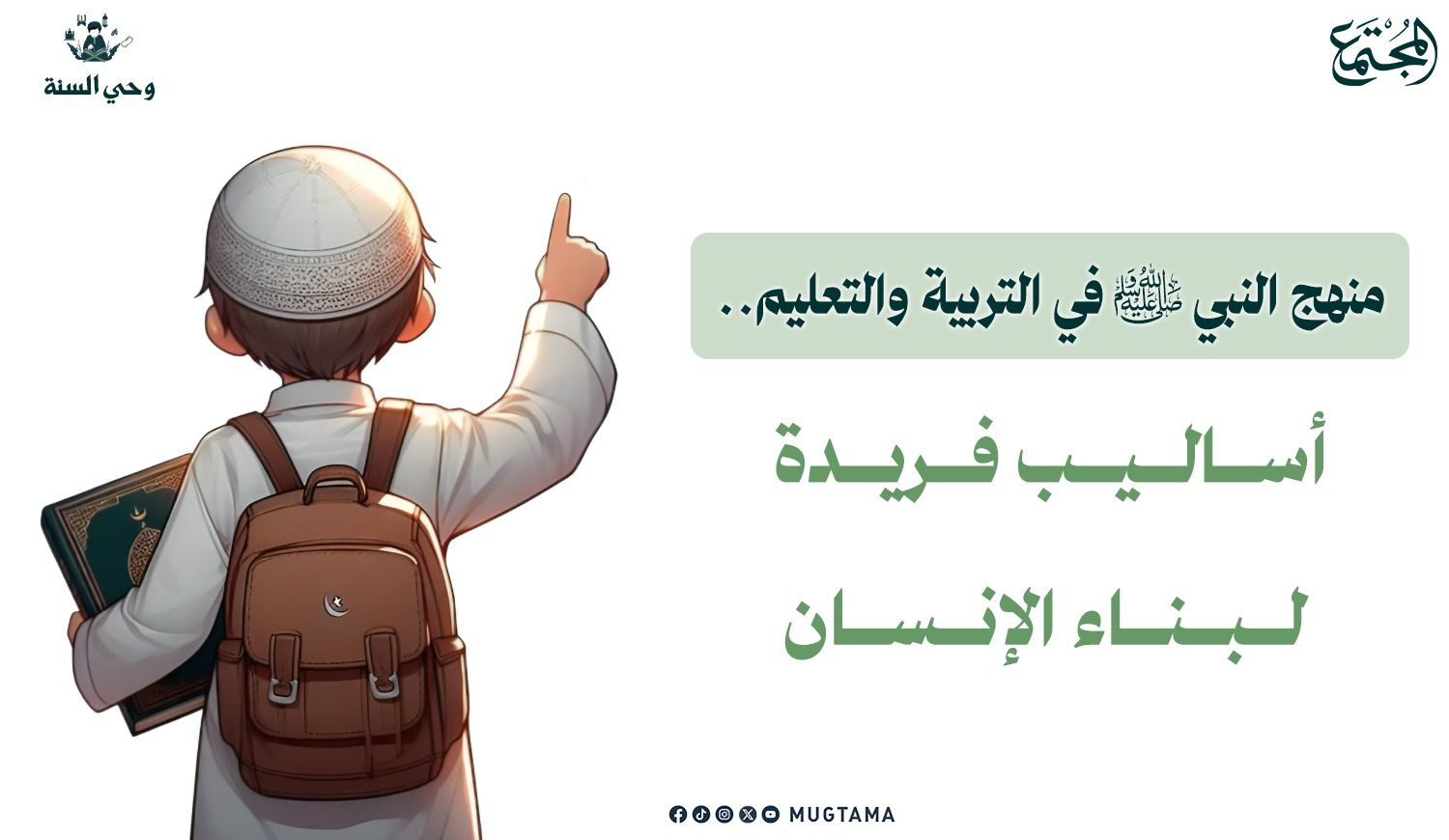
لم تكن بعثة
النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تبليغ لرسالة عقائدية لاهوتية داخل جدران المسجد
وتتوقف عند علاقة العبد بربه، بل كانت مشروعاً تربوياً حضارياً متكاملاً، يشمل
مظاهر الحياة جميعها، اعتمد على منهجية علمية واضحة ومحددة، مشروع لإعادة صياغة
الإنسان من جديد، مشروع يعلم الإنسان كيف يزكي نفسه ويعمر الأرض، وقد جمع هذا
المنهج بين التربية القلبية والسلوكية، والتعليم المعرفي والعمل؛ قال تعالى: (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) (الجمعة: 2).
ومن خلال هذا
المنهج التربوي القويم، أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيلاً فريداً من الصحابة حملوا
الرسالة وانطلقوا بها في أرجاء الدنيا فاتحين، وتبييناً لملامح هذا المشروع
التربوي الضخم، نذكر أبرز معالم منهجية النبي صلى الله عليه وسلم تربوياً وتعليمياً
في ضوء كتاب الله وسُنة نبيه الكريم:
أولاً: الشمول والجمع بين التربية والتعليم:
لم يتوقف منهج
النبي صلى الله عليه وسلم في تكوين الشخص المسلم على جانب معرفي واحد كما يتم في
التعليم في بعض بلادنا بتركيزه على جانب من المعارف الدنيوية؛ ما نتج عنه جيل من
الأطباء والمهندسين والمعلمين والمفكرين لا ينتمون لفكر أو دين أو هوية، كل ما
يهمهم هو التقليد الأعمى للغرب في مظاهره، فافتقد المجتمع لمظاهر الدين والأخلاق
والصدق.
فقد اعتمد
المنهج الإسلامي على فكرة الشمول المعرفي، أو الشمول المنهجي، حيث لا قيمة لعلم
بلا أخلاق، يقول تعالى: (هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)؛ حيث التزكية
والتعليم ركيزتان متلازمتان.
ثانياً: التربية بالقدوة:
اعتمد النبي صلى
الله عليه وسلم أسلوب التربية بالقدوة؛ حيث إنه النسق الإنساني المعتمد من الله
تعالى كقدوة للإنسانية بشهادة رب العالمين الذي يقول: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ) (الأحزاب: 21)، وبرواية عائشة رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن»
(رواه مسلم).
ومثل الداعية
والمربي الذي يهتم بالمربين وينسى نفسه كما صوره النبي عليه الصلاة والسلام
بالسراج المطفأ، فعن جندب بن عبدالله: «مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ
النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ
وَيَحْرقُ نَفْسَهُ» (رواه الطبراني).
ولذلك، فكثير من
المناسك والشرائع غير موضحة في كتاب الله، ولم تتعلمها الأمة إلا من خلال فعل
النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة على سبيل المثال، ففيها قال صلى الله عليه وسلم:
«صلُّوا كما رأيتموني أصلي»، وفي الحج قال: «خذوا عني مناسككم»، وقد استنكر القرآن
أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون، وينصحون الناس بما لا يقدمون، فيقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ {2} كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا
مَا لَا تَفْعَلُونَ) (الصف).
ثالثاً: التعليم بالتدرج والمرحلية:
من سمات منهجية
النبي صلى الله عليه وسلم التدرج في التعليم، حيث بدأ بتثبيت العقيدة والتوحيد، ثم
انتقل إلى التشريعات، مراعاة لطاقات الناس واستعدادهم، قال تعالى: (وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ
لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ) (الإسراء: 106)، وفي التشريع
الواحد تم تطبيقه على الناس بالتدريج كما تم في تشريع تحريم الخمر بداية من عدم
معاقرتها في الصلاة، ثم تحريمها بشكل مباشر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر،
وفَرِّقوا بينهم في المضاجع» (سنن أبو داود).
وفي حديث معاذ
بن جبل لما أرسله إلى اليمن، فقال له فيما رواه ابن عباس: «إنَّكَ تَقْدَمُ علَى
قَوْمٍ مِن أهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى أنْ
يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذلكَ، فأخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ
فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَومِهِمْ ولَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا،
فأخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم زَكَاةً في أمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِن
غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ علَى فقِيرِهِمْ، فَإِذَا أقَرُّوا بذلكَ فَخُذْ منهمْ،
وتَوَقَّ كَرَائِمَ أمْوَالِ النَّاسِ» (أخرجه البخاري).
رابعاً: التعليم بالرفق والرحمة:
لقد كان سمت
النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة في كل أمره، خاصة في التربية والتوجيه للناس، فمن
أقواله عليه الصلاة والسلام: «إنما بعثت معلماً» (رواه ابن ماجة)، وكان التعليم
عنده ممتزجاً بالرفق، إذ قال: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» (صحيح
البخاري).
ومن مواقفه
التربوية؛ عن أبي هريرة أنه قال: دخَلَ أَعْرابِـيٌّ الـمَسجِدَ فصلّى
رَكْعَتَينِ، ثم قال: اللَّهمَّ ارْحَـمْني ومحمدًا، ولا تَرْحَمْ معنا أَحَدًا،
فالتفَتَ إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «لقد تـحجَّرْتَ واسِعًا»، ثم
لَـمْ يَلْبَثْ أنْ بال في الـمَسجِدِ، فأسْرَع النّاسُ إليه، فقال لَهم رسولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّما بُعِثْتُم مُيَسِّرين، ولَـمْ تُبْعَثوا
مُعَسِّرين، أَهْرِيقوا عليه دَلْوًا مِن ماءٍ، أو سَجْلًا مِن ماءٍ» (أخرجه
البخاري).
خامساً: أسلوب الحوار والسؤال:
اعتمد النبي صلى
الله عليه وسلم الحوار والسؤال أداةً للتعليم. قال: «أتدرون من المفلس؟»، ثم
أعطاهم الجواب الذي رسّخ المعنى (رواه مسلم)، ومنه ما رواه الإمام أحمد في مسنده
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«تدرونَ مَنِ المسلمُ؟»، قالوا: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ، قالَ: «مَنْ سَلِمَ
المسلمونَ من لسانِهِ ويدِهِ»، قالَ: «تدرونَ مَنِ المؤمنُ؟»، قالوا: اللَّهُ
ورسولُهُ أعلمُ. قالَ: «من أمِنَهُ المؤمنونَ على أنفسِهِم وأموالِهِم، والمُهاجرُ
مَنْ هَجَرَ السُّوءَ فاجتنبَهُ»(1).
وقد أشاد خبراء
التربية والتعليم بهذا الأسلوب؛ حيث إنه يثير الانتباه والتفكير وينشط الذاكرة،
ويحيل المتلقي لمستمع إيجابي فعال بدلاً من السلبية وأسلوب التلقين، فكان هذا
الأسلوب يثير التفكير، ويحول المتلقي من مستمع سلبي إلى مشارك فعّال.
سادساً: التربية بالقصة والمَثل:
استخدم النبي
صلى الله عليه وسلم القصص والأمثال لتقريب المعاني؛ فتزخر السيرة النبوية بحكايات
السالفين من الأنبياء والصالحين وغيرهم للاعتبار والتعلم بصورة غير مباشرة، فعلى
سبيل المثال قص قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، لتعليم قيمة الدعاء والعمل الصالح
وقد وردت في صحيح البخاري، كما شبّه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة (صحيح
البخاري).
والتربية بالقصة
هي طريقة مؤثرة ومن الأدوات التعليمية الناجعة في توصيل المعلومة والهدف من ورائها
والمغزى منها بشكل سلس، حيث إنها تخاطب الوجدان وتثير مشاعر المتلقي.
سابعاً: التكرار والمراجعة:
كان النبي صلى
الله عليه وسلم يكرر الكلمة 3 مرات ليؤكدها، فعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان إذا تكلَّم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه» (رواه البخاري)، وقوله صلى
الله عليه وسلم: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاثًا، قَالُوا:
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ
الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا- فَقَالَ: أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ»،
قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. (رواه البخاري).
كما أوصى
بمراجعة القرآن باستمرار، فقال: «تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد
تفلّتاً من الإبل في عقلها» (صحيح البخاري)، ومن الأساليب التربوية الحديثة عملية
التكرار لأن التكرار يمنح المتعلم المزيد من الثبات والحفظ.
ثامناً: مراعاة الفروق الفردية:
كان النبي صلى
الله عليه وسلم يراعي اختلاف قدرات المتعلمين، فيعطي كل سائل جواباً يناسب حاله،
فسُئل: أي العمل أفضل؟ فقال لواحد: «الصلاة على وقتها»، ولآخر: «بر الوالدين»
(صحيح مسلم).
ويتضح ذلك أكثر
من خلال ما رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبيِّ
صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فجاء شابٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ، أُقبِّلُ وأنا
صائمٌ؟ قال: «لا»، فجاء شيخٌ فقال: أُقبِّلُ وأنا صائمٌ؟ قال: «نعم»، قال: فنظر
بعضُنا إلى بعضٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «إنَّ الشيخَ
يملِكُ نفسَه» (مسند أحمد).
_______________
(1) مسند الإمام
أحمد، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث – القاهرة، ط:1، 1416هـ/ 1995م، ج 6،
ص398، (6925).

















