الدين والتديّن لدى اليهود بين الحقيقة والتصنّع البراغماتي.. الجذور التاريخية والواقع الراهن (6)
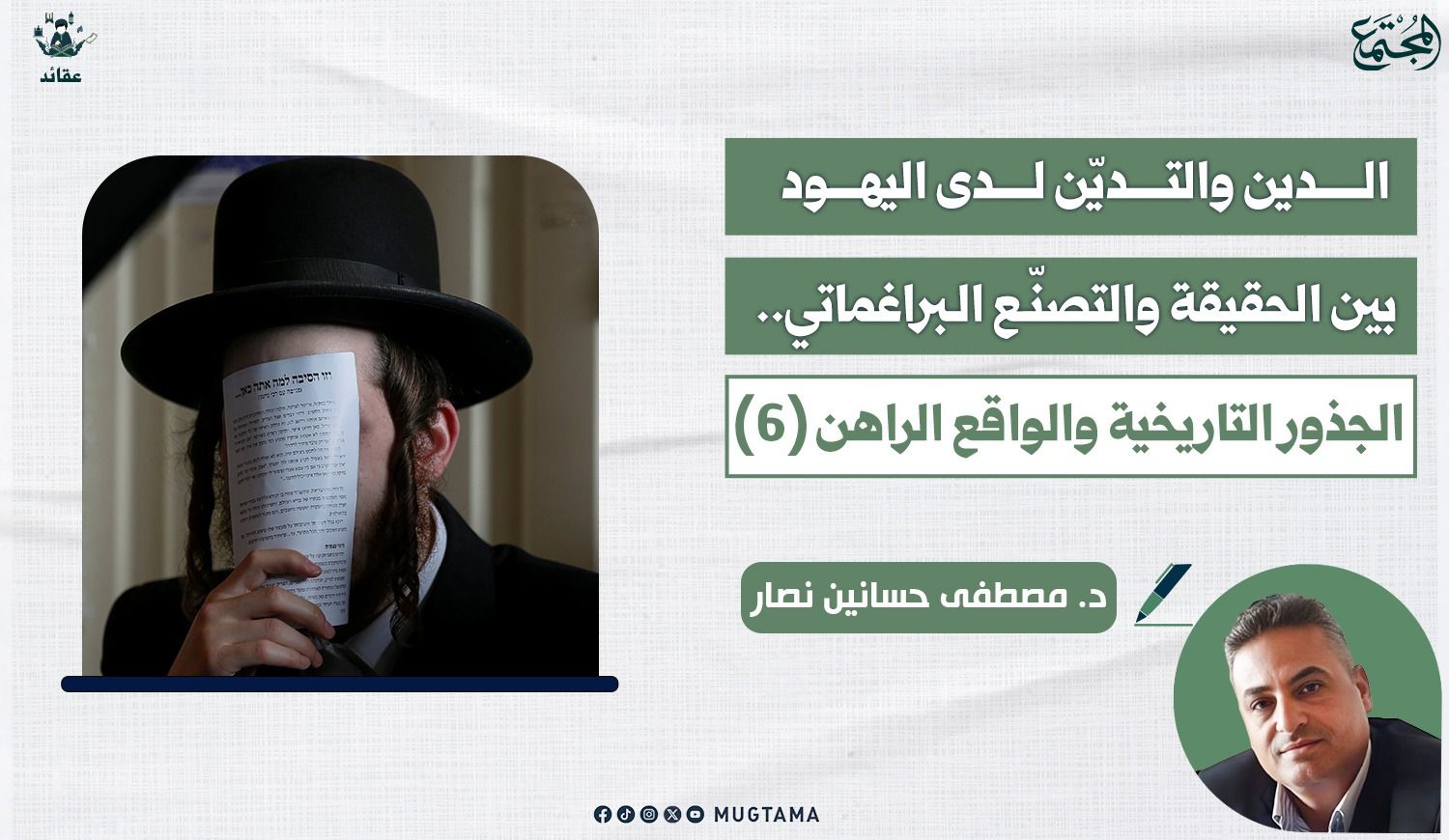
عرضنا في
الأجزاء الخمسة السالفة الأسس العقدية والأخلاقية لهؤلاء من خلال كتابهم المقدس العهد
القديم، وعلى رأسه أسفار التوراة الخمسة، وأظهرنا ما به من كوارث ونزعات شيطانية، تنطوي
على رذائل وفواحش، وإجرام، وتشويه وافتراءات في حق الله تعالى، ثم في حق أنبيائه
ورسله، ومن ثم في حق الإنسانية بأسرها.
ونصل في هذا
المقال إلى استخلاص النتائج، وتحليل ما عرضناه، وانعكاساته القاتلة على البشرية
عموماً، وربطه بمسلك هؤلاء المجرمين في دروب الحياة رأسياً وأفقياً، حتى نتعرف على
الحقيقة العميقة للقوم، لكن قبل هذا ثمة نقاط توضيحية لا بد منها:
- نؤمن بالشريعة
اليهودية الحقة المنزلة من لدن الله تعالى، ونؤمن بأنبياء بني إسرائيل وجميع
أنبياء الله ورسله، لكن هؤلاء الناس حرفوا شريعتهم وشوهوها وطمسوا أصولها الحقيقية
بحيث أُفرغت من مضمونها وأضحت شيئاً آخر.
- مع هذا لا
ننكر احتمال وجود نصوص سماوية حقيقية ما زال يحويها العهد القديم فعلاً، لكنها إن
وُجدت فلا بد أنها من الندرة بمكان، بحيث إنها تاهت في خضم تلال الأباطيل
والأكاذيب والخرافات والتعاليم الشيطانية المدسوسة بين دفتيه.
- كل ما عرضناه
منقول نصاً من عهدهم القديم «المقدس» وفي القلب منه التوراة.
أولاً: منهجهم في التحريف وعلاقته بإشاعة الشرور والفواحش في الجنس البشري:
على عكس ما هو
متوقع في سياق كهذا، سنعمل على تحديد قسمات منهجهم التحريفي، وأهدافه، عبر رصد
العواقب، واستخلاص النتائج التي من شأنها التمخض عن هذا التحريف، وهي النتائج التي
تماهت معها بالفعل توجهات بشرية شيطانية على مدار حلقات التاريخ البشري وحتى يومنا
هذا، حتى إن الأمر يبدو وكأن هذه التوجهات قد حِيكت على منوال هذا التحريف، أو
كأنه خيط ممتد عبر التاريخ كانت بدايته ما أرساه القوم من خلال نهجهم التحريفي هذا
ومخرجاته، تلك المخرجات التي نلخصها فيما يلي:
1- عندما يقدم
كتابهم «المقدس» تصورات هزلية عن الله جلّ في علاه، ويلصق به صفات بشرية، كتناول
الطعام والمشي على الجبال والتصارع البدني مع بعض خلقه، بل وانتصار بعضهم عليه،
وارتكاب الأخطاء والندم عليها، فهم بهذا ينفون القدسية عن الله، أو على الأقل
ينتقصون منها إلى حد بعيد، ويميّعون فكرة الألوهية من الأساس، وينزعون المهابة
نحوها من النفوس؛ ما أوجد أرضية خصبة وملائمة لانتشار الإلحاد، وما يمكن أن نطلق
عليه «الإلحاد المقنع»؛ أي اعتناق الدين بالوراثة والبقاء عليه اسماً لا رسماً، أو
لأغراض براجماتية مع عدم نفاذ نوره إلى الأفئدة مطلقاً.
2- عندما ينسب
كتابهم المقدس أوامر مباشرة وصريحة من الله تعالى، بالتعامل بوحشية لا متناهية مع
البشر والنبات والحجر، بل وحتى مع الأجِنّة في بطون أمهاتهم، فهم بهذا يشرعنون هذه
الوحشية ويُكسبونها أساساً دينياً إلاهياً، ويؤسسون لمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، وهو
عين ما يفعله أحفادهم اليوم في فلسطين وغيرها من مجازر لا تبقي ولا تذر، بلا سقف
وبلا مبرر، رافعين راية اليهودية، ومرددين نصوصهم الدينية المزعومة!
3- عندما تنسب
نصوصهم الدينية إلى أنبياء الله المرسلين إليهم موبقات السُّكْر والزنى، بل وزنا
المحارم، حاشاهم عن هذا، فهم بهذا ينزعون عن أنبياء الله أي نوع من العصمة أو حتى
الفضيلة بوجه عام، ويضربون فكرة الدين السماوي ذاتها في مقتل، بالإضافة إلى أن هذا
من شأنه تهيئة النفس البشرية للتطبّع بهذه الرذائل، خصوصاً أن أسفار العهد القديم
لم تستنكر هذه المخازي أو تقدمها كأفعال شائنة، بل عرضتها على أنها أمور طبيعية لا
غضاضة فيها أبداً.
4- عندما يوجه
كتابهم المقدس الفقراء لمعاقرة الخمر، باعتبارها حلاً ناجعاً ينسيهم أزماتهم
ويلهيهم عن مآسيهم، فهو أو بالأحرى من حرّفوه يروّجون لتناول الخمر دون أدنى
اكتراث، أي باعتباره أمراً عادياً طبيعياً، بل ومفيداً ومحموداً، كونه إحدى وصايا
الرب.
وهذا هو النص: «ليس
للملوك أن يشربوا خمراً ولا للعظماء المسكر، لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيّروا
حجة كل بني المذلة، أعطوا مسكراً لهالك، وخمراً لمرّي النفس، يشرب وينسى فقره، ولا
يذكر تعبه بعد« (الأمثال: 31/ 6).
لماذا استغلوا تحريفهم لنشر الفواحش؟
وبعد، فقد كان
طبيعياً أن تنتشر العنصرية والفظاظة والجرائم الوحشية بشكل يفوق كل تصور، كما كان
طبيعياً أيضاً أن تتفشّى الموبقات الجنسية وغيرها، لتغطي مساحة هائلة من حياة
الجنس البشري، التي استفحل أمرها في عصرنا الحديث، لا سيما في بلاد الغرب التي
تمثل معقلها ونقطة انطلاقها، كما أنها آخذة في الرواج بين شعوب الشرق إلى حد ما.
ولمَ لا ونصوص
الكتاب المقدس بعهديه، القديم والجديد، تطفح بصور لا حصر لها من هذه الجرائم
والموبقات، والأدهى أنها لم ترد في سياقات الزجر والعبرة والدعوة إلى استبصار
عواقبها؟
ولمَ لا وعدد من
هذه القصص بما تحمل من وحشية، وقصص فاجرة داعرة، قد أوردتها نصوصهم المقدسة على
لسان الله تعالى، حاشاه؟
ولمَ لا والجزء
الأكبر من هذه الموبقات المهلكات اقترفها أنبياء الله ورسله، وتضمنها كتابهم
المقدس في شكل نصوص دينية تُتلى عبر الأجيال ويُتعبّد بدراستها وترديدها، دون أن
تسجل هذه النصوص ولو مجرد عتاب من الرب لأنبيائه على هذه البشائع، وهم الذين
أرسلهم لهداية خلقه؟!
أليس هذا النهج
مستشرياً في عالم اليوم ومدعوماً سياسياً وإعلامياً، وبلا أي اعتراض أو تحفظ من
أبناء العهد القديم، والجديد أيضاً، بوصفهم أصحاب شرائع سماوية؟!
إرث من الفساد الأخلاقي
ولا يعني هذا
أننا نحمّل هذه الأسفار المحرَّفة وحدها مسؤولية الشرور والفواحش على الأرض، إلا
أنها شكّلت أساساً قوياً لها، باعتبارها نصوصاً دينية سماوية، وعليه فجميع ما فيها
مدموغ بالشرعية العليا، شرعية الرب وأنبيائه ورسله وكتابه المقدس؛ ما يسهّل تسربها
للوجدان ويساعد النفوس على تمثلها والتطبع بها، دون أي مقاومة داخلية من ضمير أو
وازع ديني!
يقول ول
ديورانت: «مهما يكن من أمر هذه الكتابات الغرامية فإن وجودها في العهد القديم سر
خفي.. ولسنا ندري كيف غفل أو تغافل رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف
شهوانية، وأجازوا وضعها في الكتاب المقدس!» (قصة الحضارة، ج 3، ص 388).
أما برنارد شو
فيقول عن الكتاب المقدس بوجه عام: «إنه أخطر الكتب الموجودة على وجه الأرض، احفظوه
في خزانة مغلقة بالمفتاح!» (راجع كتاب: هل الكتاب المقدس كلام الله، للأستاذ أحمد
ديدات، رحمه الله، ص 54، 70).
وكأن إبليس قد
وجد في هؤلاء، بحكم دأبهم على التمرد على الله وعصيانه، ونزوعهم للتزييف والخداع،
وحبهم للفواحش والشهوات وولعهم بنشرها، وميلهم للإجرام والاستكبار، كأنه وجد فيهم
طريقاً ممهَّداً لإغواء بني آدم، ومدخلاً رحباً يلج عبره بشروره وقاذوراته إلى
نفوسهم.

















