الالتزام الأدبي.. ميتُنا الذي يجب أن يُبعث من جديد
الالتزام الأدبي.. ميتُنا الذي يجب أن يُبعث من جديد
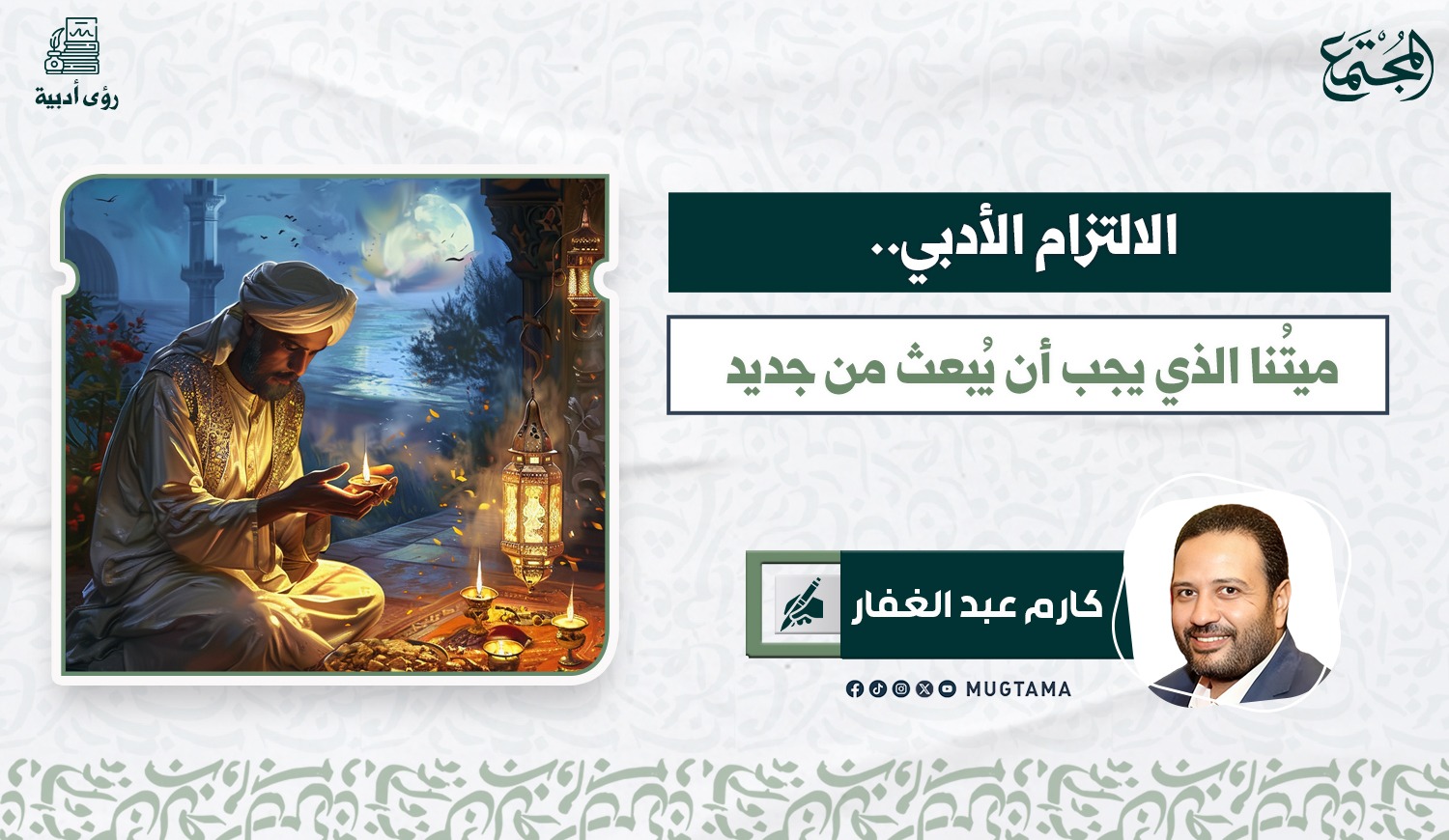
هِبة الله الكامنة في صدر المبدع هي التي تُحركه وتنعش
عزيمته وتوجه إرادته نحو إفلات ما بداخله من طاقة محبوسة، ومن أفكار تبحث عن فضاءات،
ومن ثم يتحقق له الانسجام الروحي والارتياح بالبوح والتنفيس، وتلك ضرورة إنسانية
لا يمكن تغافلها أو تقزيم موضعها في صدور المبدعين.
وقد انتبه عمر بن عبد العزيز يومًا لشيخه عبيد الله بن
عبد الله وهو ينظم شعرًا، فعاتبه في ذلك، وقال له: "ما لك والشعر؟!" فأجابه
شيخه يقرر له تجذُّر مطلوبية الإبداع في قلب صاحب الموهبة، وصعوبة التهرب منها،
فيقول: "وهل يستطيع المصدورُ إلا أن ينفُث!!". إنها جِبِلَّة الإنسان،
وحظ المبدع من خلقته المُيسر لها، ومن الحياة.
أدب يعاند الأوجاع
وإن كان إلحاح الموهبة له تقديره ورصيد التوقير في
سردياتنا العربية، قديمًا وحديثًا، فقد كان يُرافقه دومًا سؤال عن القيمة والغاية
وحجم التداخل بين منتوج الموهبة وبين حاجات الناس، وأوجاعهم، ولا نتحدث هنا عن
القيمة بمعناها الأخلاقي، ولكن نقصد الدائرة الواسعة التي يجب أن يلتزم المبدع
بالتحرك حول مركزها، وتحت ظلالها، فيعبر عن الناس وخواطرهم المحبوسة خلف ضغط
الواقع أو قلة الحيلة وعجز اللسان، فيصير الأديب والفنان، والمبدع بشكل عام، كأنه
نائب المجموع ومسئول البيان المختص بإخراج المعاني من خيالاتهم إلى الرصيف والزحام
ودنيا الناس، بما لا يضر التواثق العضوي بين روحه وأنفاس الناس.
وفي حديثه عن حاجة الإنسانية إلى إنتاج له معنى، وإلى قيمة
تحرض على الجمال، كتب خليل أحمد خليل منذ ستينيات القرن الماضي واصفًا ما يعنيه
الالتزام الأدبي في الشعر والإبداع عمومًا بأنه
"ابن العقل والفكر فهو دعوة الكلمات إلى الأيادي لتحول الأشياء، وتولد
في الأرض حقولًا خضراء تستقبل الأجيال الأخرى بصدر أكثر حنانًا وحبًّا، والمناضل هو
كالطاحون يعصر زيت وجوده ليضيء مصباح الحياة في بيوت الفلاحين والعمال في بيوت تجاوزت
أرض القارات العتيقة لتتصل بالتاريخ عبر زمن عملي معاش".
وقد تبلورت فكرة الالتزام في الأدب الحديث بإطاره النقدي
تحت ضغط الحاجة الغربية لبوصلة اجتماعية توجه صاحب الموهبة، وتنقله من برجه العاجي
إلى ساحة الاندماج مع مجتمعه؛ حيث ظهر مصطلح أدب الالتزام أو أدب المواقف نتيجة
لتأثير الأيديولوجيات الحديثة على الأدب، التي تشترك، بالرغم من تعددها وتباينها،
في شيء واحد وهو أنها تعكس المتغيرات الاجتماعية السريعة لعصرنا – بحسب ما يقول
الناقد الأدبي هيرمان نورثروب - ومن أجل ذلك فإن هذه الأيديولوجيات تجبر كل امرئ
منا على أن يعيد فحص موقفه نقديًّا من العالم، ومسئوليته نحو الآخرين، وتحت
تأثيرها ينظر الكاتب - بصفة خاصة - إلى عمله من منظور جديد، أي إنه يلزم نفسه على
اتخاذ موقف.
عقيدة تهزم القبح بالإبداع
وإن كان ذلك الدافق الإنساني قد تيقَّظ لدى شريحة من
مبدعي الغرب – فيما يخص مجتمعهم - بشكل خاص ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبسبب ما
نال الإنسانية من ويلاتها؛ حيث إن التجربة الحضارية والإحساس القوي وحتمية
المشاركة جعلت الفنان يتصدى لمشاعر القلق والظلم والتمزق، وغيره مما أصبح من سمات
عصرنا، كما يرجِّح دكتور رجاء عيد، وهو مع ذلك لا يتمثل ذاته بقدر ما يتمثل ذوات
الآخرين الملتصقين بلحمه وعظمه، وهو يضمد جراح الإنسانية التي تبتلع المشكلات
ماضيها وحاضرها، وتكاد تستعد لالتهام مستقبلها وهو في المخاض.
نقول إن كان هذا الدافق قد فعل فعله في المبدع الغربي
وحرَّكه تجاه قضايا مجتمعه، ولو بشكل نسبي، فإن الحافز في مجتمعنا الشرقي العربي
المسلم أقوى وأعمق وأصدق وأقدم؛ فالمسلمون والعرب بشكل خاص يتوافر لديهم بساط روحي
متسع لأعمال الخيال والخواطر ومنتوج المواهب، ويتيح الجانب الإيماني للمبدع أن
يشبع شغفه البطولي بالانضمام الناعم لصفوف المصلحين عبر مساحته التي اكتمل فيها
بنيانه النفسي، ووُهب أدواته، ويستطيع بتلك الأدوات أن يزاحم في مصنع القيمة
والفروسية وإسعاد الناس.
وقد استنفر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه لمواجهة
هجاء قريش بهجاء، عندما وجد أن سلاح اللسان صار حاضرًا على الجبهات، فأرسل إلى
حسان بن ثابت، وهنا نضجت انفعالات الشاعر واستوت، وتدحرجت ثمرات موهبته على رمال
المعركة، فقال للنبي مفاخرًا بموهبته مطمئنًا إياه: "والذي بعثك بالحق لأفرينَّهم
بلساني فري الأديم"، فقام حسان بمهمته، والنبي يقول له: "إن روح القدس
لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله". فتقول السيدة عائشة: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: "هجاهم حسان فشفى واشتفى".
إرهاب الاحتلال
وقد ظلت الطاقة الإبداعية في ثقافتنا العربية والإسلامية
لها هامش ملتزم بقضايا المجتمع وأفكاره وهمومه، أو على الأقل منسجم مع بيئته
وخصوصياته الثقافية في المقصود العام وطريقة التعبير، وذلك أضعف الإيمان، قرونًا
طويلة. لكن تقلَّص ذلك الهامش الخاص بالالتزام الأدبي بشكل كبير في القرن العشرين،
لا سيما مع الحضور الثقيل ليد الاحتلال الباطشة في كثير من الدول العربية، ثم ما
تفرع عنها من أذرع داخلية حكمت بالحديد والنار، وألجمت كل لسان عن البوح بخطراته
الطبيعية التي تتخلَّق مع ما يعيشه ويراه، ما اضطرَّ كثيرًا من المبدعين، خاصة
الشعراء، إلى التهرب خلف أسوار آمنة بعيدًا عن إزعاج المعارضة وكلمة
"لا"؛ فأسسوا مدارس أدبية معزولة مغيَّبة بعيدة عن ضجيج الشارع
الاجتماعي وأوجاع الناس.
ويتحدث د. رجاء عيد في هذا السياق عن الحالة المصرية، بصفتها
كانت مركزًا لحركة الإبداع، وصورة صادقة للحال العربية والإسلامية بشكل عام،
مشيرًا أن ذلك التهرب والانعزال قد تجلَّى نتيجة
لحكم رئيس الوزراء إسماعيل صدقي الباطش المدعوم من السرايا والاحتلال، كنموذج زمني
لأثر الظلم والعنف على تقزيم الإبداع، فانصرف "الشعراء إلى التقوقع داخل ذواتهم؛
حيث وجدنا جماعة أبولو منذ سنة 1933؛ حيث نبتت بذور اليأس على شواطئ الفن وعشَّش الانهزام
في الكلمة، فوجدنا ناجي يكتب عن "ما وراء الغمام"، وفي عجلة الهروب نفسها
كتب علي محمود طه "ما وراء البحار"، و"الملاح التائه" وكتب الصيرفي
"الألحان الضائعة".
الالتزام يواصل الانسحاب
وإذا استثنيا ديوان الغاياتي في أول القرن العشرين، وبعض
قصائد البارودي وشوقي وحافظ، و"طقطوقات" المناضلين في ثورة 1919
وتوابعها، وبعض إنجازات سيد درويش الموسيقية، وبعض فلتات المسرح الإسلامي الذي صيغ
برعاية المدرسة الإسلامية في ذلك الوقت، وكتاب "الأيام" لطه حسين،
ورائعتي توفيق الحكيم "يوميات نائب في الأرياف" و"عودة
الروح"، يمكننا أن نقرر أن الالتزام الأدبي كان غائبًا في كثير من المنتج
الأدبي والفني في النصف الأول من القرن العشرين.
بل إن الحضور الأدبي الباهر لنجيب محفوظ بعد ذلك – كما
يقرر مؤلفا كتاب الثقافة المصرية – قد تأثر بقتامة الوضع السياسي العام، فاكتسى
منتوجه الأدبي بتضمينات يائسة مُحبطة كثيرة، سواء في رؤيته حول ماضيه الذي عاشه
تحت سطوة الاحتلال والسرايا، أو مرحلة نضوجه وكهولته التي عاشها في ظلال حكم قاسٍ
صادر كثيرًا من الحريات، وفعَّل مخالب الرقابة على الكلمة والإبداع.
ومع مضي الوقت، بدأت هوامش الالتزام في الأدب تغيب أكثر
عن الساحة الفنية والأدبية، في مصر والعالم العربي تأثرًا بوقائع السياسة
وتأزماتها، ومخالب الرقيب المترصدة، مع بعض الاستثناءات بالطبع في بعض أعمال
الأساتذة نجيب محفوظ ويوسف إدريس وعبد الحميد جودة السحار ونجيب الكيلاني وعلي
باكثير، وسعيد الكفراوي، وأشعار محمد عفيفي مطر، وغيرهم من الأعداد القليلة التي
تمسَّكت بحبال الالتزام الأدبي الاجتماعي.
وعليه كان النصف الثاني من القرن العشرين أكثر بعدًا عن
قضايا الالتزام الأدبي. وها نحن، وبعد انقضاء الربع الأول من القرن الحادي
والعشرين لا يزال الأدب والفنون – في غالبها – خارج الوعاء الاجتماعي المطلوب،
وبعيدًا عن هموم الناس الحقيقية؛ حيث غلبت روايات الخيال العلمي والفانتازيا
المسلية، وتسويق الكتب بحسب القدرة المالية في مجال النشر، ومثله صارت حقول
الأغنية وصناعة السينما والمنتجات الدرامية؛ حيث تتجه إلى التسطيح وتمييع الهُوية
وعدم الالتفات للحاجات الضرورية للناس.
ونختم هذا المقال بدعوة لأصحاب المواهب إلى التحرك
العاجل الطموح لصياغة أدب فاعل وإبداع نافع، وفن يليق بالضمير العربي الذي علَّم
العالم معنى الضمير.
***
اقرأ
أيضًا:

















