النخبة في الفكر السياسي الإسلامي
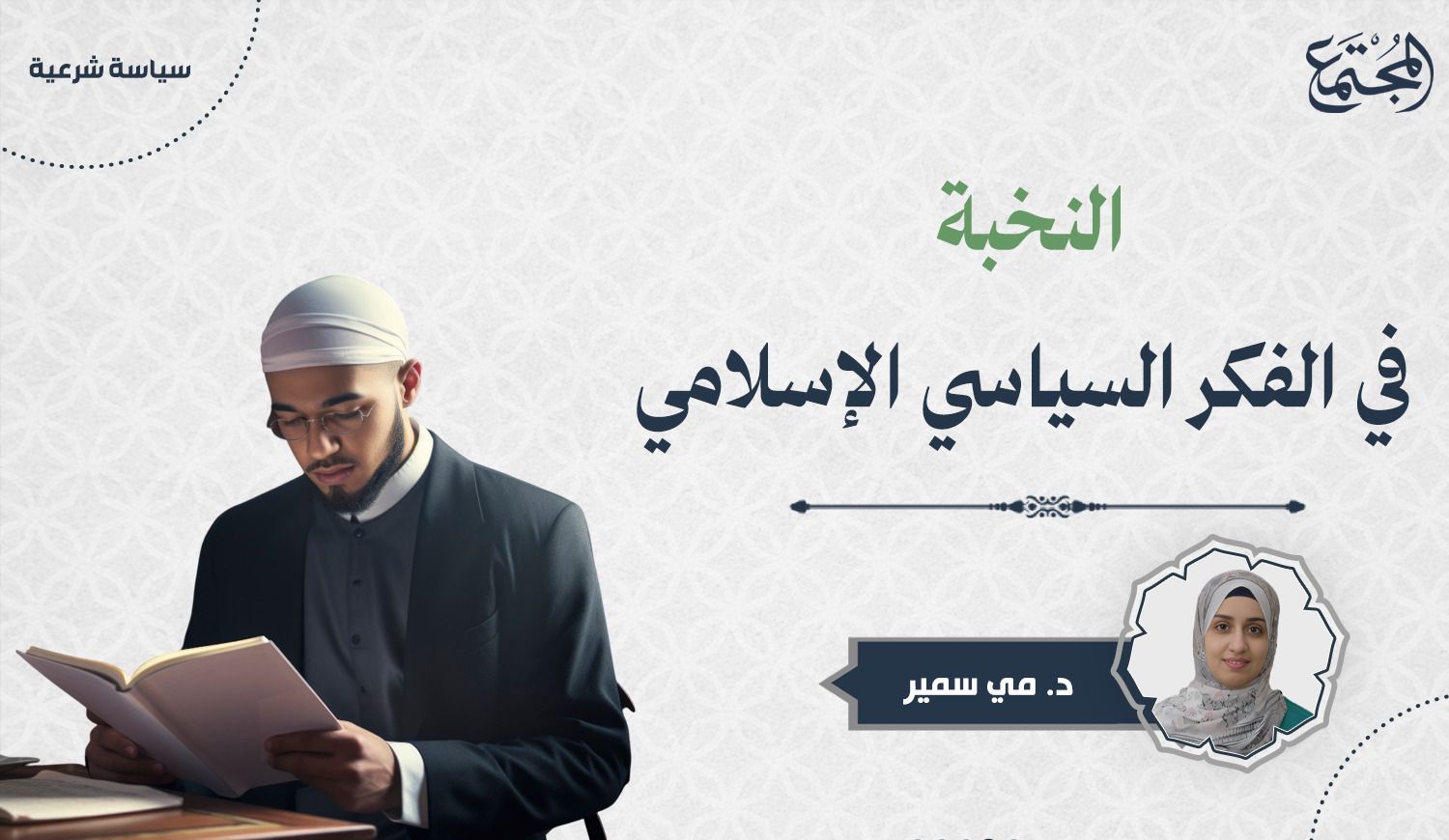
يعزو كثير من
الباحثين عن إجابة لتساؤل: لماذا ترزح مجتمعات المسلمين تحت وطأة الجهل والتخلف
الحضاري؟ إلى النخبة السياسية والثقافية، وذلك بفعل تكلسها وتراجع دورها التثقيفي
والتوعوي في قيادة المجتمعات نحو التنوير والفهم والتحول الديمقراطي، فالنخبة هي
القيادة التي تهدي المجتمع نحو الأفضل بحكم ما تحوزه تلك النخبة من تعليم راق
وتفقه في الدين وإدراك متعمق لمكامن الخلل وقدرة على تقديم حلول فعالة للمشكلات،
وبدونها يصبح المجتمع كالأعمى يسير على وجهة بلا هدى يتخبط في الظلام.
وقد فطن الإسلام
إلى جوهرية النخبة مبكراً، فأعطى اهتماماً خاصاً منذ بواكير الدعوة إلى تأسيس
وتشكيل نخبة من المؤمنين الذين أخذوا على عاتقهم حفظ القرآن وتلقي السُّنة عن
النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا بمثابة
مستشارين ووزراء وسفراء لنشر الدعوة وتبليغ الرسالة.
ثم بعد وفاة
النبي صلى الله عليه وسلم ما لبث خلفاؤه الراشدون أن اتبعوا سُنة النبي صلى الله
عليه وسلم بانتهاج مبدأ الشورى، وأقروا مبدأ البيعة لكبار وسادات البلاد باعتبارهم
النخبة الاجتماعية والسياسية التي تمثل كافة المسلمين، فأصبح منذ ذلك الحين مبدأ
البيعة واحداً من مبادئ الحكم الإسلامي.
وقد رسخت تلك
النخبوية الإسلامية مبدأ الشورى الذي عنى استشارة الخليفة لذوي الرأي والخبرة
والدين كل بحسب اختصاصه في إدارة شؤون الدولة وعدم الاستبداد بالرأي، وهو ما جعل
الحكم الإسلامي في شكله «الراشد» أو المثالي حكماً سياسياً شديد التقدمية بمقاييس
عصره، بل وعصرنا أيضاً.
طبيعة
النخبة في الفكر السياسي الإسلامي.. دينية أم سياسية؟
ويثير مفهوم
النخبة جملة من التساؤلات حول طبيعة هؤلاء الصفوة من المقربين من دوائر الحكم في
الإسلام، هل هم نخبة دينية بالمعنى الثيوقراطي؛ أي هل هم أعلى درجة من الناحية
الدينية من باقي البشر، كمثل هؤلاء الرهبان وآباء الكنسية الذين كان لهم الحق في
منح صكوك الغفران في أوروبا خلال ما يطلق عليه «عصور الظلام»؟ أم هم نخبة سياسية
بحكم اقترابهم من الخليفة ومشاركتهم في صنع القرار؟ أم هم نخبة ثقافية بحسب تخصصهم
العلمي وتبحرهم في الفروع المختلفة من العلم؟
لكن تلك
الإشكالية قد تنبع من فهم غير صحيح لطبيعة العلاقة بين الديني والسياسي في
الإسلام، واختلافها جذرياً عن مثيلتها في المسيحية، وتعيدنا مرة أخرى إلى جدلية
العلمانية والإسلام، فالدين والسياسة في الإسلام متصلان انطلاقاً من رؤية الإسلام
كمنهج حياة أو دين ودنيا، وطالما أنه لا انفصال بين الدين والدولة في الإسلام، لا
يمكن القول: إن النخبة السياسية نخبة علمانية، فأهل الحل والعقد أو العلماء لطالما
كانوا مرادفاً للفقهاء، ذلك أن الفقهاء كانوا النخبة الأساسية في الدولة الإسلامية
باعتبارهم الفئة الوحيدة القادرة على تنزيل أوامر الشرع على مقتضى الحال.
بل إن منصب
الخليفة نفسه في أشهر تعريفاته لدى المفكرين المسلمين هو «حراسة للدين وسياسة
الدنيا به»، ولما كانت القدرة على الاجتهاد والاستنباط والقياس للوصول إلى اجتهاد
بشأن الحوادث النازلة ببلاد المسلمين لم يكن ليتوفر سوى للفقهاء، فإنهم صاروا نخبة
إسلامية راسخة.
النخبة
الإسلامية.. بين الفقه والفلسفة والأدب
وتختلف معايير
النخبة الإسلامية ومواصفاتها في الفكر السياسي الإسلامي بحسب الخلفية الفكرية التي
اجتهد من خلالها المفكر، فالفكر السياسي الإسلامي قد تفرع من ثلاثة ينابيع فكرية؛
الفقه والفلسفة والأدب، فاتسمت طبيعة الفقهاء بالخلفية الدينية القانونية، وظهرت
كتاباتهم في مؤلفات «السياسة الشرعية» و«الأحكام السلطانية»، فهي شرعية وحكمية
قانونية واتخذت طابعاً عملياً، فاختلفت بحسب ما يفرضه واقع المسلمين.
بينما انطبعت
الكتابات الفلسفية بالمثالية والانعزال عن المجتمع، فجاءت كتابات نظرية وفلسفية عن
الحكم الفاضل والمدينة الفاضلة، وتأثرت إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية وبخاصة
أفلاطون وأرسطو.
أما كتابات
الأدباء فتمثلت في كتابات أدب النصيحة أو مرايا الأمراء التي صورت في شكل أدبي
مزخرف الكلمات واهتمت بجمع خلاصات الحكمة الخاصة بالأمم السابقة، وقدمتها في شكل
نصائح للحاكم أن يأخذ بها أو لا، واقتبست كثيراً من نصائحها من إجمالي تجارب الأمم
السابقة وبخاصة الفرس والروم.
أهل
الحل والعقد
وقد أخذت النخبة
شكل «أهل الحل والعقد» لدى الفقهاء، فقال ابن تيمية: «أولو الأمر صنفان؛ الأمراء
والعلماء»؛ أي الفقهاء، أما الماوردي فقد أكد أن الإمامة «تنعقد من وجهين؛ أحدهما:
باختيار أهل الحل والعقد، والثاني: بعهد الإمام من قبل».
ورغم عدم تفصيل
كثير من فقهاء السياسة الإسلامية في شروط أهل الحل والعقد، فإن السياق العام
لاجتهاداتهم دلت على أن هؤلاء العلماء من أهل الرأي والمشورة ذوي خلفية دينية
فقهية وقانونية، لا لأنهم أصحاب سلطان ثيوقراطي، ولكن بحكم تبحرهم في الشريعة
والحديث والفقه وقدرتهم على الاجتهاد في تنزيل مقتضى الشرع على أحوال المسلمين
اليومية، وبحكم أيضاً تمثيلهم لمجتمعاتهم باعتبارهم ذوي شأن وحيثية في المدن
والبلاد التي عاشوا فيها، فبعضهم فقهاء وقضاة مع حيازتهم للنسب العالي والسيرة
الحسنة، ومن ثم فإن هؤلاء العلماء والفقهاء أحرى بأن يكون رأيهم ذا ثقل نسبي عن
عامة المسلمين.
الحكام
الفلاسفة
أما لدى
الفلاسفة وانطلاقاً من خلفيتهم الفلسفية، فالنخبة لديهم جاءت فكرية وثقافية
بالأساس، فالحكمة والعقل الراجح والقدرة الفلسفية هي الأساس في اختيارهم، إذ اتفق
ابن رشد مع أفلاطون مع أهمية أن تحظى المدينة الإسلامية الفاضلة على طبقة «الحكام
الفلاسفة» الذين يمتلكون الفضيلة العقلية بما يؤهلهم إلى النظر في الأمور العملية
في الأمم والمدن.
وهذا الشرط
العقلي الفلسفي لدى ابن رشد هو بمثابة شرط رئيس ليس للحاكم فحسب، فحد الفيلسوف هو
بعينه حد الملك والشارع والإمام على السواء.
أما الفارابي،
فقد تمثلت نخبويته الفكرية في أن جعل للمدينة الفاضلة طبقة من الحكماء الذين
يمتلكون حكمة فلسفية عقلية ونظرية خالصة أعلى من سائر أهل المدينة، وهم يقودون
بتلك المعرفة البرهانية أهل المدينة للوصول إلى الفضيلة.
ذوو
الرأي والخُلُق
ومن ناحية أخرى،
فإن أدباء مرايا الأمراء قد عنوا عناية خاصة بتوجيه الحكام إلى الانصراف عن اتخاذ
بطانة السوء وحثوا الخلفاء والولاة على تقريب وتفضيل أصحاب الرأي والدين، مثلما
أشار إليه ابن المقفع في رسالته إلى الخليفة أبي جعفر المنصور «رسالة في الصحابة»،
حيث وضع شرائط لما يجب أن تكون عليه صحابة أمير المؤمنين، ومنها «رجل شرفه ورأيه
وعمله أهل لمجلس أمير المؤمنين وحديثه ومشورته، أو صاحب نجدة يعرف بها ويستعد لها
يجمع مع نجدته حسباً وعفافاً، أو رجل فقيه مصلح يوضع بين أظهر الناس لينتفعوا
بصلاحه وفقهه، أو رجل شريف لا يفسد»، وهي صفات جامعة لم تركز على التفقه الديني
فحسب كما لدى الفقهاء ولا العلم الفلسفي النظري فحسب، بل حازت جوامع الفضائل من
الفكر والدين والنسب والخلق على السواء.
وأخيراً، فإننا
أحوج ما نكون في يومنا هذا إلى نخبة حقيقية تدرك دورها كتكليف وواجب لقيادة الأمة
إلى النهضة والصلاح والخروج من سبات الجهل وفتور العزم وضياع الهمة، ونحن إن
تأملنا في مفهوم النخبة في الفكر السياسي الإسلامي بفروعه الثلاثة، يتكشف لنا
نموذج متكامل يتجاوز الحدود التقليدية بين الديني والسياسي، ويعيد تعريف القيادة
كمسؤولية معرفية وأخلاقية قبل أن تكون سلطة، وترى في النخبة ركيزة أساسية للحكم لا
ترفاً شكلياً، بل وترى في بطانة السوء عاملاً جوهرياً في فساد البلاد وضياع هيبة
الحكم.
وانطلاقاً من
تلك الرؤية يمكن إعادة فهم النخبة واستعادة أدوارها الاجتماعية والسياسية التي
غابت وغيبت بفعل انتشار الجهل وتردي الأخلاق وفساد الدين.
















