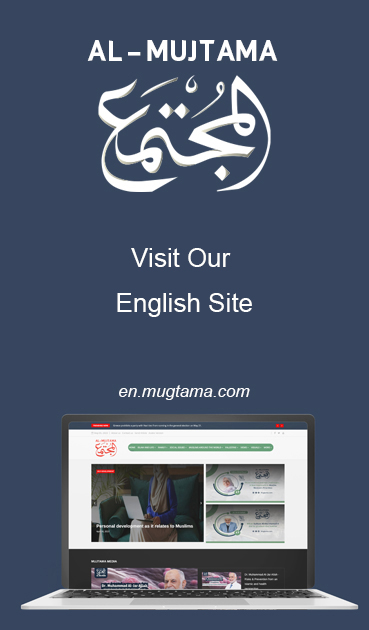فقه دعوة الأقليات المسلمة (1)
تعلم لغة غير المسلمين

الدعوة إلى الله
تعالى أشرف رسالة عرفتها البشرية، ذلك لأنها رسالة الأنبيّاء والمرسلين من لدن
سيدنا آدم حتى سيدنا محمّد عليهم جميعاً الصلاة والسلام، والأنبيّاء هم صفوة الله
من خلقه فكانت رسالتهم أشرف الرسالات جميعاً.
لماذا الحديث عن
فقه دعوة الأقليات المسلمة؟ لأن في أوروبا وحدها يعيش ما يزيد على 60 مليون مسلم
كأقلية، وأضعاف هذا العدد في الأمريكتين وروسيا والصين ـ
ولأن النبيّ صلى
الله عليه وسلم خصص غير المسلمين خاصة أهل الكتاب في كثير من أحاديثه، ومن ذلك ما
روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَالذي
نَفْسُ محمّد بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يهودي وَلاَ
نصراني ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالذي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّارِ» (صحيح مسلم)، وما رواه أَبُو بُرْدَةَ عن أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ
أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ
اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا
فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا
فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ» (صحيح البخاري).
وكذلك بيننا
وبين أهل الكِتاب من اليهود والنصارى ثوابت مشتركة، كالاعتقاد بوجود الإله، والإيمان
بالأنبيّاء، واليوم الآخر، كل ذلك على وجه الإجمال، ومن ثم فإن معاملة الإسلام
لأهل الكِتاب ليست كغيرهم، فقد أباح الشارع الحكيم الزواج منهم، وأحلّ ذبيحتهم،
وذلك لأنهم أقرب من غيرهم، وهي وشائج تهيئ العمل الدعوي لنتائج النجاح المرجوة في
دعوتهم.
القاعدة الأولى: تعلم لغة غير المسلمين:
إن اللغة مفتاح
التواصل بين الناس، ومن يعش في أوربا مدة من الزمن يدرك تماماً أن أجيال المسلمين
التي تولد فيها تَضعف لديهم اللغة العربية بشكل لا يفهمون معه غالباً مضمون خطبة
الجمعة ولا غيرها من المحاضرات أو الدروس باللغة العربية، وتصبح لغة البلد التي نشؤوا
فيها اللغة الأم.
وعن مكانة اللغة
في الإسلام، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ
بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) (إبراهيم: 4)، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنيبنا محمّد صلى الله
عليه وسلم: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (سبأ: 28).
ومما سبق، يتبين
أن من رحمة الله سبحانه بعباده أن كل رسول يدعو قومه بلسانهم ولغتهم التي
يفهمونها، وبناء على ذلك فاللغة ضرورة للتواصل مع المدعوّين.
وهناك نماذج
من تعلم لغة غير المسلمين، منها:
الأول: احتمال
تكلم النبيّ صلى الله عليه وسلم لغة غير المسلمين من العرب وغيرهم باعتبار عموم
بعثته.
كان كل نبيّ
يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الله تعالى سيدنا محمّداً للخلق كافة، وبما أن كل رسول
يتكلم بلسان قومه فنبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكل لغات الأقوام
باعتباره رسولاً إليهم، وهذا ما أشار إليه ابن حجر عندما قال تعليقاً على قول الله
تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ
بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ): كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ النبيّ صلى الله عليه
وسلم كَانَ يَعْرِف الْألسنّة لِأَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَى الْأُمَم كُلّهَا عَلَى
اِخْتِلَاف أَلْسِنَتهمْ فَجَمِيع الْأُمَم قَوْمه بِالنِّسْبَةِ إِلَى عُمُوم
رِسَالَته فَاقْتَضَى أَنْ يَعْرِف أَلْسِنَتهمْ لِيفهمْ عَنْهُمْ وَيَفْهَمُوا
عَنْهُ. (ابن حجر: فتح الباري).
كما أن من
الصحابة الكرام كذلك مَن تعلم لغة الحبشة وتكلم بها، فعن أبي موسى الأشعري قال في (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ) (الحديد: 28): ضعفين وهو بلسان الحبشة: كفلين. (ينظر: ابن الجوزي (ت
597هـ) تنوير الغبش في فضل السودان والحبش).
النموذج
الثاني: تعلم لغة أهل الكتاب السريانية:
لقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم زيداً بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية لغة اليهود، فعَنْ خَارِجَةَ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ– قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتاب يَهُودَ وَقَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتابي»، فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلاَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ. (سنن أبي داود).
ومما سبق يستفاد
ما يلي:
أ- أن تعلم لغة
غير المسلمين من الواجبات التي لا بد للدعاة أن يتعلموها كي يستطيعوا أن يتواصلوا
مع المدعوّين، ولا يكفي تعلم اللغة فقط، بل وإجادتها بما يسمح به التواصل والخطاب
بشكل كامل وتام، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ب- حكم تعلم لغة
غير المسلمين، وبالتأمل في قول زيد بن ثابت: «أَمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه
وسلم» أن الأمر يفهم منه أن الموضوع قد يدخل في حكم الفرض أو الاستحباب، ومما يؤكد
أهميته المدة القصيرة التي تعلم فيها زيد لغة اليهود، ومعنى حذقته: علمته وأتقنته.
وتعلم اللغة قد
يكون بواسطة الترجمان لمن لا يستطيع لغة القوم، ومن هنا فقد استعان النبيّ صلى
الله عليه وسلم بقوم كتبوا له، فأشار العلماء إلى أسمائهم منهم من كتب له الوحي
ومنهم من كتب له بريده ورسائله، ومنهم من تولى له تدوين المغانم وأمور الزكاة
والحرص والصدقة وما إلى ذلك من أمور اقتضاها تطور الظروف والأحوال.
جـ- اللغة آية
ربوبية، قال تعالى مبيناً أن اختلاف الألسن آية من آيات الله: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) (الروم: 22)؛ أي: ومن دلائل ربوبيته أيضًا اختلاف لغاتكم، حيث علم
كل أُمة لغتها المخالفة للغة غيرها، أو ألهمها العبارات المختلفة للتعبير عن
حاجاتها، وخالف بين طرائق نطقكم، فلا يكاد يوافق أحدكم غيره في أُسلوب نطقه
واختيار عباراته» (التفسير الوسيط، مجمع البحوث» 8/ 41).
فعلى الدعاة إلى
الله تعالى إتقان لغة المدعوين من غير المسلمين ومعرفة دلالات خطابهم وما يتميز به
لسان القوم حتى يستطيعوا إبلاغ الرسالة الإسلامية كاملة لهم.