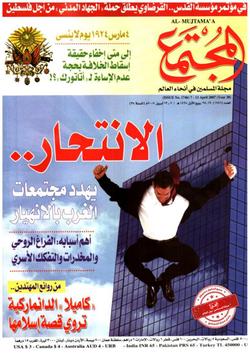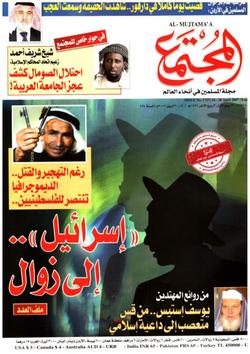العنوان القيم العلمية والأخلاقية في الحضارة الإسلامية.. الدين والحياة وجهان لعملة واحدة
الكاتب أ.د. عبد الرحمن علي الحجي
تاريخ النشر السبت 19-يوليو-2008
مشاهدات 52
نشر في العدد 1811
نشر في الصفحة 48
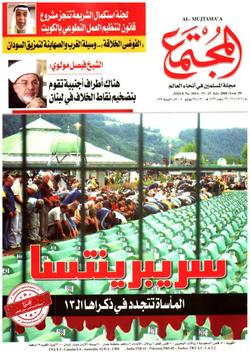
السبت 19-يوليو-2008
تَعَسّف البعضُ من المُحْدَثين في تبني فكرة مجانبة لكلّ الحقائق، مُتَجاهلةً الواقعَ والوقائع أنّ العلماء في الحضارة الإسلامية بعيدون عن أمور الحياة التي تحتاج إلى التصرّف واللباقة واللياقة.
فوصفوهم بالتحيّز، والجمود، والإهمال. ولكن الحقيقةَ المؤكدةَ غيرُ ذلك، إذ نجد الوعي، والجرأة، والإقدام، والدراية السياسية، والتوجيه الحكيم، وقوة الإرادة الشرعية، وحسن التعبير والمرونة في التصرّف، كانت عند العلماء ومنهم.
لأنّه أيضاً ــ بجانب هذه الصفات، ومع العلم، والذكاء، والبديهة ــ كانت هي مقومات العلم والعلماء، ولأنّ العلم الإسلامي يحتاج إلى هذه المواصفات مجتمعة. لقد كان العلماءُ وجهَ المجتمع وملجأَه، وكانوا هم الطليعة.
وكان العلمُ شائعاً، ومتاحاً، وانفتاحاً للنساء والرجال والأطفال كافة. ولدينا الكثير والكثير جداً من النساء اللواتي ظهر منهن عالمات، ومعلمات، وشاعرات، وراعيات، ومربيات، وطبيبات، بل وحتى فارسات ومحاربات، ابتداءً من أيام الرسول الكريم [ وما تلاها، كـ«خولة بنت الأَزْوَر»، و«غزالة»، و«جميلة» الأندلسية.
كما ظهر منهن متخصصات في ميادين عِدِّة، حسبما تؤهله لهن طبيعة تكوينهن، ودورهن، ووظائفهن، ومنها تربية الأولاد، ورعاية الأُسرة، ومشاركة الزوج، بل ونصحه، والتشاور معه، أو حتى توجيهه، والأمثلة لذلك وفيرة في أمصار العالم الإسلامي وأعصاره.
وكم من الرجال العلماء تلقى العلم عن عالمات عُرِفْن بمكانتهن العلمية العالية واُستاذيتهن، من أمثال «شَهْدَة الإبَرية البغدادية» المُعَمِّرة (574هـ)، الكاتبة ذات الخط الجيد، مُسْنِدة العراق، فخر النساء، التي سَمِعت من العلماء الرجال وأسمعتهم، واشتهر ذكرها، وذاع صيتُها.
مقومات المجتمع المسلم
ولكن الجميع كانوا يسعون في ذلك وهم بالسمت الإسلامي. وحين ينشأ الإنسان على الدين ويبنى به ويحيا بمعانيه، إيماناً، وفقهاً، والتزاماً ممارَساً، أطلقه ولا تَخْشَ عليه أو عليها. وهكذا يقوم المجتمع المسلم الذي يحرص عليه وعلى بنائه وشموخه أهلُه كافة ويحرص ويرعاهم بكل فئاتهم.
وبجانب تلك الصفات العلمية الشاملة كانوا من أهل الصفات الإنسانية. وهذه وتلك كلُّها يستدعيها العِلْمُ الإسلامي ويرتضيها انتماؤهم للإسلام، يقيمها ويربيها ويعليها. حيث كان التعليم الشرعي أساساً، ثم يأتي التخصص.
ولذلك، فإن المتخصص تظهر فيه آثارُ هذا العلم الشرعي، سلوكاً وأُسلوباً وتأليفاً، في الميادين الأُخرى كافة. فالعلماء: النحوي، واللغوي، والشاعر، والأديب، والطبيب، والصيدلي، والمهندس، والكيميائي، والفلكي، والنباتي، والزراعي، والفيزيائي، والقائد، والمجاهد، والإداري، والدبلوماسي، والسياسي، والمربي، والموجه، والمدرس، والتقني، والمخترع، والمؤرخ، والجغرافي، والرحالة، وأهل الوِراقَةِ العلماء، كانوا جميعاً بهذه المثابة.
ومن شذَّ ــ ربما كان في دينه ضعف، أو لعلّه كان مدسوساً أو شاذاً ــ عرف بذلك.
ترى ذلك السمت الرفيع، والنفح العبق، والفيح الفواح، كله عند هؤلاء العلماء واضحاً في حياة أحدهم ونِتاجه وعمله. وخلال دراساتي أُتابع وأبحث وأجمع المادة العلمية لكثير من الموضوعات، فأجد منها: العلماء، والعالمات، الشهداء، والعلماء السفراء، والعلماء الشعراء.. والموضوعات الأُخرى، وهي جِدُّ كثيرة.
العلم إيمان وعمل
وكان العلماء يتسامَوْن رفعةً، فتراهم قادةً وقدوة. وتلك من واجبات ومتطلبات مكانتهم، بها كانوا وفيها يتنافسون، وهي عدتهم. وإنّ تلك المواصفات لا يُغْني عنها طول الباع العلمي، وعمق التبحر فيه، لأنّ العلم إيمان وعمل، بل هو للعمل.
عَرَفَ المجتمعُ الإسلامي ــ لاسيما العلماء ــ قيمة العلم، فاحتمل الجميع تكاليف السعي له مهما كانت، من أجل تَلقِّيهِ وحَرِصوا على تحصيله بكل سبيل مُتلائم متناغم مُتوائم مع بنائهم الإسلامي. فهم يُقْبِلون على تلقيه وبَذْله وبَثِّه دِيناً، للناس جميعاً ودواماً، حِسْبَةً وقُرْبى.
وانظر إلى هذه الحكاية الطريفة التي يرويها «المَقَّري» (1041هـ) في كتابه نَفْح الطِّيِب (2/73) عن «أبي علي القالي» (قُرْطُبة ،356هـ) اللغوي، الأديب، الشاعر الذي كان يُمْلي بعض كتبه من حِفْظه ككتابَيْ «النوادر» و«الأمالي». ولقد كان موصوفاً منذ صباه بالحَذْق والذكاء. و«القالي» وافد الأندلس من بغداد أيام الخليفة «عبد الرحمن الثالث» (350هـ)، «الناصر لدين الله».
وحكاية «القالي» هذه: أن طلبته الذين كانوا ينتابون مجلسه. ثم في يوم ٍكان ممطراً وموحلاً فلم يحضر منهم سوى واحد، فلما رأى الشيخُ حرصَه على الاشتغال وإتيانه في تلك الحال ــ وكان لديه بعض الشيوخ أو أحدهم، «أبوالوليد الباجي» ـ أنشده لنفسه، ربما مُرْتَجِلاً:
دَبَبْتَ للمَجْدِ والساعُونَ قد بَلَغوا
حَدَّ النُّفوسِ وألْقَوْا دُونَهُ الأُزُرا
وكابَدُوا المَجْدَ حتى مَلَّ أكْثَرُهمْ
وعانَقَ المَجْدَ مَنْ وافى ومَنْ صَبَرا
لا تَحْسَبِ المَجْدَ تَمْراً أنتَ آكِلُهُ
لَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ حتى تَلْعَقَ الصَّبِرا
سمت أهل العلم
وما دام الحديث عن العلم وأهله (نساءً ورجالاً) وسمتهم فيه واهتمامهم به وإعطائهم حقه وصدقهم فيه، تلقياً وبذلاً، مع الله أَوَّلاً ثم مع الناس وتقديره وتقديم أهله والإقبال عليه وعليهم من قِبَل الجميع، حُكَّاماً ومحكومين وأُمراء، وذلك إلى جانب البناء العلمي للمجتمع، وهو الأَساس والممول والمنطلق، نلتقط قصةً مُعَبِّرة عن هذا المعنى تمام التعبير وبأجلى صورة، وأروع نموذج.
ذلك أن العالم اللغوي المعروف بالديانة والفقه والورع «تَمَّام بن غالب التَّيَّاني» (436هـ) المُرْسِي (من مدينة مُرْسِيَة الأندلسية)، صَنَّف كتاباً جليلاً. ولَمَّا وقف على ذلك الأمير «أبو الجيش»: «مجاهد العامري» (436هـ)، أرسل إلى «التياني» ألف دينار وكِسْوة راجياً إيّاه أن يزيد في الكتاب عبارة: مما أَلَّفَهُ «التياني» لـ«أبي الجيش مجاهد». لكن «التياني» رَدَّ عليه هّدِيَّتَه!، قائلاً: كتابٌ صَنَّفْتُه لله ولطلبة العلم، أصرفه إليه؟ هذا والله ما لا يكون أبداً! فكان أن زاد «التياني» في عين مجاهد وعَظُمَ في صدور الناس.
وكم من العلماء تقدّموا وقادوا المجتمع في أشد الأوقات وأصعبها، وبذلوا لرعاية المجتمع، ورفعة شأنه، وحمايته، وتطوعوا لرفع راية الجهاد، والدفع للأعداء، فكانوا أولَ الشهداء. وهؤلاء كثيرون جداً في أنحاء العالم الإسلامي كافة، وعلى مدار تاريخه، وامتداد أحواله وتنوعها.
ومن أمثالهم في الأندلس، استُشْهِد: «ابن رُمَيْلة القُرْطُبي» في معركة «الزَّلاَّقة» (479هـ) والقاضي الأمير الفقيه «ابن جَحَّاف» في «بَلَنْسِيَة» (488هـ)، والإمام «الجَزولي» (501هـ)، والقاضي «ابن الفَرَّاء»، والقاضي الفقيه «أبو علي الصَّدَفي» كلاهما استُشْهِدَ في معركة «قَتُنْدة» شَمالي الأندلس (514هـ)، و«أبوالربيع سليمان بن سالم الكَلاعي» عالِمُ ومُحَدِّث وشاعر «بلنسية» (634هـ).
ساروا في ذلك الطريق وهم مُقَدَّماً على عِلْم تام بمؤداه، بل تَراهم طالبين لمعناه، راغبين فيما يأتي به، مستعدين لكل التزاماته، وحريصين، وحاثين، ومسارعين، وبغير ذلك يكون حامله مُنْزَوياً مَحروماً مُبْعَداً.
مثل ذلك جرى لأدبهم ـ لاسيما شعرهم ـ أُغْمِض عنه وغُمِطَ حقُهم فيه. بينما كم كان منهم الأديب شعراً ونثراً، والخطيب قولاً وفكراً، والمُفَوَّه بديهةً وارتجالاً. ومن هؤلاء قاضي الجماعة بـ«قرطبة» «منذر بن سعيد البلوطي» (355هـ)، العالم الفقيه الدبلوماسي الخطيب الأديب الشاعر يرتجل الكلام والشعر والخطب، رواية وبديهة، وكأنه يقرأ كُلَّ ذلك من ورق.
وفي الطلائع الاجتماعية كانوا وجهاً فاخراً ولامعاً متنوراً، وفي المفاوضات والسفارات حازوا حكمة وبراعة وإبداعاً، وفي سوح الجهاد كانوا مقدمة، وهم في كلّ ذلك أمناء أقوياء أذكياء. وكلما زاد علم أحدهم زاد التزامه وإقدامه واهتمامه {إنَّمّا يّخًشّى پلَّهّ مٌنً عٌبّادٌهٌ پًعٍلّمّاءٍ} (فاطر: 28).
النهوضَ بالإسلام وللإسلام
وما دامت دوافعهم النهوضَ للإسلام وبه، فقد ظلوا مسلمين في كلّ أحوالهم، بل إنّ تلك الوظائف ـ بجانب أنّها ميدان لإظهار كل تلك الصفات ونعوتها ـ كانت مقوماتها من المتطلبات والمؤهلات، يُضاف إلى ذلك القضاء والتدريس.
فكلها مواصفات لا بد لها من ذكاء، ومرونة، وحيوية متفتحة لبقة ذكية نَضِرَة. وبالإمكان ـ لمعرفة كل ذلك ـ تسليط الضوء على أي من الدروب التي سلكها العلماء في الاستشهاد، والسفارات، والقضاء، والأدب، والتدريس، والقيادة الاجتماعية وغيرها، وكلّها موضوعات غنية بالأمثلة وذكية وعالية.
ومن أطرفها الدبلوماسية التي تولاّها علماء بدت لهم فيها مهارة أخرى، بجانب ما اعتادوه من أصل فنونهم، وحقول أعمالهم، وميادين تخصصاتهم. وكل ذلك مستمدٌ من تلك المواصفات البارَّة المنيرة المشرقة، الضاربة الجذور في أعماق البناء المقيم، والقائم على أُسس راكزة ركيزة {أّصًلٍهّا ثّابٌتِ $ّفّرًعٍهّا فٌي پسَّمّاءٌ>24< تٍؤًتٌي أٍكٍلّهّا كٍلَّ حٌينُ بٌإذًنٌ رّبٌَهّا}(إبراهيم)، تأصيلاً وتفعيلاً وتدليلاً، لا تمد يدها ولا عينها إلى غير هذا المنهج الرباني الكريم، وهي بالأخذ في متأسية بالرسول الكريم [: {لّقّدً كّانّ لّكٍمً فٌي رّسٍولٌ پلَّهٌ أٍسًوّةِ حّسّنّةِ لٌَمّن كّانّ يّرًجٍو پلَّهّ $ّالًيّوًمّ الآخٌرّ $ّذّكّرّ پلَّهّ كّثٌيرْا >21<} (الأحزاب).
كان هؤلاء العلماء يَحْنُون على المجتمع ويَحِنون إلى رعايته كأُسْرَتهم في كل أحواله وأحوالهم ويَبْذُلون له أغلى ما لديهم. فهذا «أبو بكر الخطيب البغدادي» (463هـ)، حافظ المشرق الإمام خطيب بغداد، عالم الفقهاء الشاعر الأديب، له المؤلفات الكثيرة، تَصَدَّق بكل ماله ـ عند وفاته ـ ووَقَفَ جميع كتبه الفخمة الكثيرة النوادر. وظاهرة الوقف متميزة فريدة مهمة في الحضارة الإسلامية، وتُعَدُّ إحدى مؤسساتها الكثيرة.
نماذجَ فريدة للمهمات المتنوعة: ولابد هنا ـ بجانب ما مَرَّ من الشواهد المُعَبِّرة ـ من ضرب أمثلة لنماذجَ لهذه المهمات المتنوعة الميادين، القوية المواقف الجذّابة القِوام، شرقاً وغرباً، حتى لقد كان كل ذلك أعرافاً بارة كريمة واضحة موسومة مرسومة محسومة.
ههنا يجري التعرف على هذا الإمام العلاَّمة القاضي «أبو بكر الباقِلاَّني محمد بن الطَّيِّب» (403هـ)، البصري ثم البغدادي، له المؤلفات الكثيرة الوفيرة الرائقة. كان سيف السُّنَّة، ولسان الأُمَّة المتكلِّم على لسان أهل الحديث، كان يُضْرَب به المَثَل بفهمه وذكائه وسرعة وقوة بديهته الغلاَّبة. كان في علمه أوحد زمنه موصوفاً بجودة الاستنباط، وسرعة الجواب.
اختاره «عضد الدولة البويهي» (بغداد،372هـ) سفيراً إلى «باسليوس الثاني» ملك الروم في «القُسْطَنْطِِينِيَّة» نحو سنة 371هـ للمفاوضة حول أُمورٍ، وهناك ناظر علماءَهم بحضور المَلِك فغلبهم، «وقد سار القاضي رسولاً عن أمير المؤمنين إلى طاغية الروم، وجرت له أُمور، منها أن المَلكَ أَدخله عليه من باب خَوْخَةٍ (باب صغير ضمن باب كبير لا يتمكن الإنسان من دخوله إلا أن يَحْني رأسَه) ليَدخُلَ راكعاً للملك، ففَطِنَ لها القاضي، ودخل بظهره!».
كذلك تَعَجَّب ما شِئتَ من هذا العالم الفقيه المقدام «أبو الوليد الباجي»، من مدينة «باجة» الأَندلسية: «سليمان بن خلف» (474هـ)، الذي تولى ـ مع غيره من علماء الأَندلس ـ أيام الطوائف فيها، العمل على تجاوز حالة الفرقة، والتشتت، والضعف لديها، التي أَحاطت بالأَندلس في القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي.
تجديد المعاني الإسلامية: فوَهَبَ ونَدَبَ نفسَه لهذه المهمة، لِلَمِّ شَعَث المجتمع الأَندلسي وأمرائه، واستمر على ذلك يعمل على تجديد المعاني الإسلامية في النفوس لمدة 33 عاماً!، حتى وفاته في مدينة «المَرِيَّة»، ذاهباً إليها لنفس القضية ــ رحمه الله تعالى ــ قائماً بذلك، يزور مدن الأَندلس عاملاً على إقالته من كَبْوَته حتى استقام الحال، وارتقت البلاد، فَلَمَّت شملها، وعادت إلى الوَحدة والقوة والالتئام. فواجهت مشكلاتها، واعْتَلَتْ أَمواجَها، وواجهت عَدوَّها منتصرة.
أفقه أهل الأندلس
وأَخيراً وليس آخراً، لك أَن تتمعَّن ما شئت، أَمام ما تقدَّم له وبادر وتجشم من أَجله الإمام العلاَّمة قاضي الجماعة بـ«قرطبة» «أبو الوليد بن رُشْد»، الجَد (520هـ)، وكان من أَهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم، مع الدين، والفضل، والوقار، والحلم، والسمت الحسن، والهدي الصالح، والإقدام، والتقدم المبادر، صاحب «البيان والتحصيل» وغيره من المؤلفات.
وكان أفقهَ أَهل الأَندلس، سار في القضاء بأحسن سيرة وأقوم طريقة. كان الناس يُعَوِّلون عليه ويلجؤون إليه. كان حسنَ الخلق، سهلَ اللقاء، كثيرَ النفع لخاصته، جميلَ العشرة لهم، بارَّاً بهم. وهو جَد «ابن رُشد» الحفيد (595هـ). وهو الذي ندب نفسَه للتوجّه إلى المغرب أَيام المرابطين، مبيناً لأمير المسلمين «علي بن يوسف بن تاشُفين» (537هـ) الأَحوالَ، وشارحاً إياها، ومقترحاً عليه إجراءات بشأنها، أخذ الأميرُ بها جميعاً ونفذها حالاً.
وشبيه بهذا ما فعله القاضي الإشبيلي العالم المفسر الفقيه الدبلوماسي الأديب الشاعر، الذي كان يرتجل الشعر ويجيزه، «أبوبكر بن العربي» (543هـ) صاحب كتاب «العواصم من القواصم» وعشرات المؤلفات غيرها، والذي رأس وفداً من علماء الأندلس، يمثلون أهله، ذهبوا إلى «فاس» بالمغرب لإبلاغ الموحدين، وتقديم بيعة أهل الأندلس لهم.
وقُلْ مثلَه عن الفقيه الأديب الشاعر الذي كان كذلك يُجيز الشعر ويرتجل أحياناً القصيدة المديدة، «أبومحمد علي ابن حَزْم» الأندلسي (456هـ)، الذي حاول لمّ شمل المجتمع الأندلسي بدايات فترة الطوائف.
هذا، وأمثاله الكثير الكثير مما تتفرَّد به الحضارة الإسلامية ومجتمعها، ولاسيما علماؤها الأفذاذ، أهل العفة والاستقامة. وهو تفرد مستمد من الإسلام نفسه، الذي قام عليه بناؤها، آخذةً تعاليمه الربانية الفاضلة المجيدة المتفردة.
المدنية الحالية
غير بعيد لو قيل: إنّ المعرفة والمدنية الحالية ـ بكلّ ما فيها من انحراف وهبوط، إلى جانب ما فيها من علم وتقنية ـ استخدمته أحياناً أجيالٌ لتأكيد الانحراف، وإن إمكانياتها أظهرت جانباً من طبيعة هذه المدنية، التي كثيراً ما تجردت من الدين الحق. ولو قلنا إنها بهذا النهج المتخلف لا تخدم الحياة، لما كنا مجانبي الصواب.
لكن لا خوف بحال على الحقيقة من أي وضع مهما كان. فهي باقية تحمل الخير الذي أودعه الله فيها، والقوة التي وضعها لها. وهل من حقيقة أقوى من عقيدة الإسلام، وما من خير يداني شريعته التي تأتي بالمعجزات لأنّها معجزة. وكلّ ما في الكون يؤكّد ذلك ويقويه ويعليه. لكن سنة الله جارية, حيث إنه لابد للحقيقة مَن يحملها.
و«عجباً للمؤمن فإن أمرَه كلَّه له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلاّ للمؤمن». وهذا دليل على أن كل حال يواجهه المؤمنُ يحمل في طياته له الخير والحياة البارّة.
وكم من أحداث ــ ملأت المُدَوَّناتِ الإسلامية ـ في حياة المسلمين كانت منذرة بالإهلاك، لكنها غدت خيراً لهم: صلح الحديبية، وفتح الأندلس، والحروب الصليبية. وحين لا يكون الأمر كذلك، فإن مثل هذه الأحداث قد تكون قاضية، ولكن الانتفاع بها وتحولها إلى الخير يتحقق تماماً إذا هبت ريح الإيمان!!