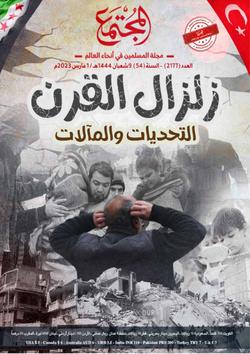العنوان حقيقة القتال في الإسلام (١من٢)
الكاتب د. محمد عمارة
تاريخ النشر الاثنين 01-ديسمبر-2014
مشاهدات 57
نشر في العدد 2078
نشر في الصفحة 60

الاثنين 01-ديسمبر-2014
• «الدين» في الإسلام لابد لإقامته من وطن لأنه ليس مجرد تكاليف فردية وإنما فيه كذلك تكاليف اجتماعية لا تؤدى إلا في أمة ونظام ومؤسسات.
• الإسلام رفع قيمة الحفاظ على حرية الوطن
واستقلاله وسيادته وحق المواطن في أن يعيش حرًا داخل وطن حر.
• القرآن الكريم ذكر أن الإخراج من الديار
مساو للقتل الذي يخرج الإنسان من عداد الأحياء.
• لمقام الوطن وضرورته ولإقامة دين الإسلام
وشريعته كان الجهاد القتالي واردًا وأحيانًا واجبًا للحفاظ على الوعاء الذي بدونه
لا يقام كامل الإسلام.
• معيار الاسلام في السلم أو الحرب ليس الإيمان والفكر ولا الاتفاق والاختلاف وإنما التعايش السلمي مع الآخرين.
إذا كان الجهاد في الإسلام أعم من القتال؛
فإن القتال الذي هو الجهاد العنيف والذي هو شعبة واحدة من الشعب السلمية التي لا
تحصى للجهاد متميزة ثمرته- وهي القتل، عن الموت الطبيعي، فالموت هو فوت الحياة،
بينما القتل هو إزالة الروح وإزهاقها، وفوت الحياة بفعل فاعل من الخارج يتولى هذا
الإزهاق.
وليس هناك شك- بل ولا غرابة- في أن نجد في
الإسلام تشريعًا مضبوطًا يجوز القتال أو يوجبه في بعض الحالات، ذلك أن الإسلام دين
ودولة وأمة ووطن واجتماع ونظام... فالدين في الإسلام لابد لإقامته من وطن يقام
فيه، لأن هذا الدين الإسلامي ليس مجرد تكاليف فردية، يستطيع المكلف بها أن يقيمها
بمعزل عن الناس أو بإدارة الظهر للناس وإنما فيه– إلى جانب التكاليف الفردية-
تكاليف اجتماعية لا تؤدى إلا في أمة وجماعة ونظام ومؤسسات وسلطة واجتماع، أي لابد
له من وطن ودولة، وهذه التكاليف الاجتماعية والكفائية هي أهم من التكاليف الفردية،
لأن الإثم في التخلف عن التكليف الفردي يقع على الفرد فقط، بينما إثم التخلف عن
التكليف الجماعي والاجتماعي الكفائي يقع على الأمة جمعاء.
بل إن أغلب التكاليف الفردية في الإسلام تؤدى
وتقام في جماعة، وثوابها في الجماعة أضعاف أضعاف إقامتها خارج الجماعة.
ولهذه الحقيقة التي تميز بها الإسلام عن
النصرانية التي تتمثل ذروة إقامتها كاملة في الرهبانية التي تدير الظهر للعالم
والدنيا والناس كان الوطن هو الوعاء الذي بدونه لا تقام جملة شعائر الإسلام
وفرائضه وتكاليفه.
حرية الوطن واستقلاله
ولهذه الحقيقة أيضًا رفع الإسلام قيمة الحفاظ
على حرية الوطن واستقلاله وسيادته، وحق المواطن بل واجبه في أن يعيش حرًا في وطن
حر، رفع هذه القيمة إلى مقام الحياة فجاء في القرآن الكريم الحديث أن الإخراج من
الديار معادل ومساو للقتل، الذي يخرج الإنسان من عداد الأحياء، ﴿ وَلَوْ أَنَّا
كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم
مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا
يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ (سورة النساء: 66)،
وجاء في القرآن الكريم كذلك الإشارة إلى بنود المواثيق التي أخذها الله سبحانه
وتعالى على بعض الأمم، ومنها نتعلم أن الإخراج من الديار، والحرمان من الوطن هو
معادل لسفك الدماء والإخراج من الحياة ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا
تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ
أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ(٨٤) ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ
أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ
عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا
خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ
أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ٨٤،٨٥).
ولذلك، جعل القرآن الكريم «استقلال الوطن
وحريته» الذي هو ثمرة الوطنية، جعل ذلك «حياة» لأهل هذا الوطن، بينما عبر عن الذين
فرطوا في استقلال وطنهم بأنهم «أموات»! وجعل من عودة الروح الوطنية إلى الذين سبق
لهم التفريط فيها، عودة الروح الحياة إلى الذين سبق وأصابهم الموت والموات: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ(٢٤٣) وَقَاتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة:٢٤٣-٢٤٤)
فالذين خرجوا من ديارهم وليس الذين أخرجوا
لضعف في وطنيتهم، وجبن عن مقاتلة أعداء وطنهم هم أموات، مع أنهم ألوف يأكلون
ويشربون! وعودة الوطنية إليهم، واستخلاصهم لوطنهم، هو إحياء لهم بعد الممات.
وعاء الوطن
ولأن هذا هو مقام الوطن وضرورته لإقامة دين
الإسلام وشريعته كان الجهاد القتالي واردًا، وأحيانًا واجبًا للحفاظ على الوعاء «الوطن»
الذي بدونه لا يقام كامل الإسلام.
وفي تفسير هذه الآيات على هذا النحو قرر
الإمام محمد عبده (١٣٦٥- ١٣٢٣هـ /١٨٤٩- ١٩٠٥م) «أن معنى موت أولئك القوم هو أن
العدو نكل بهم فافني قوتهم وازال استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد أمة، بأن تفرق
شملها، وذهبت جامعتها، فكل ما بقي من أفرادها خاضعون للغالبين، ضائعون فيهم،
مدغمون في غمارهم، لا وجود لهم في أنفسهم، وإنما وجودهم تابع بوجود غيرهم، ومعنى
حياتهم هو عودة الاستقلال إليهم! إن الجبن عن مدافعة الأعداء، وتسليم الديار
بالهزيمة والفرار، هو الموت المحفوف بالخزي والعار، وإن الحياة العزيزة الطيبة هي
الحياة المحفوظة من عدوان المعتدين والقتال في سبيل الله أعم من القتال لأجل
الدين، لأنه يشمل أيضًا الدفاع عن الحوزة إذ هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا
والتمتع بخيرات أرضنا، فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق كله جهاد في
سبيل الله.. ولقد اتفق الفقهاء على أن العدوان إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض
عين على كل المسلمين(۱).
إقامة الدين: فلابد لإقامة الإسلام من وطن، الأمر الذي
يجعل القتال لحماية حرية هذا الوطن، التي هي حرية مواطنيه واردًا في شريعة
الإسلام، فالحفاظ على الدين هو ذروة سنام مقاصد الشريعة الإسلامية، والحفاظ على
حرية الوطن الإسلامي هو الشرط لإقامة الدين، والقيام بأمانة العمران التي هي المهمة
العظمى من وراء استخلاف الله سبحانه وتعالى لجنس الإنسان؛ ولذلك وقف الإسلام
بالقتال إذنًا وأمرًا وتحريضًا فقط عند:
١-الحفاظ على الدين، وحرية الدعوة إليه،
وتحرير ضمائر المؤمنين به من الفتنة والإكراه.
٢-والحفاظ على الوطن، وصيانة حريته وحرية
أهله من العدوان.
فالقتال في الإسلام هو الاستثناء الذي لا
يجوز اللجوء إليه إلا لمدافعة الذين يفتنون المسلمين في دينهم، أو يخرجونهم من
ديارهم، ولقد كان منهاج الدعوة الإسلامية التجسيد لهذا المنهاج.
ففي البداية، وبعدما تعرض له المسلمون من أذى
في عقيدتهم وفتنة عند دينهم واضطهاد تصاعد حتى اقتلعهم من وطنهم مكة وجعلهم
يهاجرون إلى يثرب «المدينة» بعد هجرة العديدين منهم إلى الحبشة أذن الله تعالى
مجرد إذن للمؤمنين في القتال، ولقد كان الإخراج من الديار والفتنة في الدين
الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم في كل الآيات التي شرعت لهذا القتال.
ففي الإذن بالقتال، يقول الله سبحانه وتعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (٣٨)أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا
ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ(٣٩)الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن
دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ
اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج:٣٨،٣٩،٤٠)
الإخراج من الديار
وعندما تطور الحال من الإذن، في القتال إلى «الأمر»
به جاء القرآن الكريم ليضع الإخراج من الديار سببًا لهذا الأمر بالقتال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ(١٩١) فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (البقرة:١٩٠،١٩١،١٩٢)
فهو قتال دفاعي ضد الذين أخرجوا المسلمين من
ديارهم، وفتنوهم في دينهم؛ لتحرير الوطن الذي سلبه المشركون من المسلمين.
ذلك لأن منهاج الشريعة الإسلامية في الدعوة
إلى الله وإلى دينه ليس القتال، وإنما هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي
أحسن ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ
عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا
وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾
(سورة النحل: ١٢٥،١٢٦،١٢٧،١٢٨)
بل لقد تميز الإسلام في هذا الميدان برفضه
فلسفة «الصراع» لأنه يؤدي إلى أن يصرع القوي الضعيف، فيزيله، وينهي التنوع والتعدد
والتمايز والاختلاف، التي هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في سائر المخلوقات،
رفض الإسلام فلسفة «الصراع»، وأحل محلها فلسفة «التدافع» الذي هو حراك يعدل
المواقف، ويعيد التوازن والعدل مع بقاء التعددية والتعايش والحوار والتفاعل بين مختلف
الفرقاء ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ﴾ (فصلت: 34)
إن الإسلام لا يريد «الصراع» الذي ينهي الآخر
﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾
(الحاقة: 7)، وإنما «التدافع»، الذي هو حراك يحل التوازن ويحل الخلل الذي يصيب
علاقات الفرقاء المتمايزين
ولقد صاغ أبو بكر الصديق (٥١ق. هـ - ١٣هـ /
٥٧٣ –٦٣٤م)، وهو رأس الدولة قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة
إسلامية، عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان (١٨هـ / ٦٣٩م)، وهو يودعه أميرًا
على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشام، فقال في وثيقة الوصايا العشر:
«إنك ستجد قومًا زعموا أنهم احتبسوا أنفسهم لله «الرهبان»، فدعهم وما زعموا أنهم
احتبسوا أنفسهم له، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيًا ولا كبيرًا هرمًا،
ولا تقطعن شجرًا مثمرًا، ولا تخربن عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكله،
ولا تحرقن نخلا، ولا تفرقنه، ولا تغل ولا تجبن (رواه مالك في الموطأ).
فكانت هذه «وثيقة الوصايا العشر» دستور
الآداب الإسلامية وأخلاقيات القتال عندما يفرض على المسلمين القتال.
تسامح ومساواة
يرجف كثير من المرجفين مستشرقين وعملاء لهم -
حول هذه الآيات، زاعمين أنها تحض على القتال والتربص بالمشركين في كل مكان، وعلى
القتال والإرهاب لهؤلاء المشركين، حتى لقد قال أحد عملاء وضحايا التغريب متسائلًا
تساؤل الإنكار والاستنكار: «لماذا يستشهد المسلمون دائمًا بالنصوص القرآنية
والأحاديث النبوية التي تبرز الوجه السلمي المتسامح للإسلام، ويتجاهلون النصوص الأخرى
التي تحض على القتال والقتل والإرهاب؟! مع أن النصوص التي تحض على القتال والتربص
بالمشركين نزلت بعد النصوص التي تؤكد التسامح والمساواة؟!». وهذا الإرجاف والغمز
واللمز، بل والطعن، يجهل ويتجاهل الحقائق الصلبة التي تفصح عنها هذه الآيات من
سورة «براءة»، فهي تميز في المشركين بين توجهات ثلاثة:
١-مشركون معاهدون للمسلمين يحترمون العهود،
والآيات تدعو المسلمين إلى الوفاء بالعهود لهؤلاء المشركون ﴿ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ
مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: 4).
٢-ومشركون محايدون، لم يحددوا موقفًا مع أو
ضد، ويريدون أن يعلموا الحقيقة ليتخذوا لهم موقفًا، وهذه الآيات تطلب من المسلمين
إجارة هؤلاء المشركين وتأمينهم ووضع الحقائق أمام بصائرهم وأبصارهم... ثم تركهم
أحرارًا، بل وحراستهم حتى يبلغوا مأمنهم، ليقرروا ما يقررون: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾
(سورة التوبة: ٦)
٣-أما الفريق الثالث من المشركين، فهم الذي
يقاتلون المسلمين، والذين احترفوا نقض العهود مع المسلمين: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي
مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ (التوبة:١٠)
﴿وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ
لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ﴾ (التوبة: 12)
فليس هناك تعميم لقتال كل المشركين في هذه
الآيات التي تعلق بها ويتعلق المرجفون الذين يتهمون الإسلام بالقتل والإرهاب، لأن
التربص والقتال في هذه الآيات ليس لمطلق المشركين ولا لكل المخالفين، وإنما هو رد
العدوان المعتدين الذين نقضوا العهود ونكثوا الأيمان وأخرجوا الرسول ﷺ والمؤمنين
من ديارهم: ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا
بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ
فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: 13)
معيار الإسلام
فمعيار الإسلام ودولته، هي السلم والسلام أو
الحرب والقتال، ليس «الإيمان» و«الكفر» ولا «الاتفاق» و«الاختلاف» وإنما هو
التعايش السلمي بين الآخرين وبين المسلمين، أو عدوان الآخرين على المؤمنين بالفتنة
في الدين، أو الإخراج من الديار.. وعن هذا المعيار للعلاقة بين الإسلام وبين الكافرين
به والمنكرين له يقول القرآن الكريم: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (7) لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن
تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾(الممتحنة:
٧،٨،٩)
ولقد طبق المسلمون هذا المعيار في العلاقات
مع المخالفين، فكان اليهود بدولة المدينة المنورة جزءًا من الرعية والأمة، ونص
دستور هذه الدولة الإسلامية الأولى على أن «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ومن
تبعنا من يهود فإن لهم النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وأن بطانة
يهود ومواليهم كأنفسهم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين على
اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه
الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر والمحصن من أهل هذه الصحيفة دون الإثم،
لا يكسب كاسب إلا على نفسه، فيهود أمة مع المؤمنين».
وبالنسبة لعموم النصارى، قررت المواثيق
النبوية في هذه الدولة الإسلامية الأولى: «أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على
المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما
عليهم ().
دستور الفروسية
وفي قواعد أخلاقيات دستور الفروسية الإسلامية
هذا، يروي الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز (٦١-١٠١هـ / ٦٨١ – ٧٢٠م) وهو على رأس
السلطة التنفيذية «الخلافة» وليس في صفوف المعارضة يروي فيقول: «إنه بلغنا أن رسول
الله ﷺ كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله، في سبيل الله تقاتلون من كفر
بالله، لا تغلوا أي لا «تخونوا» ولا تغدروا، ولا تمثلوا «أي لا تمثلوا بجثث القتلى»،
ولا تقتلوا وليدًا» (رواه مسلم ومالك في الموطأ).
فلسفة إسلامية
يرفض الإسلام الفلسفات التي اعتبرت القتل والقتال
إزهاقًا للأرواح جبلة جبل عليها الإنسان، وغريزة من غرائزه المتأصلة فيه، وفي
مواجهة هذه الفلسفات التي ذهبت إلى حد اعتبار الحرب طريقًا من طرق التقدم والتطور
يقرر الإسلام أن القتال هو الاستثناء المكروه، وليس القاعدة، إنه ضرورة تقدر
بقدرها: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ ﴾ (البقرة: ٢١٦)،
وليس هناك «مكتوب» ومفروض وصف في القرآن الكريم بأنه «كره» سوى القتال!
ولقد بينت السنة النبوية وأكدت هذه الفلسفة
الإسلامية إزاء القتال فقال رسول الله ﷺ: «لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله
العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا ، وأكثروا من ذكر الله ( رواه الدارمي).
وحتى هذا القتال الذي كتب على المسلمين وهو
كره لهم والذي وقف به الإسلام ودولته عند حدود القتال الدفاعي لحماية حرية العقيدة
وحرية الدعوة من الفتنة، التي هي أكبر من القتال المادي، ولحماية حرية الوطن الذي
بدونه لا يقام الإسلام، حتى هذا القتال الاستثناء والضرورة قد وضع الإسلام ودولته
له «دستورًا أخلاقيًا» تجاوز في سموه كل المواثيق الدولية التي تعارف عليها
المجتمع الدولي نظريًا بعد أربعة عشر قرنًا من ظهور الإسلام وتطبيق المسلمين
لقواعد الدستور الأخلاقي لهذا القتال.
----------------------
الهوامش
(١) «الأعمال الكاملة» للإمام محمد عبده، ج
4، ص ٦٩٥ – ٦٩٧، دراسة وتحقيق: د محمد عمارة، طبعة دار الشروق القاهرة سنة ١٩٩٣م.
(۲) انظر: في تفصيل ذلك كتابنا «الإسلام
والحرب الدينية» ص ۳۲- ۳۹، طبعة مكتبة الشروق الدولية- القاهرة – سنة ١٤٢٥هـ-
٢٠٠٥م
(۳) د. نصر حامد أبو زيد، مجلة وجهات نظر
القاهرة - يناير سنة ٢٠٠٢م، مقال «الإسلام والغرب.. حرب الكراهية»
(٤) د. محمد حميد الله الحيدر آبادي محقق «مجموعة
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة»، ص ١٦ طبعة القاهرة، سنة ١٩٥٦م.
(٥) المصدر السابق، ص ۱۱۱.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل