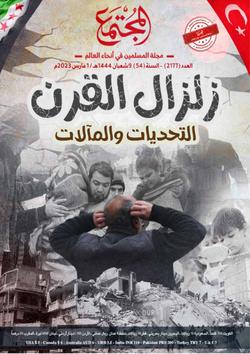العنوان قصة قصيرة القطار «١ من٢»
الكاتب زكريا التوابتي
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1994
مشاهدات 11
نشر في العدد 1106
نشر في الصفحة 54

الثلاثاء 05-يوليو-1994
يريد أن يراك قبل الرحيل.. أصاب الشلل نصف جسده، لكنه ما زال يستطيع أن يقول شيئًا...
ما زالت المرارة ظاهرة لم يذهب طعمها من قلبه.. لم ترمش له عين، ولم يتكلم، وبدأ الكون صامتًا...
ألا تجيبني؟ هل نسيتنا؟ إنه الموت.. لهذا جئت إليك...
ببطء شديد، وبنظرة تعلن الغضب قبل الرفض، وبصوت أحسن ردد.. إنما الميت ميت الأحياء... الموقف لا يتسع للخيال الشعري، ولا للعتاب ولا للرفض أيضًا...
لم ينس أبدًا كل ما مر به وأصاب منه ببطء شديد وبنظرة غاضبة عاد يردد.. لم يعد لكم في القلب موضع.. قال الزائر.. أنت حر في رفضك لنا، لكن.. هل نكون أرق منك أفئدة؟! أنقى قلبًا؟!
كان عادم الآلات بالمصنع القريب يصنع غيمة تحجب وراءها ضوء السماء الساطع وعاد الزائر يلح.. عبد الرحيم.. هيا معي قبل أن... قبل أن يموت...
اضطرب صوت الزائر، ثم استسلم لموجة دافقة من البكاء، وأخذ بعد لحظات يلقي بكلمات تتخلل شهيق الحزن.. تبدلت السبل... واختار.. اختار كل واحد منا.. طريقه...
غمغم عبد الرحيم في غضب.. كلكم توحدتم وسرتم في طريق واحد.. طريق الظلام، وحدي أنا.. كنت في الطريق الآخر....
-كنا نحبك وما زلنا.. كنا نستكشف هذا الطريق معك، لكنك تركتنا.. ابتلعك الظلام...
-كنتم تعرفون الأبيض من الأسود..
تعرفون النور من الظلمات...
-كنا في أول الطريق، لم يكن الوضوح كافيًا.. وكنا نحاول أن نجد لنا موقعًا، ومع الطموح وفي غيبتك تمكن منا الآخرون.. لماذا تركتنا؟ لأول مرة يبدو الأسف والعتاب في كلامه.. هل تركتكم يا سالم؟ لقد..
دون الغضب قاطعه سالم.. نعرف.. نعرف.. اختطفك منا سلطان الظلام...
همس عبد الرحيم.. كنتم تستطيعون الثبات وتسلكون نفس الطريق.. كل موقف هو في ذاته عملية تربوية.. لكنكم...
قال سالم متضرعًا.. الإيمان الذي تؤمن به عذر الناس في كفرهم أمام الخوف والجهل... بيننا وبينك هذا الميزان.
- هذا يعني أنكم كنتم تعرفون الطريق الخاطئ... كنا نريد أن نصل.. ذهبت ولم نجد من يحرسنا، عاطفة الحب كانت تشدنا إليك.. لكن أین أنت؟
- هذا وحده لا يكفي...
اندفع سالم في حدة يقول.. لماذا لم تشركنا معك؟ وليكن الثمن الذي دفعته... السجن، لكن.. كنا سنتعرف على الطريق، ولا يحدث لنا ما حدث...
قال عبد الرحيم وهو يتأمل الأفق من خلال النافذة.. لا بد من إعداد، وفهم ومعرفة بالتكاليف.. ثم يكون الاختيار.. كنتم في البداية، وجاءت الأحداث مسرعة...
-ما ذنبنا؟
-ما حدث لي كان كافيًا للبحث.. للفهم، لكن.. أعجبكم رباط العنق الأحمر...
-لن ينتهي الكلام.. الرجل على فراش الموت أرجوك هيا بنا... نعم.. استيقظت في قلبه الثورة، وانفتل من معاني الحنان إلى معاني القسوة، لم يزحزحه حديثه مع الزائر عن موقفه.. لن يذهب معه ولو راغمًا نفسه، فما زال القلب فارغًا من الصديق القديم ومنهم جميعًا.. الروح والعقل يتأذيان من الضلال والنذالة، ونزعة الحيوان في الإنسان، وقال الزائر يخرجه من التفكير.. في القطار جنتك، وفيه نذهب معًا.. كم كان الماضي جميلًا.. كانت في الطريق وقفات، لكن لا بد من مواصلة المسير..
غمغم عبد الرحيم في حزن.. ومهما واصلنا المسير فللطريق منتهي... من نافذة القطار أخذ يتأمل الأفق الممتد فوق بساط من الزروع الخضراء والأشجار السامقة، ورغم السكينة التي تبعثها رؤية الآيات الكونية في النفس.. كان قلقًا، هؤلاء الصبية والشباب.. هذا الجيل.. ماذا ترى وماذا تسمع تلك الطلائع؟
كانت دورة الكون سريعة ومشحونة بالغرائب والعجائب، فالأحداث والنزعات تهز ثوابت الفطرة والإيمان.. ربما لو طال به العمر لجاوزت الأحداث والتغيرات تقديراته، ومن يدري.. ربما كانت التغيرات خلاف الذي يخشاه، فالدنيا تبدو له كموج متلاطم، وكل شيء فيها يفور ويغلي ويتقلقل.. تعلق بصره بالسماء، وغمغم لنفسه.. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.. سبحانه وتعالى..
تمتم سالم.. ماذا تقول؟
أجاب عبد الرحيم.. أقول: لا إله إلا الله.. ولثوان اهتزت عربة القطار بشدة، وهي تمر سريعًا فوق تقاطعات القضبان المتشابكة مختلفة الاتجاهات عند مدخل إحدى المدن بينما صمت رفيقه ولم يتكلم، وتصور عبد الرحيم أنه قد رماه بسهم.. وانشغل كل منهما بعد ذلك بما كانا عليه من قبل من تفكير أو تأمل للكون، وسأل عبد الرحيم نفسه.. لماذا غادر مدينته الصغيرة لكي يرى هذا الذي يوشك على الموت؟ ليدع مشاعره الخاصة وفلسفته في أنه قد مات منذ أسقطه من عالمه تمامًا، فوجوده المادي قائم رغم أنفه، نعم... لماذا استجاب الرجاء سالم ورضي أن يذهب معه لرؤية الصديق القديم؟ هل لأنه خاطب فيه قيمه؟ فكيف يكون مجردًا من الرحمة والشفقة ونقاء القلب وهو أحق بهم دونهم جميعًا؟ هكذا قال سالم مستفزًا أو إقرارًا منه بالحقيقة.. أم أنه يذهب إليه مستعليًا بإيمانه متشفيًا شامخًا بأنفه؟ وماذا لو حاول أن يستتيبه ويرده إلى الحق والخير متجاوزًا عن إساءاته له؟ ولعله الآن يسعى إلى ذلك، وها هو ما زال يرى فيه ذلك الرمز، لذا أرسل يدعوه إليه قبل أن يفارق.. خفق قلبه، وتساءل.. ماذا يدور في قلبه الآن؟
استغرق في تأمل ما بنفسه، وتذكر غدره وخيانته، وطغت الآلام.. ولم يجد في قلبه ميلًا لاستتابته وأن تسعه رحمة ربه، وجل وهو يحس كان ضوءًا يكاد يغشي عينيه، ونداء يريد أن ينفذ إلى أذنيه، وقلبه ينطق رغمًا عنه أأنت تملك خزائن رحمة ربك؟! كان القطار يطرح ما بداخله من البشر... ساروا زرافات ومثنى ووحدانا.. البعض يفكر في أعماله التي يريد أن ينجزها، وآخرون تشغلهم هموم وأحزان أو أفراح وآمال، وعلى الرغم من ذلك.. كان الكل يمشي على قدميه آمنًا، أما في ذلك اليوم.. الكل عار ولا يرى أحد عورة أحد الكل خائف مرتعب لا أحد يعرف أحدًا ولو كانوا فلذات أكباد.. الكل يريد أن ينتهي ذلك اليوم المشهود ولو أن يطرح في السعير.. تذكر عبد الرحيم يوم أن دار بينهما حديث عن البعث والنشور والملائكة والجنة والنار، صاح الصديق القديم حينذاك متمازحًا.. أتصدق بهذا كله؟!
ثم أسرع وهو يرى الإنكار والدهشة على وجهه مرددًا.. أنا أمزح.. أنا أمزح... المسار قد تغير، وكان لم يكن ما زال وجوده بينهم يمثل الضمير.. ما الذي ذكره بهذا الموقف الآن فلم تعلوه تلك السنون؟ ظل فترة في حينها يسترجع ذلك الموقف من الصديق القديم قبل أن يفترقا، وتساءل كثيرًا.. هل كان ضلاله مستترًا، وكانت هذه فلتة لسان كشفت عن خباياه؟
هو كان يؤدي الصلوات معه، ويردد معان كثيرة كان يتداولها مع مجموعة الأصدقاء حينذاك، لكنه كان يعرف أيضًا أنه يفلت كثيرًا من الصلوات خاصة عندما يكون بعيدًا عنه والآن وهو يوشك على أن يكون في أحضان الموت.. ترى هل يرى كل ذلك الآن؟
عاد يتأمل مشهد الجموع وهي تتبدد وتتفرق خارج محطة القطار..
نزل الرفيق من السيارة يتبعه عبد الرحيم ووقفا أمام مبنى صغير من طابقين يحيط به سور حديدي منخفض، وفي المدخل على جانبي درجات سلم قليلة.. استقرت بعد أصص فخارية بها بعض نباتات الزينة، ورأى عبد الرحيم كذلك شجرتين ترتفعان حتى تلامس فروعها بعض نوافذ الطابق العلوي... من غرفة ملأى بالبراغيث تقع على مقربة من حظيرة بها جاموسة ووليدها الصغير وحمار لا يكف عن النهيق هناك في قرية صغيرة من قرى الريف المصري إلى شبه قصر في حي راق من أحياء العاصمة، ومن النوم على حصير إلى فرش ناعمة ووسائد لينة مريحة وسجاجيد ومقاعد فاخرة بلا شك.. رحمة الله على شعارات العدل والكفاية، وكل حسب حاجته التي كان يهتف بها في كتاباته عندما جعل من نفسه ذيلًا لقوافل العبث والضلال ليسلطوا عليه الأضواء.. أشعرته تلك المفارقة التي يراها لأول مرة ماثلة أمامه بالرضا عن النفس، كما كان زهده وإيمانه ينقيان سريرته من الحسد وهو بطبيعته لم يكن ممن يتطلعون كثيًرا إلى ماديات الحياة وبذخ العيش، فلم تكن هدفًا كبيرًا من أهدافه، وهو نفسه في فقره ويسره الآن إلى حد ما هو هو لم يتغير..
أشعرته تلك المفارقة بالتفوق، وربما يتأكد له ولهم الآن حقيقة مع النفس، وأخذ يتمتم بصوت هامس لا يسمعه أحد، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورة التوبة: 119)
وقف رجل أقرب إلى الشباب يستقبلهم، لم يكن عبد الرحيم يعرفه، ولكن سالم سرعان ما قال: عزيز بك.. صهره...
وعندما أشار إلى عبد الرحيم قاطعه عزيز قائلًا.. نحن نعرفه من قبل أن نراه.. مرحبًا بك.. كانت يده معدودة، ومد عبد الرحيم يده بذاك الوجه الذي لا يريد أن تتبدل ملامحه العابسة ظنها عزيز أنها تعكس مشاعر صديق قديم جاء في وقت أليم، وسرعان ما سحب عبد الرحيم يده، وكأنه كان مكرها على تلك المصافحة.. تبادل عزيز وسالم كلمات قليلة، والتفت سالم إلى عبد الرحيم وقال... بعض الأصحاب يرغبون في لقائك.. قالوا نتصل بهم عند مجيئك كانوا على ثقة من... قاطعه بحزم قائلًا.. لا.. لا أريد أحدًا...
جلسوا على المقاعد بفناء الطابق العلوى وقال عزيز وهو يستشعر لسبب خفي وجلًا وضيقًا منه في آن واحد.. للأسف فقد النطق أخيرًا.. قبل مجيئكم، لكنه لم يفقد الوعي بعد.. هو يعرف الذين حوله ويعي حديثهم، هو الآن نائم.. نائم..
جاءت صبية ناضجة لم تخف عليه ملامحها، وقال سالم.. لينا .. لينا ابنته... لأول مرة ينبسط وجهه المشدود، وابتسم لها مرحبًا، وتبادل معها بضع كلمات همساء واستراحت إليه فجلست إلى جواره، وأسرع عزيز قائلًا.. هيا.. لينا.. اذهبي إلى ماما.. ابق معها.. وكأنه يريد أن يشعر عبد الرحيم بأنه غير مرغوب فيه، بينما قال سالم موجهًا حديثه إلى لينا.. أرسلي أخاك رمسيس...
تركت الابتسامة طيفها على وجه عبد الرحيم، ثم عاد إلى وجهه ذلك القناع الصخري، ولم يلتفت أو ينظر إلى أي منهما، بدوره بدا كمن يريد أن يثبت لهما أنه فقد الإحساس بوجودهما.. لينا.. هكذا تردد في خاطره.. أين هذا من ست الدار، وست أبيها وكعب الدار، وأم عوينة، والجلادة؟
أسماء كثيرة يعرفها الصديق القديم وكثيرًا ما كان يرددها على لسانه وفي كتاباته وبعضها تسمي بها بعض نساء من أسرته... لتكن أسماؤهن من بقايا عصور السلطة والتخلف والجهل أو عبيد المماليك والإقطاع فأين تلك الأسماء الرقيقة المحببة.. زينب، خديجة، أسماء، الزهراء، ياسر، خالد، محمد، وأحمد؟ لكن لينا هذه.. لينا خير له لو كان قد سماها «ولاء»، ورمسيس لا شك أنها نزعة فرعونية محنطة.. لماذا لم يختر اسمًا آخر غير هذا الاسم حتى لا يلتبس اسم ولده بين أصحاب الديانتين هنا؟ قال عزيز فجأة وهو يتطلع إلى الساعة... موعد الدواء.. يجب أن أوقظه الآن...
همس سالم.. أستاذ عبد الرحيم، حالته فيما يبدو تتدهور كن رقيقا معه.. لا تنسى أنه كان أقرب إليك منا.. تأخر عزيز، وسمع عبد الرحيم حركة فتح وغلق أبواب.. حدثته نفسه أن هناك معركة داخل الغرفة بين عزيز وأخته.. ترى ماذا يجري بغرفة الصديق القديم؟ انفتح الباب فجأة، وخرج عزيز عابس الوجه، ومن وراءه امرأة برداء البيت عارية الرأس كاشفة الوجه والنحر.. كانت تبدو كدرة منفعلة، ومدت يدها مصافحة، لكن عبد الرحيم تجاهل اليد الممتدة إليه، وردد كلمات مضطربة وهو يبعد نظراته منها جانبًا.. ارتبكت واضطربت وجحظت عيناها، ثم أسرعت تغادر المكان..
كان عاقدًا العزم على بلوغ نهاية الرحلة وقد خرج إليها، وبذكائه أدرك أن عزيزًا رافضًا لهذا اللقاء بوحي من مشاعره الخاصة، وقد صدق حدس عبد الرحيم، لكن عزيزًا لم يستطع أن يفرض رأيه على أخته التي صممت على تحقيق رغبة زوجها وأصرت على أن لا تحرمه من رغبة، تمكنت منه مهما كان الثمن...
سار عبد الرحيم إلى جوار سالم خلف عزيز الذي تقدمهما، وولجوا الغرفة، لم يكن يحتاج إلى تأكيد مظاهر الترف والبذخ الذي تعكسه فرش الغرفة وكل محتوياتها.. وقف عبد الرحيم يتأمل ذلك الجسد المسجى على سرير ضخم فخم، والتقت العينان في نظرة طويلة، وعزيز وسالم يرقبانهما.. كان عبد الرحيم يدفع بنظراته كأنها سهام مسددة، والآخر قد تصلبت حدقتاه، لكن اهتزازات عينيه كانتا أسيرة نظرات عبد الرحيم.. هل كانت نظرات مرتعبة؟ أم خجلة؟ أم دهشة؟ أم حزينة؟
كان عبد الرحيم بدوره متوترًا مضطربًا وبدا أنه غفل عن إلقاء تحية ما، أو حتى لمسة يد حانية، أو كلمة عطف يقتضيها الموقف، وهتف عزيز بعد لحظات في انفعال.. هذا يكفي.. هيا بنا.. صاح المريض معترضًا والتفت عبد الرحيم إليه قائلًا.. اخرج..
بهت عزيز، وواجهه عبد الرحيم بنظرة غاضبة آمرة وهو يهتف.. قلت اخرج من هنا..
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله!!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل