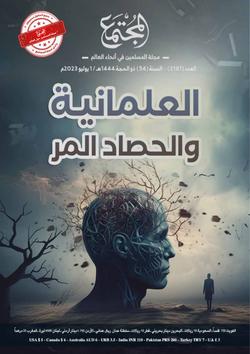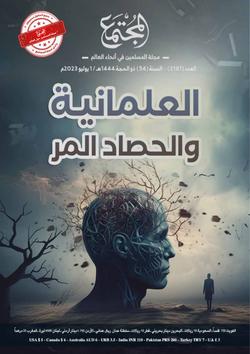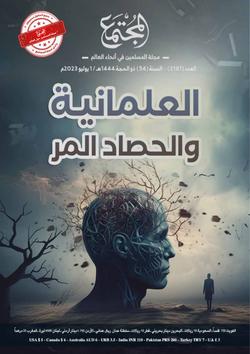العنوان اقتصاد (1590)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 28-فبراير-2004
مشاهدات 56
نشر في العدد 1590
نشر في الصفحة 48
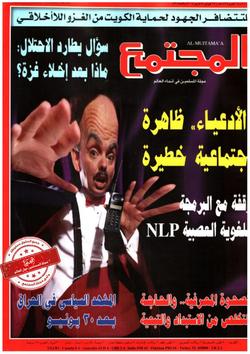
السبت 28-فبراير-2004
■ الديْن العام في دول العالم الإسلامي.. أزمة هيكلية اقتصادية
بعد مرور سنوات طويلة من السير في طريق الاستدانة الداخلية والخارجية تحت شعار التنمية الاقتصادية وجدت الدول الإسلامية نفسها في مأزق كبير، فلا هي حققت التنمية المطلوبة ولا أصبحت قادرة على سداد ديونها، وأمام هذا العجز عن سداد الديون واستجابة للضغوط «خصوصًا من المؤسسات الدولية» لجات تلك الدول إلى مزيد من الاستدانة وإعادة جدولة ديونها وفقًا لشروط الدائنين من خلال نادي باريس.
وقد ألقى الدكتور المرسي حجازي عميد كلية التجارة السابق في جامعة بيروت العربية محاضرة بعنوان: «الدين العام في دول العالم الإسلامي المشكلة والحلول» في جامعة الإمام الأوزاعي في بيروت، عرض فيها للواقع القائم في العالم الإسلامي على صعيد الديون والفوائد والقروض ودور صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية في هذا الواقع المتفاقم باستمرار، وخلص إلى نتائج وتوصيات قال فيها إن أزمة الدين العام في الدول الإسلامية أزمة هيكلية اقتصادية عميقة وليست أزمة مالية فحسب أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد أزمة نقدية وغذائية وبطالة، وأزمة الطاقة كلها تنبع من عدم ملاءمة السياسات الاقتصادية المتبعة في هذه الدول للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولخصوصياته.
وقال د. حجازي إن النظام الاقتصادي الإسلامي لم يطبق بعد في غالبية البلدان الإسلامية، وبدلًا منه تحاول تلك البلدان حل مشكلاتها من خلال تصميم سياسات تم وضعها في ظل الفلسفة الرأسمالية، ومن الواضح أنه على الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الغالبية العظمى لتلك الدول إلا أن هذه السياسات لم تفلح، لأن السبب الحقيقي لأزمة الديون العامة البلدان العالم الإسلامي «وإن ظهرت أسبابها المباشرة في الفجوات الاقتصادية المحلية والخارجية» هو الابتعاد عن الشريعة الإسلامية في مجالي جمع الأموال وإنفاقها والتي تظهر في الصور التالية:
الإنفاق غير المبرر على المظاهر والكماليات.
استخدام القروض العامة في تمويل النفقات الاستهلاكية بدلًا من تمويل النفقات الإنتاجية التي تدر دخلًا يمكن من خلاله سداد الديون.
ج- عدم الالتفات إلى الصيغ الإسلامية المتعددة في التمويل «القرض الحسن» أو الصيغ البديلة عن التمويل «المشاركة والمضاربة والإجارة، وغيرها».
كما أن السبب الرئيس لتفاقم المشكلة هو ارتفاع سعر الفائدة عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهكذا تلعب الفائدة «الربا» إضافة إلى عدم استخدام صيغ التمويل المشروعة الدور الأول لاتساع مشكلة الدين العام.
إن غالبية الدول الإسلامية التي تعاني من مشكلة عجز الموازنة وإتساع الدين العام بمرور الوقت، تجاوزت في برامج إنفاقها مقدرتها على تعبئة الأموال، ولذلك أصبح عجز كل من الموازنة وميزان المدفوعات عجزًا هيكليًا يستدعي ضرورة تغطيته سنة بعد أخرى. وهناك حاجة حقيقية نحو تعديلات جوهرية في المالية العامة لتلك الدول، ومراعاة التمييز بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري عند تعبئة الموارد وتفعيل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية الموارد الوطنية بهدف التنمية، كما أن الكثير من المشروعات العامة يمكن تنفيذه على أساس صيغ التمويل الإسلامية.
إن تحديد وظائف رئيسة للإنفاق العام وتحديد مصادر لتمويلها والالتزام بها في التطبيق يمكن أن يضمن القيام بتلك الوظائف، دون إهمال الوظائف العامة الأخرى، وهنا فإن برامج الدفاع وإزالة الفقر في بلدان العالم الإسلامي هي من بين تلك المجالات الرئيسة للإنفاق العام وسيساعد هذا التقسيم للموارد المالية، على أساس الوظائف في ترشيد الإنفاق العام وعدم الإسراف والتبذير في الأموال العامة خصوصًا الإنفاق على الكماليات ما دامت الضرورات لم يتم إشباعها بعد.
وينبغي تفعيل الصيغ الإسلامية في التمويل لتغطية عجز الموازنة العامة خصوصًا التمويل والمشاركة في الربح والخسارة والإجارة والقرض الحسن.
أما القروض المصرفية فإن مجالها محدود في البيئة الإسلامية، وقد تستخدم فقط في حال التوسع النقدي الذي لا يهدد الاستقرار النقدي.
وينبغي تطبيق فريضة الزكاة وإصدار قوانينها الملزمة، وذلك يمكن أن يوفر جانبًا مهمًا من إحتياجات الدولة في مجال الشؤون الإجتماعية، كما ينبغي تشجيع الدور الذي تلعبه الأوقاف الإسلامية في مجالات التعليم والصحة، وقد تحملت مؤسسة الوقف -تاريخيًا- المسؤولية الكاملة تقريبًا في توفير النظام التعليمي للكبار والصغار ومد المساجد بالعمارة والخدمة والرعاية وبناء المستشفيات والحدائق العامة، حيث يمكن القول إنه كان لنظام الوقف دور كبير في بناء البنية التحتية للخدمات الإجتماعية.
كما ينبغي تشجيع المساهمات التطوعية، خصوصًا مساهمات خدمة المجتمع من خلال العمل والمشاركة في الأنشطة الخيرية والثقافية، وبالمساهمة الخيرية بالعمل التطوعي تعد من أهم مصادر دعم التنمية وحل المشاكل الاقتصادية في الدول الإسلامية بسبب انخفاض مستوى الدخل الفردي وصعوبة التطوع بالمال، فما نحتاجه هو فحص دقيق لهيكل الإيرادات والنفقات وليس مجرد إصلاح مالي.
وهكذا يتضح لنا أن مشكلة اتساع الدين العام في بلدان العالم الإسلامي يمكن علاجها تدريجيًا على مدى فترة زمنية ممتدة شرط الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في مجالات اكتساب المال العام وإنفاقه، مع ضرورة تحمل الدول الدائنة لجزء من مسؤولية تفاقم المشكلة.
■ عملة تركية جديدة
عرض محافظ البنك المركزي التركي ثريا سردنجيشتي نموذجًا لليرة التركية الجديدة التي تم إلغاء ستة أصفار منها، والتي يبدأ التداول بها اعتبارًا من مستهل العام المقبل. وأشار سردنجيشتي إلى أن الدراسات الأولية لإلغاء سنة أصفار من الليرة بدأت في عام ۱۹۹۸ غير أن الدراسة لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم انخفاض نسبة التضخم في البلاد خلال فترة السنوات الماضية.
■ تركيا تصدر معظم إنتاجها من السيارات إلى الاتحاد الأوروبي
أعلن اتحاد المصدرين الأتراك في مدينة بورصة التي تعتبر مركزًا لصناعة السيارات التركية أن ٦٣.٩ من صادرات البلاد في قطاع صناعة السيارات خلال شهر يناير المنصرم التي تجاوزت قيمتها ٦۹۷ مليون دولار، تم تصديرها إلى الدول الخمس عشرة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وذكر تقرير نشره الاتحاد أن السيارات التركية جرى تصديرها إلى ١٢٤ دولة ومناطق حرة في خمس قارات وأن نحو نصف هذه الصادرات ذهب إلى خمس دول أوروبية رئيسة هي بريطانيا وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.
■ مجلس الأمن القومي الصهيوني: الأزمة الاقتصادية تمزق المجتمع
أصدر مجلس الأمن القومي الصهيوني تقريرًا قدمه مؤخرًا لرئيس الوزراء شارون تحت عنوان: «القضية الأكثر إشكالًا بالنسبة لنا، ليست القضية الفلسطينية وإنما الأزمة الاقتصادية التي تمزق مجتمعنا».
وورد في تقرير التقديرات السنوية، أن الدولة تستثمر ميزانيات كبيرة في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، الذي سيطر على غالبية مجالات الحياة، بدلًا من توجيه هذه الأموال لحل المشكلة الحقيقية وهي التهديد «الاجتماعي- الاقتصادي».
وقدم مجلس الأمن القومي توصيات عديدة في التقرير، منها تخصيص ميزانيات إضافية للوسط العربي في إسرائيل «داخل الخط الأخضر»، ودفع الإصلاحات في الجهاز التربوي والمبادرة إلى فرض الخدمة الوطنية على كل قطاعات المجتمع بما في ذلك القطاع العربي واليهودي المتدين.
و٤٢٠ ألف عاطل عن العمل
من جانب آخر، كشف تقرير أعدته المنظمة الاجتماعية «محويفوت لشلوم ولتسيدق حفراتي»، ونشر حديثًا أن عدد العاطلين عن العمل في الكيان الصهيوني أو المضطرين للعمل بشكل جزئي دون أن يكون ذلك بمحض إرادتهم، بلغت نسبتهم ١٦.٧، أي نحو ٤٢٠.٣ ألف شخص، خلافًا لما نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الرسمية من أن نسبتهم تبلغ 10.7، أي نحو ۲۷۷ ألف عاطل عن العمل.
وقالت المنظمة إن دائرة الإحصاء المركزية لم تأخذ في حساباتها نحو ١.7٪ من العاطلين عن العمل الذين ينسوا من الحصول على عمل وتوقفوا عن البحث عن عمل ويقدر عددهم المنظمة بـ ٤٣.٣ ألف شخص كما لا تأخذ الدائرة في حساباتها الذين يعملون بوظيفة جزئية دون أن يكون ذلك بمحض اختيارهم، ويشكلون نحو 4% أي مائة ألف شخص.
ويتضح من التقرير الذي أعده كل من الدكتور أريك بن شاحر والمحامي أفيشاي بینینش، أن عدد العاطلين عن العمل قد تضاعف تقريبًا خلال السنوات السبع الماضية من ١٥٠ ألف عاطل عن العمل في العام ١٩٩٦، حيث كانت نسبة البطالة عندها نحو 6٪، ليصل عددهم إلى ۲۸۰ ألف عاطل عن العمل في العام ۲۰۰۳، بحسب الإحصاءات الرسمية.
ويشير التقرير أيضًا، إلى أن عدد الأكاديميين من أبناء الطبقات الوسطى، الذين أضحوا عاطلين عن العمل ارتفع من ٢٦.٦ ألف شخص عام ٢٠٠١ إلى ٣٥.٧ ألفًا في عام ٢٠٠٢، أي ارتفاع بنسبة 34%، ويتضح من التقرير أيضًا أن نسبة البطالة كانت خلال العام ١٩٩٦ في أوساط الأقلية العربية أقل منها في الوسط اليهودي، ولكن ارتفعت هذه النسبة في عام ۲۰۰۲ لتصل إلى 13.4 وارتفع عدد النساء العاطلات عن العمل في الفترة نفسها من ٧٣ ألف امرأة إلى ١٢٤ ألف عاطلة عن العمل.
ويرسم التقرير المذكور صورة قائمة لوضع البطالة في الكيان الغاصب مقارنة بوضعها في الدول المتطورة، إذ تحتل نسبة البطالة في «إسرائيل» المرتبة الثانية من حيث ارتفاعها في الدول المتطورة بعد إسبانيا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل