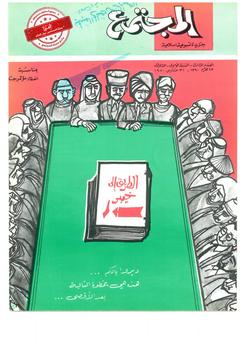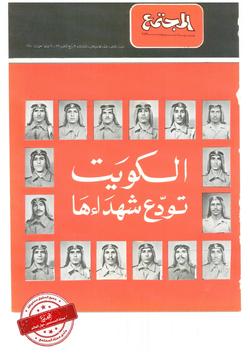العنوان التشريع الإسلامي وتطور الفقه في ظلها - الحلقة الثانية
الكاتب د. محمد الصادق عرجون
تاريخ النشر الثلاثاء 08-ديسمبر-1970
مشاهدات 15
نشر في العدد 38
نشر في الصفحة 12

الثلاثاء 08-ديسمبر-1970
التشريع الإسلامي وتطور الفقه في ظلها
الحلقة الثانية
محاضرة علمية قيمة ألقاها بجمعية الإصلاح الاجتماعي فضيلة الشيخ محمد صادق عرجون، والمجتمع حريصة على أن ينتفع المسلمون بهذا الفيض الكبير من المعرفة والعلم من أستاذ عرفته الأمة الإسلامية وتخرج على يديه وفود من الأساتذة والمعلمين.
الإنسانية اليوم فريضة رغم ما يتراءى في مسيرتها من ترسبات وهي في حاجة إلى تجربة جديدة لعلاجها من أمراضها.
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟؟
التخبط في القول والتفسير
وبهذا الذي يقوله أئمة الهدى يتبين موقف المغرورين الذين يخبطون في القرآن بآرائهم لمجرد الهوى، اعتمادًا على النظر إلى ظاهر الآيات ومعرفة معنى مفرداتها اللغوية، دون علم بشيء وراء ذلك من علوم القرآن وفنونه التي يلزم لمستنبط الأحكام أن يحيط بها علمًا.
والقرآن بهذه الاعتبارات كلها هو المرجع الأول لجميع مصادر التشريع في الإسلام، وهو الدستور الجامع للأحكام التي تفي بمصالح العباد، إما نصًا وتفصيلًا، أو دلالة وتأصيلًا، وذلك عند أكثر المفسرين وجمهور فقهاء الأمصار هو معنى العموم في قوله تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: 89)، وفي قوله تعالى ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ (الأنعام: 38).
ولم يختلف المفسرون في أن المراد بالكتاب في الآية الأولى وهي من سورة النحل هو القرآن الحكيم، لأنه هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول الزمخشري:
فإن قلت: كيف كان القرآن تبيانًا لكل شيء؟ قلت: المعنى أنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نصًا في بعضها وإحالة على السنة، حيث أمر فيه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وقال ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (النجم: 3)، وحث على الإجماع في قوله ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النساء: 115)، فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيين الكتاب، فمن ثم كان تبيانًا لكل شيء.
وهذا الذي قاله الزمخشري في آية النحل هو الذي ينبغي أن يفهم من آية الأنعام ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ (الأنعام: 38).
وإن ذهب الزمخشري نفسه إلى خلافه، واقتصر على أن الكتاب في آية الأنعام المراد به اللوح المحفوظ، وأن الآية واردة لإفادة أن أعمال العباد محصاة عليهم يجزون عليها صغيرها وكبيرها يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولذلك ذيلت بقوله تعالى ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ (الأنعام: 38).
وسلف الزمخشري في هذا الفهم الإمام أبو جعفر الطبري.
وحيث إن آية النحل لا سبيل إلى الاحتمال فيها، وأنها يتحتم إرادة القرآن من لفظ الكتاب فيها فينبغي حمل آية الأنعام على هذا المعنى وأن الكتاب فيها هو الكتاب في آية النحل، وهو القرآن بإجماع المفسرين توحيد للمعاني المتشاركة في آيات القرآن المتعددة، وخير ما فسر القرآن هو القرآن. وليست حكاية التذييل الذي أستدل بها الزمخشري بملزمة، وإنما هي مجرد استئناس يمكن تأويله، ولا تأويل في آية النحل.
وقد اختار الإمام الرازي إرادة القرآن من لفظ الكتاب في سورة الأنعام، واحتج لذلك على طريقته وأسلوبه العقلي وأطال رثاء القول معتمدًا على أن الدلائل الأصلية مذكورة في القرآن على أبلغ الوجوه وأما الدلائل الفرعية فهي مأخوذة من دلالة القرآن على حجية سائر الأدلة الشرعية المبينة في أصول الفقه، وهو يعني بذلك السنة، والإجماع، والقياس، والاجتهاد.
وكذلك ذهب إلى هذا في آية الأنعام أبو حيان، وقال وهو الذي يقتضيه السياق والمعنى، ويقول الآلوسي في آية الأنعام والمراد من الكتاب القرآن، واختاره البلخي وجماعة، فإنه ذكر فيه جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا، وغير ذلك إما مفصلًا، وإما مجملًا، فعن الشافعي عليه الرحمة: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الهدى فيها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الشافعي أنه قال: أنزل في هذا القرآن كل علم وبين كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن.
وقد كان القرآن الكريم ينزل في أول البعثة بآيات العقيدة والتوحيد، وبيان عظمة الله تعالى، وباهر قدرته ونافذ حكمته، ليقتلع جذور الوثنية والشرك، ويطهر النفوس البشرية من دنس التعبد لغير الله تعالى الواحد الأحد العليم القهار.
وبهذه الآيات أيقظ العقل الإنساني من سباته، وحرره من ربقه التقليد البليد، وأعلن سلطانه في حرية التفكير وجعله نقطة الارتكاز في التكليف، ودعاه إلى النظر في ملكوت الله ليتدبر آياته الكونية حتى يعلم أن هذا الكون العظيم في دقة نظامه وأحكام صنعه، وتدبير أمره يستحيل أن يكون وليد المصادفة العمياء بل لابد أن يكون له خالق مدبر حكيم، قادر قاهر عليم ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور: 35) ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ (الأعراف: 185)، ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: 190)، ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ﴾ (الروم: 20)، وهكذا مما يجده كل متصفح للقرآن الحكيم في عرض بسيط من غير تفلسف ولا تعقيد.
وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاث عشرة سنة في مكة يجاهد بالقرآن، يعرض ما ينزل عليه من الآيات مشتملة على الحجج والبراهين لتوطيد العقيدة في النفوس، وكان أسلوب القرآن في هذا الدور قويًا قاهرًا، مليئًا بالزجر المرعب، والتقريع المرهب للذين ألغوا عقولهم، وغفلوا عن النظر في عظمة الوجود، وتعبدوا لأوثان ينحتونها بأيديهم.
ولم ينزل في هذا الدور من التشريع العملي إلا القليل، والركن الوحيد من أركان الإسلام الذي تم تشريعه بمكة هو الصلاة التي فرضت ليلة الإسراء، والإسراء كان بمكة في أوائل البعثة.
ويمكن اعتبار ما نزل من القرآن في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، وهو ما يسمى في اصطلاح علماء القرآن بالمكي الطور الأول من أطوار التشريع اعتبارًا لما فيه من تأسيس العقيدة وبيان أحكام الصلاة، وما يترتب على ذلك من أحكام عملية في الفعل والترك.
وشرع الجهاد
وهذا الطور من الناحية التشريعية العملية لم يأخذ الاتجاه الفقهي القانوني إلا بعد الهجرة إلى المدينة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر مع أصحابه من المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة شرع الله الجهاد لرد اعتداء المعتدين وإزالة العقبات من طريق الدعوة إلى الله، وفي ذلك نزل قول الله تعالى ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ﴾ (الحج: 39-40)، وترتب على الجهاد وجود أموال الغنائم والفيء والأسرى فنزل التشريع التفصيلي في طريقة توزيعها وأحكامها وطريقة معاملة الأسرى، ثم شرعت صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وشرعت أحكام الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة، وما يترتب عليه من أحكام في حالتي الوفاق والخصام والبقاء والانفصال، وشرعت الزكاة أحكامها ومقاديرها وموارد إنفاقها، وشرع الحج إلى البيت الحرام واتسعت المعاملات بين المسلمين، فشرعت أحكام البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا تحريمًا قاطعًا لا يحتمل التأويل والدوران، ورخص للناس في العرايا والسلم لحاجتهم في تحقيق مصالح الحياة المعاشية فيما بينهم، وشرع لتبادل المنافع والتعاون بغير ظلم القراض والمضاربة، والرهن والوقف والوصايا، وشرعت المواريث على أساس عادل حكيم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأب نصيب، وللأم نصيب، وللأخوة نصيب، كل ذلك على حسب الأحوال التي يكون عليها المتوفون مما هو مفصل في كتب الفروع الفقهية.
وشرعت العقوبات
وقد اتسع المجتمع الإسلامي ودخل فيه كثير من مختلفي الأمزجة و المشارب وازدحم الناس على مطالب الحياة وتنازعوها بينهم فوقعت اعتداءات على الحقوق في الأموال والأعراض والأنفس، فشرعت الحدود والجنايات واحتاج الناس إلى القضاء والفتوى، فما شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء الله تعالى أو أخبر أصحابه بحكمه، وما لم يشهده رسم الطريق للتصرف فيه ممن له أهلية التصرف والنظر الصائب في الاستنباط وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويبلغهم عن الله، ويحرضهم على نقل هذا العلم إلى من لم يحضره ولم يسمعه منه فيقول «نضَّرَ اللَّهُ امرأً سَمعَ منَّا حَديثًا فبلَّغَهُ، فرُبَّ مُبلَّغٍ أَحفَظُ مِن سامِعٍ» وكانت بعض التشريعات تفوت بعض الأفراد، فلا يقع لهم العلم بما نزل فيها، فإذا وقعت لهذا البعض حادثة سأل عن حكمها.
وقد اشتهر بعض الصحابة بالحرص على العلم وسعة الرواية ودقة النظر التشريعي كالخلفاء الراشدين والعبادلة وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وعائشة أم المؤمنين فكانوا يفتون فيما يعرض عليهم من الحوادث والمسائل بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين للقرآن كما أخبر الله بذلك في قوله تعالى:
﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: 44)، وقوله ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر: 7).
ومن هنا كانت السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره هي المنبع الثاني للفقه والتشريع في الإسلام وبها يبدأ طور آخر للتشريع أوسع مدى في أحكام الحوادث العملية والتشريع القضائي.
فالسنة بمراتبها الثلاث القول والفعل والتقرير هي المرجع البياني الأول لمقاصد القرآن الكريم، روى أبو داود في مسنده عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«أوتيت الكتاب ومثله معه» قال الخطابي في شرح هذا الحديث قوله «أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن معناه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الوحي الظاهر المتلو.
والثاني قال بعض العلماء: معناه أنه أوتي الكتاب وحيًا يتلى، وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين الكتاب فيعم ويخص، ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب، فيكون وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن، ثم قال الخطابي: فأما ما رواه بعضهم منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فاتركوه» فإنه حديث باطل لا أصل له، وقال القرطبي: البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين: بيان لمجمل ما في الكتاب، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وبيانه لمقدار الزكاة ووقتها ونوع المال الذي تجب فيه، وبيانه لمناسك الحج، وقال إذ حج بالناس:
«خذوا عني مناسككم» وقال لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وبيان آخر هو الزيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، والقضاء بالشاهد واليمين.
وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذوى البطنة والترهل العقلي من المترفين في حديث إنكار الشبعان المتكئ على أريكته الأخذ بالسنة وإهدار العمل بها معجز اخترق بها صلى الله عليه وسلم حجب الغيب وأخبر عما وقع في أمته بعد ذلك، فقد ابتليت السنة المطهرة قديمًا وحديثًا بمن أنكر العمل بها، ورأى عدم اعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع وزعم هؤلاء المنكرون على السنة أن الأحاديث مشكوك فيها ودخل عليها الوضع والكذب أفلا نترك كتاب الله الثابت المقطوع به لأمر مشكوك فيه، وقد أغفلوا جهود المحدثين في تنقية الحديث وغربلة رجاله مما لم يعرف في تاريخ أمة غير الأمة الإسلامية، وقد انتهض الإمام الشافعي رضي الله عنه قديمًا للرد على هؤلاء المنكرين في كتابه «الأم» فزيف أقوالهم وانتصر للسنة وأثبت صحة الاحتجاج بها باعتبارها الأصل الثاني للتشريع في الإسلام.
وفي عصرنا هذا تحركت طائفة من المتحللين تردد ما ردد أسلافهم من التشكيك في السنة، ولكن الله تعالى ردهم على أعقابهم خاسرين، وبقية السنة المطهرة حجة للتشريع الإسلامي إلى جوار كتاب تعالى نبين مجمله وتفسر مبهمه، وتخصص عمومه، وتشرع ما لم يرد به نص في آياته بوحي من الله تعالى، فالوحي بالسنة كالوحي بالقرآن واجب الطاعة والعمل به، والفرق بينهما أن القرآن قطعي النص ثابت ثبوتًا لا ارتياب فيه والسنة، فيها القطعي والظني، وكل ما ثبت منها برواية الثقاة يجب العمل به، وقد جعل الله تعالى طاعة الرسول واتباعه من طاعته تعالى واتباعه قال تعالى ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ﴾ (النساء: 80)، وقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (النساء: 59)، وقال ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: 31).
وقد تعرض الحادثة لمن لم يسمع حكمها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحادثة التي لم يرد في شأنها وأمثالها حكم منصوص صريحًا فهذا النحو قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق الحكم فيه، والعمدة في الاستدلال على هذا أحاديث بلغت من الكثرة حدًا يرفعها إلى إفادة العلم بمعانيها المشتركة، وأشهرها حديث معاذ لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو صريح في إثبات جواز الاجتهاد بالرأي وعند عدم النص، قال ابن القيم: وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصًا عن الله ورسوله، فقال شعبة حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ بن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن «قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: اجتهد رأيي، لا آلو، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري، ثم قال: الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».
قال ابن القيم:
فهذا حديث وإن كان مرويًا عن غير مسمين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهر الحديث، وأنه مروي عن جماعة من أصحاب معاذ لا عن واحد منهم وهذا أبلغ في الشهرة، كيف وأصحاب معاذ في شهرتهم بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى.
موقف الرسول من المجتهدين
وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في أحكام الحوادث باجتهادهم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادهم وبلغه فضلهم فلم يعنف أحدًا منهم ولا عاب على أحد منهم اجتهاده فرده، بل أقرهم على فعلهم وهو مختلف في الحادثة الواحدة ومن ذلك اجتهادهم في فهم نصه صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة فاجتهد فريق منهم وصلاها في الطريق، وقالوا مجتمعين لرأيهم وفعلهم: لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، ولم يقفوا عند حرفية النص، واجتهد فريق آخر منهم وأخروا صلاة العصر إلى بني قريظة فصلوها ليلًا ناظرين إلى اللفظ.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أصحابه بهذا الاجتهاد فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن معاذ سيد الأنصار بالحكم في بني قريظة باجتهاده، فحكم فيهم سعد وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات»، ومن أشهر مسائل الاجتهاد بالرأي تسوية أبي بكر رضي الله عنه بين الناس في العطاء، وقال إنما هذا بلغة الدنيا ومعاشها فالأسوة فيه خير من الأثرة وجزاء الأعمال عند الله، وخالفه عمر رضي الله عنه ففرق في أعطيات الناس وقال: لا أجعل من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البقية في العدد القادم
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلبرقية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى مؤتمر وزراء التربية العرب في ليبيا
نشر في العدد 3
112
الثلاثاء 31-مارس-1970