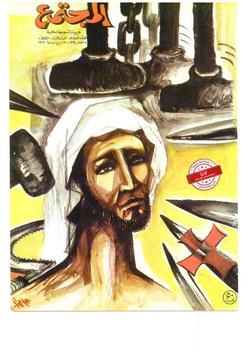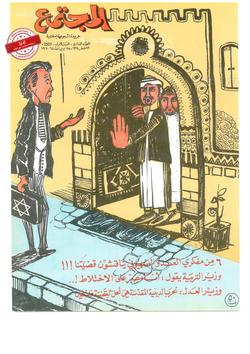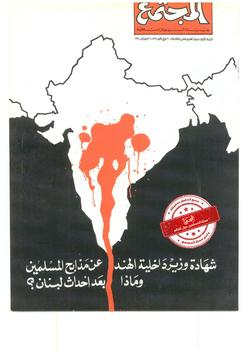العنوان التشريع الإسلامي والمجتمع المتطور (198)
الكاتب محمد سلام مدكور
تاريخ النشر الثلاثاء 30-أبريل-1974
مشاهدات 15
نشر في العدد 198
نشر في الصفحة 19
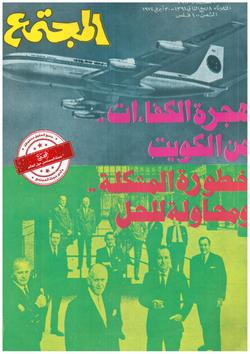
الثلاثاء 30-أبريل-1974
ألقى الأستاذ الدكتور محمد إسلام مدکور رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة. والأستاذ المعار لجامعة الكويت - ألقى محاضرة قيمة موضوعها «التشريعي الإسلامي والمجتمع المتطور».
وذلك بقاعة المحاضرات بالمقر المركزي لجمعية الإصلاح الاجتماعي في منطقة الروضة.. وتعميما للفائدة تنشر «المجتمع» فيما یلي الحلقة الثالثة والأخيرة من محاضرة الأستاذ الدكتور محمد سلام مدکور.
صور من تقدمية التشريع الإسلامي
جاء التشريع الإسلامي كما قلنا شاملا كل ما يتعلق بتصرفات الناس، ما يرجع منها إلى العبادات الصرفة، وهي ما كان الغرض منها التقرب إلى الله، وهذه محدودة ثابتة مستقرة لا تتأثر باختلاف الناس في بيئاتهم وأزماتهم. ومن أجل هذا بيّنها الرسول عليه السلام بسنته أکمل بيان، وما يرجع منها إلى العادات والمعاملات وهي ما كانت لتنظيم علاقات الأفراد أو الجماعات أو لتحقيق مصلحة دنيوية وهذه معقولة المعاني رُوعي فيها أعراف الناس ومصالحهم، وأنها تتغير بتغير الأزمان والبيئات من أجل هذا جاءت أحكامها أصولا كلية وقواعد عامة مقرونة بعللها، حتى يفهم أن الحكم ينبغي أن يكون مصاحبًا لعلته، فإذا زالت العلة ارتفع الحكم وتبدل بآخر يتناسب مع تغير وجه المصلحة. يقول القرافي المالكي «إن كل ما في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيها عند تغير العادة المتجددة».
وإذا كان الفقهاء في العصور السابقة لم يبوبوا الأحكام الفقهية كما هو الآن بالنسبة لفقه القانون فإن هذا كان منهجهم في شتى نواحى العلوم والمعرفة، كما أن القضاء عندهم في صدر الإسلام لم يكن في حاجة إلى التخصص الدقيق نظرا لقلة لخصومات والتزام الناس بحكم الإسلام الحق في أعمالهم وتصرفاتهم غالبًا.
ولذا فإن القاضي كان غالبًا ينظر في كل نزاع يعرض عليه في الصدر الأول نظرا لقلة الخصومات في دائرة اختصاصه ككل، وإن وجد التخصص الدقيق أحيانًا.
وواقع الأمر أن الفقه الإسلامي تناول جميع النواحي التي تناولتها القوانين الحديثة، سواء منها ما ينظم علاقات الأمة الإسلامية بالأفراد الأجانب المقيمين بها، أم المتقاتلين مع أفرادها وهو ما يسمّى حديثًا بالقانون الدولي الخاص.
أم كان ينظم علاقات الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم مما يسمّى بالقانون الدولي العام، أم كان ينظم العلاقات الداخلية في الأمة عاما كالقانون الدستوري والإداري والمالي والجنائي أم خاصا كالأحكام المتعلقة بالأسرة وسائر القوانين المدنية والتجارية وما يتعلق بذلك كله من نظام المرافعات. كما أن أحكامه طبقت في مختلف أنحاء الدولة الإسلامية على اتساعها حقبة كبيرة من الزمن كانت الأمة الإسلامية فيها في أوج القوة والازدهار والتقدم الحضاري، وإذا ما عقدنا موازنة عامة بين القوانين المعاصرة وما يشمله الفقه الإسلامي من فروع قانونية لوجدنا أنه فيما يتعلق بمركز الدولة وكيانها وعلاقاتها بالدول الأخرى وهو ما يقابل القانون الدولي العام تناوله كتاب الله في سورتي الأنفال والتوبة على وجه خاص. كما جاءت السنة بكثير من أحكامه. ولنا في المعاهدات التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نص عليه في عقود الصلح، وما أثر عن الصحابة أصل ومرجع.
وإذا كانت القوانين حديثا قد اجمعت على احترام المعاهدات فإن الإسلام أسبق منها في الوفاء بالعهد، يقول الله سبحانه «1» ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ﴾ (النحل: 91). وقد حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على المعاهدات التي احترمها خصومه.
أما ما نقضه الخصم فقد عاملهم فيها بالمثل ومن قواعد الإسلام أن المعاهدات لا تنقض بجنايات بعض الأفراد، وإذا وادع المسلمون قومًا من المشركين فإنه لا يحل أن يأخذوا شيئًا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم احترامًا للعهد. ففقهاء المسلمين من قديم تناولوا علاقة الدولة الإسلامية بغيرها في الحرب والسلم، وعنونوا لذلك بكتب السير والمغازي، وقد برع محمد الحسن الشيباني الفقيه الحنفي من فقهاء القرن الثاني الهجري في هذا، وأخرج كتابين سمّى أحدهما السير الكبير والآخر السير الصغير، مما جعل رجال القانون يعتبرونه أبا لهم، وألفوا باسمه جمعية خاصة تبحث ما كتبه وقالوا عنه: إنه خليق بأن يأخذ مكانه الحق بين رواد القانون الدولي العالميين، كما أخرج أيضا الإمام الأوزاعي فقيه الشام كتابًا في السير، ورد عليه وناقشه في وجهة نظره القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحبه.
وبالجملة فإن العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها تقوم دائما على أساس العدالة مع المعاملة بالمثل عند القدر، كما عرف الفقه الإسلامي حماية السفراء وممثلي الدول ومنحهم الحصانة كما أقر مبدأ التعايش السلمي.
أما فيما يتعلق بالدستوري والإداري فإن الفقهاء بحثوا ذلك تحت اسم السياسة الشرعية والأحكام السلطانية والإمامة والسياسة. وقد أخرج بعضهم في ذلك كتبًا خاصة مثل «السياسة الشرعية لابن تيمية، والطرق الحكمية لابن القيم، والأحكام السلطانية للماوردي، وقد كان الكلام عن الخلافة ورياسة الدولة من صميم بحث الفقهاء، فأوجبوا أن يكون للأمة رأس حاكم مسؤول، وأن تكون شؤون الحكم شورى بينه وبين الأمة في أشخاص ممثليها، ولم تحدد نصوص الإسلام غير هذه الخطوط العريضة حتى يتسع التطبيق لكل تطور مفيد نتيجة التجارب المتعاقبة.
- كما قرر الفقه الإسلامي حرية المواطن في نطاق الحفاظ على كيان الجماعة، ومع هذا فألزم أفراد المسلمين بمبدأ ثابت لا يقبل التطور، هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فمن ولّى الفضول متعمدًا مع وجود الأفضل كان خائنًا للأمانة. وسوت قواعد الإسلام الدستورية بين الناس في الحقوق والواجبات، وجعلت أساس الحكم الشورى، وتصرفات الحاكم في شؤون الرعية خاضعة لرقابة الأمة، وأوجبت على الرعية طاعة الحاكم ما لم يخرج على حكم الشرع، إذ طاعته مستمدة من طاعة الله ورسوله ومعطوفة على طاعة كل منهما بدليل عدم تكرار فعل أطيعوا بالنسبة لأولي الأمر في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: 59).
- وأما القوانين المالية فإن الفقهاء بحثوها ضمن أبحاثهم وكتاباتهم الفقهية عن الزكاة والعشور والخراج وعند بيان وأحكام الكنوز والركاز التي في باطن الأرض بحكم الطبيعة، بل ومنهم من أفردها بالبحث والكتابة كأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وكأبي يوسف الفقيه الحنفي في كتابه الخراج، ويحيى بن آدم في كتابه الخراج أيضا.
فالناحية المالية والاقتصادية وضعت لها في الإسلام قواعد العدالة الاجتماعية ووضحت فيها معالم الطريق في مدى حرية الاستثمار والتملك. أموال الأفراد محمية، وتملك المال وإن كان حقًّا مطلقًا غير أنه مقيد ببعض قيود تعود على الجماعة بالنفع، كما أن الأموال العامة مرصودة لمصالح الأمة ومنفصلة عن ملك الحاكم.
- والعدالة الاجتماعية في نظر الإسلام في واقع الأمر مساواة إنسانية ينظر فيها إلى تعادل جميع القيم، بما فيها القيمة الاقتصادية وهي على وجه الدقة تكافؤ في الفرص وترك المواهب بعد ذلك تعمل في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا، وهذه مفخرة للإسلام يزهو بها على جميع النظم الاجتماعية شرقيها وغربيها. فنظرة الفقه الإسلامي في الواقع تهدف إلى صلاح الفرد والمجتمع، والنزعة السائدة فيه هي النزعة الجماعية، فهو يعمل غالبًا على الحد من سلطان الفرد إذا تعارض مع الصالح أو أساء الفرد استعمال هذا الحق، ومن هذا نزع الملكية جبرًا عن صاحبها بالقيمة للمنافع العامة، فقد حدث في أيام عمر نزع ملكية بعض دور الصحابة المحيطة بالكعبة، وهدمت بعد أن قدرت قيمتها لما رفض أصحابها بيعها، ثم ألحق مكانها بالحرم المكي لتوسعته تم تكرر هذا في عصر عثمان، ومن هذا استيلاء الحاكم على الفائض من الأقوات بالقيمة لإمداد الجنود أو إمداد جهة انقطع فيها القوت، ومنه استيلاء الحاكم على عمل الصانع والزارع والعامل إذا احتاج الناس إلى صناعته وزراعته وعمله، ومنه إجبار المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل وتسعير السلع لمصلحة الجماعة.
- ومن باب مراعاة مصلحة الجماعة على حساب حق الفرد ما فرضه الله في حال الأغنياء حقًّا للفقراء وما تفرضه الدولة من ضرائب تجبى وتجمع لينفق منها على الصالح العام وذي الحاجة من المسلمين وغيرهم من المواطنين. فالإسلام وإن حد حرية الأفراد في أموالهم مراعاة للصالح العام إلا أنه دون إسراف في ذلك أو تضييق على أصحاب رؤوس الأموال، ولكن بالقدر الذي يكفل الضمان الاجتماعي ومراعاة شؤون الدولة. ورضي الله عن الإمام علي فقد كتب لولاته يقول «ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج من غير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد». فهل هناك عدالة اجتماعية تفوق هذه العدالة؟ وهل يوجد نظام للضمان الاجتماعي يفوق هذا النظام.
الذي جعل نفقة الفقراء في مال الأغنياء إذا لم يتسع بيت المال لنفقتهم؟ والذي جعل أفراد الأسرة الكبيرة يتضامنون في المعيشة فأوجب النفقة بين الأقارب؟ كما جعل الدولة بعد ذلك مسؤولة عنهم.
- وأما القانون الجنائي:
فقد جعل الفقه الإسلامي الجنابة لا يتحمل مسؤوليتها غير الجاني بعد أن كانت القبيلة كلها تتحمل المسؤولية، وتكلم الفقهاء عن الجريمة والعقوبة والجرائم التي عقوبتها محددة والجرائم التي ترك فيها تقدير العقوبة لولاة الأمر، ومن بعدهم القضاة. كما تناول الفقه الإسلامي حكم العفو عن الجريمة وأثر ذلك في سقوط حق المجني عليه وحق العامة، وفي سقوط العقوبة، وبين أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولم يجعل الفقه الإسلامي للنصوص الجنائية أثرًا رجعيًّا إلا ما كان تطبيقه في صالح الجاني إلا الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام فقد استثناها من قاعدة عدم الرجعية ولم يجعل الفقه الإسلامي لدم أحد فضلا على دم آخر. وليس في الإسلام من هو فوق القانون وإنما نص الفقهاء على أن السلطان يقتص منه إن تعدى على أحد أفراد الرعية بالقتل العمد العدوان، والإسلام وإن أقر عقوبة القصاص فإنه لم يتغال في ذلك وإنما قصر المسؤولية الجنائية على الجاني وجعلها بقدر جنايته. ومع هذا فقد حبب العفو إلى النفوس. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان الفقه الإسلامي جعل حق العفو لولي الدم فإنه لم يقصر حق طلب القصاص عليه، كما أنه ليس لولي الدم على الراجح أن يستوفي حق القصاص بنفسه لأن تخليص الناس بعضهم من بعض من وظيفة الحكام. وإذا أخذت الشفقة بعض الناس على السارق عندما يقام عليه الحد فإن الأجدر بهم أن تأخذهم الشفقة بالآمنين الذين روعهم هذا السارق في مأمنهم واعتدى على حرمتهم وعرض حياتهم للخطر والضياع، ومع هذا فإن الحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات أي أن الشك يفسر لصالح المتهم.
كما أن الإسلام فتح باب التوبة أمام المذنبين حتى لا يفقدوا الأمل في ثقة المجتمع بهم وغفرانه لهم زلتهم، فقد شرع العفو عن بعض الجرائم وجعله حق القاضي إذا رأى في ذلك علاجا لنفس المجرم وشفاء لها، ومن ذلك فإن الإسلام حث على عدم تعيير المجرم بجريمته حتى لا تستمرئ نفسه طريق الإجرام.
- وأما القانون الخاص:
فإن الفقهاء أولوه عناية فائقة وبخاصة فيما يقابل القانون المدني وما تفرع منه وقانون المرافعات وما يتعلق بالأسرة من أحكام. فأبانوا الحقوق والمنافع والأموال وطرق تملكها وما يتعلق بذلك من التزامات وضمانات وتكلموا عن الشركات وشروط تكوينها وما يتعلق بها من أحكام، وتكلموا عن المدين المعسر والمفلس والمماطل، وتناولوا الشخص من ناحية أهليته وولايته وما يعرض لهذه الأهلية والولاية.
كما تناولوا التضمين وهو ما يقابل المسؤولية المدنية وتناولوا المسؤولية عن فعل الغير مما يعرف باسم مسؤولية المتبرع.
وأفرد الفقهاء للقضاء والدعوى والشهادة أبوابًا خاصة بيّنوا فيها نظام التقاضي والحدود التي ينبغي ألا يتعداها القاضي ولا المتقاضي ونظم الإجراءات القضائية ووضعوا قواعد الدعوى وبيّنوا طرق الإثبات والطعن. وبالنسبة لأحكام الأسرة فإن عناية الفقهاء بها مستمرة متصلة لأن هذا القسم هو الذي يكاد ينحصر فيه تطبيق أحكام الشريعة في كثير من البلدان الإسلامية. ولذا فإن أحكام هذا القسم عنيت أكثر البلاد بتقنينها، وكثيرًا ما دخل على هذه القوانين التعديل والتبديل بما يتلاءم مع العصر والبيئة أخذًا من الأقوال المختلفة في المذاهب وتطبيقًا لروح الشريعة. ولعل نكوص العلماء عن البحث في المعاملات المعاصرة والقضايا الجديدة هو بعدها عن التطبيق وعدم الحاجة الملحة إليها في الإلزام والالتزام، وإن كنا لا نرى في ذلك عذرًا .
- أما الأحكام التي تخضع لها معاملات المسلمين مع غيرهم من المواطنين فقد نص الفقهاء على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا إلا في أمور دينهم فقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون. وهكذا في الغالب بالنسبة للأجانب من غير المسلمين الذين دخلوا في بلادنا بعقد أمان. ومن المعلوم أن دار الإسلام وطن لكل مسلم مهما اختلفت جنسيته، ولا مانع إذا ما وضعت حدود سياسية بين دور الإسلام من اتخاذ ولي الأمر احتياطات الأمن التي يراها، أما بالنسبة للحربيين فقد عرف الفقه الإسلامي قاعدة المعاملة بالمثل.
وبعد: كلمة أخيرة
حضرات...
الفقه الإسلامي كما ترون يتسع بمصادره وقواعده لأن يُخضع كل جديد نافع ويطوعه لقواعده؛ فالإسلام دین ونظام سياسي يأخذ بيد المؤمنين الصالحين إلى أحسن الأوضاع وأنفعها يقول الله سبحانه «1» ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (آل عمران: 110) وإذا لم يكن للإسلام مظهر في سلوكنا ومعاملاتنا ولم تكن لأحكامه قوة الإلزام فإننا نسيء إلى الإسلام ونبتعد عنه، إذ الدولة في الإسلام أداة لتنفيذ الحكم الإسلامي، فهي السلطة التي تحمي الأحكام وترعاها وتُلزم الناس بها، ولو تقاعست الدولة عن ذلك فإنها تفقد مبررات وجودها الشرعي.
ولذا فإننا نناشد المسؤولين في كل وطن إسلامي أن يجمعوا العلماء والمتخصصين ويهيئوا لهم طريق التفرغ الكامل للعكوف على التعرف على حكم كل جديد والنظر في كل حكم اجتهادي يحتاج تطبيقه إلى نظر اجتهادي في ضوء البيئة والمصلحة دون تسخير الفقه لحضارة العصر، وإنما تطور الحضارة بما يجعلها تخضع لحكم الدين، ولا بد لذلك من أن يقف النفوذ والسلطان بجانب العلماء وأن ترصد الأموال لذلك وأن يصحب العلم العمل وتطبيق أحكام الإسلام السمح؛ إذ الدولة لا تنفصم عن الدين في الإسلام أبدا والحمد لله فقد اتجهت كثير من الدول الإسلامية إلى جعل التشريع الإسلامي مصدرًا رئيسيًّا للتشريع، كما اتجهت بعض البلاد فعلا إلى ما ندعو إليه فقد شُكّلت في مصر لجان في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لتقنين أحكام الفقه الإسلامي من واقع كل مذهب على حدة. على أن تشكل لجنة أخرى للمقارنة والأخذ بما هو أنسب.. وقد كان لي شرف الاشتراك في هذه اللجان قبل إعارتي لجامعة الكويت، كما كنت مقررًا لموسوعة الفقه الإسلامي بمصر من وقت تكوينها وحتى أعرت لجامعة الكويت، وهي بلا شك تسهل البحث أمام كل باحث في الفقه المقارن، وتيسر سبيل التعرف على مختلف الأحكام بأدلتها حتى يكون الطريق أمام اللجان العلمية وأمام الأفراد - کما أن ليبيا اتجهت أيضا إلى تقنين أحكام الفقه الإسلامي.
وفق الله الأمة الإسلامية شعوبها وحكامها وعلماءها ورجال الفكر والعلم فيها إلى الالتزام بالحكم الإسلامي في كل التصرفات وتيسير ذلك للناس اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» فمقصد الشريعة هو تحقيق الخير والسعادة للناس.
ومن التيسير على الناس أن نبصرهم بأحكام دينهم السمح ونيسر لهم سبيل الاحتكام إليه، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير وما يعود على المسلمين بالنفع والرقي في ظل حكم إسلامي صحيح ﴿إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 95) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النحل: 18-19) ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ (الأعراف: 89) «3» ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران: 8) «4».
وفي الختام فإني أقول ما قاله العبد الصالح «إن كان في شيء مما قلته خطأ فمني، وأستغفر الله عليه، وإن يك في شيء مما قلته صواب فمن الله، والله أعلم بالصواب.. والسلام عليكم ورحمة الله».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل